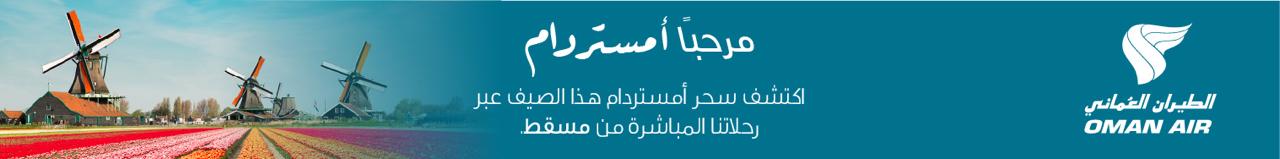ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر قوتان بحريتان في الخليج العربي، القوة البحرية البرتغالية التي وصلت إلى الساحل الغربي من الهند، ووطدت نفوذها في أماكن إستراتيجية مختلفة في المحيط الهندي للسيطرة على التجارة الشرقية واحتكارها1، والقوة البحرية العثمانية التي امتدت إلى البحر الأحمر ثم إلى الخليج العربي بعد استيلاء الدولة العثمانية على مصر عام 1517م، وسيطرتها على بغداد في عام 1534م، وعلى البصرة2 في عام 1546م، وبذلك أصبحت الدولة العثمانية على اتصال مباشر بالخليج العربي3، ووجد العثمانيون بأنهم مضطرون إلى إكمال الخطة التي وضعتها حكومة المماليك4 لاحتلال البحر الأحمر في مواجهة البرتغاليين الذي كانوا يهددون الأماكن المقدسة بين الحين والآخر بعد سيطرتهم على هرمز والسواحل العمانية، ومن ناحية أخرى كانت البحار الشرقية تشكل بالنسبة للدولة العثمانية منطقة استراتيجية هامة، لكونها متصلة بحدود ممتلكاتها الجنوبية، فوقفت ضد التوسع البرتغالي في جهات الخليج العربي5.وعندما علم السلطان سليمان القانوني (1520-1566م)6 بأمر الحملات البرتغالية على البحر الأحمر والخليج العربي، وباستيلاء البرتغاليين على بعض جهات الهند، أمر السلطان سليمان القانوني بتجهيز أسطول كبير في ميناء السويس الذي كان يعتبر أقرب قاعدة بحرية عثمانية من البحار الشرقية، بقيادة سليمان باشا الخادم7، ومنحه صلاحيات واسعة للثأر من البرتغاليين ورفع الحصار البرتغالي عن البحر الأحمر8.ونفذ سليمان باشا الخادم تعليمات السلطان سليمان القانوني، فبني مئة سفينة واستعد لقتال البرتغاليين، فتوجه من السويس قاصدا جدة9 في مايو 1538م، ثم إلى عدن10 فبلغها في يوليو 1538م، حيث فتك بحاكمها عامر بن داؤد، وبذلك تم القضاء على الدولة الطاهرية الشافعية في اليمن11.واتخذ سليمان باشا من عدن وموانئ اليمن من قواعد بحرية لمهاجمة المحطات والمراكز البرتغالية في الخليج العربي والمحيط الهندي، وعندما تخلى الهنود عن مساعدة سليمان باشا نجح البرتغاليون في مقاومة الحصار الذي فرضه العثمانيون على ديو12، واضطر سليمان باشا الخادم إلى رفع الحصار، والعودة إلى اليمن ثم عاد إلى القاهرة ومنها إلى اسطانبول، وبهذا فشلت المحاولة العثمانية الأولى ضد البرتغاليين في المحيط الهندي. ولكن وبعد انسحاب الأسطول العثماني من عدن، تعاون سكانها مع البرتغاليين وسلموا المدينة إليهم، لسوء فعل سليمان باشا الخادم وبحاكمهم عامر بن داؤد13.ونجحت الدولة العثمانية في القرن السادس عشر في إغلاق البحر الأحمر إلى الشمال من ميناء مخا14 في اليمن في وجه السفن الأوروبية، ولكنها لم تنجح في المحيط الهندي كما نجحت في البحر الأحمر، مما أضعف النفوذ العثماني في الخليج العربي، وكذلك كان ضعف القوة البحرية العثمانية في البحر الأحمر منذ أواخر القرن السادس عشر مسؤولا عن انهيار السيطرة العثمانية على اليمن واستقلال الأئمة الزيدية15 بتصريف شؤونها، ولم يبق للحكم العثماني سوى الحجاز16.المصادر التاريخية1- عوض، عبد العزيز: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، ج 1 ، ط 1، 1991م.ص 9.2 - البصرة: يعتقد بأن الاسم معناه "الحصا الأسود"، وكانت البصرة القديمة مشهورة بمدارسها وبتعاليمها الدينية والفلسفية، من أبرز معالمها شط العرب، وقد كانت البصرة بحكم موقعها على شط العرب أكثر مدن العراق اتصالا بالصراع الدائر على النفوذ في الخليج، وقد شهدت البصرة فنونا من هذا الصراع. انظر: سلوت. ب. ج: عرب الخليج في ضوء مصادر شركة الهند الشرقية الهولندية 1602-1784، ترجمة عايدة خوري، شركة أبوظبي للطباعة والنشر، أبوظبي، ط1، 1993، ص 693 - عوض، عبد العزيز: مرجع سابق، ج 2، ص 10.4 - المماليك 1250 – 1517م: مؤسسها قطب الدين أيبك، الذي كان ينوب شهاب الدين الغوري على البلاد المفتوحة، والذي استطاع أن يوطد حكمه على "دهلي" وماحولها أثناء انشغال المتآمرين من أمراء الغوريين، وأن ينشئ دولة مستقلة يتولاها المماليك من أسرته، وعمل على نشر الإسلام وبناء المساجد حتى وفاته. انظر: العلى، عفاف السيد: مرجع سابق، ص 56.5 - - عقيل، مصطفى: التنافس الدولي فى الخليج العربي 1622-1763م ، مؤسسة العهد للصحافة والطباعة والنشر، الدوحة، 1994. ص 29.6 - سليمان القانوني: عاشر سلاطين الدولة العثمانية، ولد في مدينة طرابزون في 27 أبريل عام 1495م، نشأ محبا للعلم والأدب والعلماء والأدباء والفقهاء، واشتهر منذ شبابه بالجدية والوقار، استلم الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول في 23 سبتمبر عام 1520م، وبلغت الدولة العثمانية في عهده أقصى اتساع لها، ومن أقوى الدول في العالم في ذلك الوقت، اشتهر بالقانوني، حيث وضع نظما داخلية في كافة فروع الحكومة، وأدخل تغييرات في نظام العلماء والمدرسين، وجعل أكبر الوظائف وظيفة المفتي. انظر: أبو زيدون، وديع: تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط، ط 1، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2003.؛ الصلابي، علي محمد: مرجع سابق، ص 281.7 - سليمان باشا: كان من أقوى باشوات بغداد المماليك وأطولهم عهدا، تولى باشوية بغداد عام 1780م بعد أن كان متسلما للبصرة، ودام 22 سنة حتى وفاته في 7 أغسطس 1802م. ويعتبر هارفورد جونز المقيم البريطاني في بغداد بين سنة 1798 و 1806، أن وفاة سليمان باشا قد حرمت ولاية العراق من الهدوء والاستقرار، وساعدت على مد النفوذ السعودي الذي قاومه سليمان باشا بصلابة. لقب بالكبير تمييزا له على وال آخر اسمه سليمان باشا الصغير تولى الحكم فيما بعد. انظر: عبدالله، محمد مرسي: إمارات الساحل، ج 1، ص 123؛ الخروصي، صالح بن عامر: عمان في عهدي الإمام سعيد والسيد سلطان بن أحمد البوسعيدي (1783 – 1804)، ط 1، بيت الغشام للنشر والترجمة، 2015، ص 403.8 - عوض، عبد العزيز: مرجع سابق، ج 2، ص 10؛ عقيل، مصطفى: المرجع السابق، ص 31.9 - جدة: من أهم موانئ البحر الأحمر، وهي ميناء عربي معروف ماقبل الإسلام استخدمه عرب الجاهلية في مبادلاتهم التجارية مع الساحل الإفريقي، واستمرت أهميته على امتداد العصور الإسلامية جميعا، وقد وصفها ياقوت الحموي بأنها فرضة مكة، ووصفها الإدريسي بأن أهلها مياسير وذوو أموال واسعة، وليس بعد مكة من مدن الحجاز أكثر من أهلها مالا، وهي محط السفن من الهند وعدن واليمن والقلزم. انظر: بطي، عبيد علي: مرجع سابق، ص 110.10 - عدن: سميت بهذا الإسم نسبة إلى عدن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، اشتهرت في التاريخ العربي كواحدة من أعظم الموانئ البحرية على المحيط الهندي، وكانت ميناءا مهما يتحكم في مداخل البحر الأحمر، وفي مطلع القرن السادس عشر كانت عدن في أوج ازدهارها الاقتصادي، وكانت تحتل الصدارة في حركة التجارة العالمية، ولفت ثرائها انتباه الرحالة والمبعوثين الأوروبيين، وكل هذه الأوصاف تناقض ماورد في سجلات البوكيرك والتي ذكر فيها بأن عدن "مستوطنة صغيرة ولكن بعد اكتشاف البرتغاليين للهند بدأ يتسع وأصبح سوقا لكل البضائع التي تدخل البحر الأحمر عن طريق المضائق"، وهذا كلام غير دقيق لأن شهرة عدن سبقت وصول البرتغاليين أنفسهم إليها. احتلها العثمانيون خلال الفترة (1538 – 1630) وآلت إلى الإدارة البريطانية كجزء من الهند خلال الفترة (1839 – 1937م)، بعد انسحاب القوات المصرية عام 1838م. انظر: سجلات أفونسو دلبوكيرك، ص 569؛ المقحفي، ابراهيم أحمد: معجم المدن والقبائل اليمنية، منشورات دار الحكمة، صنعاء، 1985، ص 279.11 - الدولة الطاهرية 855 1451- 1517 م، ورثت الدولة الطاهرية مناطق نفوذ الدولة الرسولية في اليمن. واجه الطاهريون ثلاث مشاكل تهدد حكمهم هي الخلافات الداخلية بين الأسرة، والقبائل المتمردة التي كانوا يعتمدون عليها لجبي الضرائب والتهديد المستمر من الأئمة الزيدية في صعدة وصنعاء، سيطر الطاهريون على معظم البلاد وبقيت مناطق الزيدية عصية عليهم. واحتل البرتغاليون بقيادة ألفونسو دي ألبوكيرك جزيرة سقطرى عام 1513 وشنوا عدة هجمات فاشلة على عدن صدها الطاهريون. وقد شكل البرتغاليون خطراً مباشراً لتجارة المحيط الهندي العابرة للبحر الأحمر فأرسل المماليك قوة لقتال البرتغاليين، فبدأ مماليك مصر محادثات مع الطاهريين في زبيد لمناقشة مايحتاجه الجيش المملوكي من أموال وعتاد، ولكن الجيش الذي كان ينفذ من المؤن، بدأ بالتحرش بسكان تهامة عوضا عن مواجهة البرتغاليين قرروا إسقاط الطاهريين وإحتلال اليمن لإدراكهم ثراء نطاق نفوذ سلاطين بني طاهر وإستخدموا البارود والمدافع وتمكنت قوات المماليك بالتعاون مع قوات قبلية موالية للإمام الزيدي المتوكل يحيى شرف الدين من السيطرة على مناطق نفوذ الطاهريين عام 1517. لم يدم الإنتصار المملوكي طويلاً، بعد شهر واحد من إسقاطهم الطاهريين، واحتلت الامبراطورية العثمانية مصر. وتحالف السلطان الطاهري عامر بن داوود مع البرتغاليين، فعزم العثمانيون السيطرة على اليمن لكسر الإحتكار البرتغالي لتجارة التوابل. بالإضافة لقلقهم من سقوط اليمن بيد البرتغاليين وربما سقوط مكة بعدها. وبقيت للطاهريين السيطرة على عدن حتى عام 1539 عندما سقطت بيد العثمانيين. انظر:http://ar.wikipedia.org/wiki12 - ديو: مدينة في جزيرة صغيرة واقعة عند طرف شبه جزيرة كاثياوار الجنوبي في الهند، كانت تقصدها المراكب من هرمز والخليج العربي وموانئ ساحل جزيرة العرب الجنوبية وساحل أفريقيا الشرقية. انظر: خوري، ابراهيم والتدمري، أحمد: سلطنة هرمز العربية، سيطرة سلطنة هرمز العربية على الخليج العربي، المجلد الثاني، رأس الخيمة، 1999م.، ص 99.13 - عوض، عبد العزيز: مرجع سابق، ج 2، ص 11.14 - مخا: مدينة في محافظة تعز باليمن، كانت تسمى قديما "موزا"، وقد مثلت دورا تاريخيا هاما في عهد الحميريين، وكانت ميناءا للدولة الجبائية التي عاصرت الدولة الحميرية، وقد تعرضت لعدة حملات من قبل الطامعين أهمها حملات البرتغاليين، واحتلت من الدولة العثمانية أيضا، وبعد انسحاب العثمانيين منها أخذت تستعيد أهميتها التجارية، حتى بلغت أيام المتوكل اسماعيل (1644 – 1676م)، أوج ازدهارها، وأصبحت الميناء التجاري لليمن بعد ميناء الحديدة، ويكثر بها إلى جانب العرب الهنود والأوروبيون، تعرضت في عام 1738م للقصف من الفرنسيين. انظر: نيبور، كارستن: وصف أقاليم شبه الجزيرة العربية، ترجمة مازن صلاح، ط 1 ، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2013م ، ص 206؛ المقحفي، ابراهيم أحمد: مرجع سابق، ص 367-368.15 - الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد جعلوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، وكان الزيدية ثلاثة فرق هي الجارودية والسليمانية والصالحية والبترية (وهما على مذهب واحد). انظر: عبدالرحمن، محمد نصر: الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى، ط 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2014، ص 153؛ بروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، الطبعة 15، دار العلم للملايين، بيروت، فبراير، 2002.، ص 226 – 228.16 - كان خضوع الحجاز للحكم العثماني تلقائيا، وذلك بعد ضمهم للشام بعد معركة مرج دابق سنة 1516م، وضم مصر في العام نفسه، والتي أدت إلى ضم الحجاز للدولة العثمانية في العام التالي، أي عام 1517م، وكان للحجاز حاكم عام عثماني في مقر الحكم العثماني في الطائف، وقائم مقام أيضا، وكانت القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية هي التي تعين الموظفين الكبار كالمحافظين والقائم مقامين والقضاة، ولم يكن والي الحجاز عالي المرتبة كالحاكم العام، وكان القائم مقام الممثل الرسمي للسلطان في جدة وأقل مرتبة من الوالي الذي يتبع الحاكم. انظر: العنقري، هيفاء السلطة في الجزيرة العربية ابن سعود، حسين، بريطانيا 1914 – 1926، ط 1، دار الساقي، بيروت، 2013، ص 103؛ دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية عبر العصور، مداولات اللقاء العلمي السنوي الثالث لجمعية التاريخ والآثار، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1423، ص 352. د.محمد بن حمد الشعيلي أكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة [email protected]