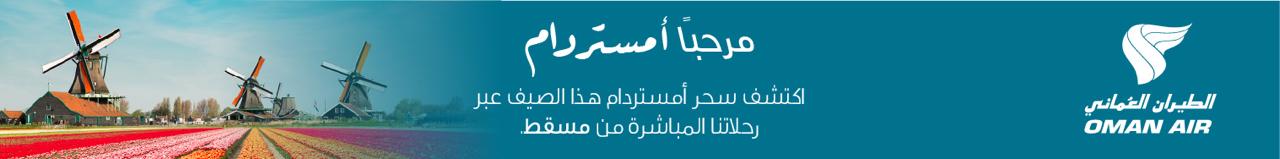[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/jawadalbashity.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]جواد البشيتي[/author]"التاريخ يعيد (أو يكرِّر) نفسه".. إنَّها عبارة طالما سمعناها، أو قرأناها، أو قلناها، وكأنَّها، لجهة معناها، في منزلة "القانون التاريخي"، أو "المسلَّمة الفكرية" التي بحكم معناها ليست بحاجة إلى إثبات، فما يوافقها هو "الحقيقة"، وما يخالفها، أو يناقضها، هو "الباطل".ومن معناها، انبثقت وتفرَّعت عبارات أخرى، منها على سبيل المثال، أو على وجه الخصوص، عبارة "لا جديد تحت الشمس"، مع أنَّ معنى هذه العبارة أوسع وأعم وأشمل من عبارة "التاريخ يعيد نفسه".أمَّا ما يدهشني ويحيِّرني (ولكن ليس كثيرًا) فهو إدمان كثير من "أهل الفكر والقلم" عندنا، ومن مدبِّجي المقالات السياسية الصحافية اليومية على وجه الخصوص، على استعمال عبارة "التاريخ يعيد نفسه"، متوهِّمين أنَّ زركشة مقالاتهم بها، أو افتتاحها، أو اختتامها، بها يمكن أن يعلي من شأنها، ومن شأنهم، أو أن يرفع منسوب "الفكر" في النصِّ الذي يتوفَّرون على كتابته.اثنان مِمَّن لا يقبلان نعتهما بما هو أقل من صفة "المفكِّر العربي"، هما اللذان أدهشاني وحيَّراني كثيرًا، إذ خالف كلاهما الآخر في أمر صاحب هذا "الاكتشاف"، أي عبارة "التاريخ يعيد نفسه"، فأحدهما أصرَّ على أنَّه هيجل، فعارضه الآخر، مصرًّا على أنَّه ماركس، وكأن ليس لـ"الحقيقة" من آذانٍ تسمع، وعيون تبصر!ثمَّ جاءهما ثالث، أي "مفكِّر ثالث"، فأدلى برأي في القضية مدار الخلاف، وكأنَّه صاحب القول الفصل، فكشف لهما، ولنا، أنَّ هيجل وماركس يتقاسمان فضل هذا "الاكتشاف"، محتجًّا بقولٍ لماركس (من مستهل مؤلَّفه "الثامن عشر من برومير") جاء فيه: "أشار هيجل إلى أنَّ كل الأحداث الكبرى والشخصيات التاريخية تتكرَّر مرَّتين؛ ولقد نسي أنْ يقول موضحًا إنَّها (الأحداث والشخصيات) في المرَّة الأولى تظهر في شكل مأساة، وفي المرَّة الثانية تظهر في شكل مهزلة".من هذا القول، الذي أساء فهم معانيه مرتكبًا خطأً يعدل خطأ أن تقول "1 + 1 = قرد"، استمدَّ "المفكِّر الثالث" حجَّته المفحمة!إنَّ هيجل هو العدو اللدود لمقولة "التاريخ يعيد نفسه"؛ ولقد أسَّس لمنطقٍ، تخطَّى فيه منطق أرسطو (المنطق الشكلي أو الصوري). ويقوم منطقه الجدلي على نفي ودحض كل مقولة أو فكرة من قبيل "التاريخ يعيد نفسه"، و"لا جديد تحت الشمس".وإلى هذا الفيلسوف الألماني العظيم، والجدلي الأعظم أيضًا، يعود الفضل في اكتشاف (وصوغ) قانون "نفي النفي" Negation Of Negation والذي في إساءة فهمه يكمن قولهم "التاريخ يعيد نفسه".هذا القانون (أو الثلاثية الهيجلية الشهيرة) والذي يشمل فعله وعمله الطبيعة والتاريخ والمجتمع والفكر، شرحه هيجل بنفسه خير شرح في مثال "البرعم والزهرة والثمرة"، فقال: إنَّ "البرعم" يختفي ما أن تحطِّمه "الزهرة"، وتحل مكانه؛ ولكنَّ "الزهرة" التي نفت وألغت "البرعم" لن تظل في مكانها، أو على ما هي عليه، إلى الأبد، فإنَّ "الثمرة" تنفيها وتلغيها هي أيضًا، وتحل مكانها.النفي الأوَّل الذي نراه في حياة النبتة إنَّما هو نفي "الزهرة" لـ"البرعم"؛ والنفي الثاني هو نفي "الثمرة" لـ"الزهرة"؛ وهذا النفي (الثاني) هو ما يسميه هيجل "نفي النفي".هيجل يسمِّي الطور الأوَّل من حياة النبتة، والذي هو "البرعم" تسمية فلسفية هي "الأطروحة" Thesis، ويسمِّي الطور الثاني، وهو "الزهرة"، "النقيض" Antithesis، ويسمِّي الطور الثالث، وهو "الثمرة"، "التركيب"Synthesis؛ وهذا الطور هو نفسه طور "نفي النفي".ثمَّ يوضِّح هيجل أمرًا في منتهى الأهمية هو "تساوي الأطوار الثلاثة جميعًا لجهة أهميتها وضرورتها"، فلو لم يُوْجَد طور "الزهرة"، مثلًا، لَما ظهرت "الثمرة" إلى الوجود؛ وإنَّ من السخف أن ينظر بعض الناس إلى "الثمرة"، مثلًا، على أنَّها "الحقيقة"، وكأنَّ طور "الزهرة" عديم الأهمية، أو قليلها.في نفي فكرة لأخرى، يمكن أن نقول إنَّ الفكرة الجديدة "دَحَضَت" القديمة، ويمكن أن يقول بعض الناس مُسْتَنْتِجًا إنَّ الفكرة القديمة ما كانت لِتُدْحَض لو لم تكن "خاطئة"، أو "زائفة"، وإنَّ الفكرة الجديدة هي، من ثمَّ، "الصائبة" و"الحقيقية".وفي الطريقة نفسها، يمكن أن يفهم بعض الناس "الزهرة" على أنَّها "الخطأ" و"الزِّيف" في حياة النبتة، و"الثمرة" على أنَّها "التطوُّر الطبيعي والحقيقي".هندسيًّا، وبما يوافق فهمهم الفلسفي هذا، تصوَّروا التاريخ (والتطور على وجه العموم) على أنَّه "دائرة لا نهاية لها"، أي يعود كل شيء إلى نقطة الانطلاق (إلى البداية) ويغدو "المستقبل"، من ثمَّ، عودة إلى "الماضي"، فلا جديد تحت الشمس!إنَّها عودة لا ننكرها؛ ولكنَّها ليست بالعودة التي لا جديد فيها، فإنَّ اختلافًا في "الكم" و"الكيف" يخالط دائمًا "العودة إلى الماضي"، أو إلى "نقطة الانطلاق"؛ وإنَّها "دورة"؛ ولكنَّها "حلزونية (أو لولبية)" الشكل، فالعودة إلى الماضي، أو إلى نقطة الانطلاق، إنَّما هي عودة أقرب إلى الشكل منها إلى المحتوى، وتمثِّل درجة أعلى في سلَّم التطوُّر.وفَهْمُ التاريخ، أو التطوُّر الاجتماعي والتاريخي، على هذا النحو، أي بما يوافق قانون "نفي النفي"، أو "الثلاثية الهيجلية (التي لا تمت بصلة إلى ثلاثية "الآب والابن والرُّوح القدس")"، إنَّما هو جزء لا يتجزأ من فهم أوسع وأشمل وأعم، هو فهم التطوُّر كله (أي في الطبيعة والتاريخ والمجتمع والفكر) على أنَّه "وحدة (وصراع) أضداد"؛ وهذا الفهم هو النقيض لفهمٍ آخر، هو فهم التطوُّر على أنَّه "زيادة ونقصان"، و"تكرار"، وكأنَّ الأشياء لا تتغيَّر، إذا ما تغيَّرت، إلاَّ في "الدرجة"، فتزيد أو تنقص، متكرِّرةً في النوع والكيف.التاريخ، إنْ أمعنا النظر فيه، مسارًا وأحداثًا، إنَّما هو اجتماع "الحركة" و"التقدُّم"، فهو يسير دائمًاإلى الأمام، أو في مسارٍ صاعد؛ وهذا السير (أو الحركة) تقدُّمي الطابع؛ لأنَّه سَيْرٌ يشبه الصعود في سُلَّم (يشبه "السلَّم الحلزوني (أو اللولبي)".والتاريخ، في سيره وجريانه، يشبه، أيضًا، "نهر هيراقليطس"، فإنَّ أحدًا لا يمكنه أن ينزل في مياه النهر نفسه مرَّتين.و"حلزونية المسار (أو السير)" لا تنفي "الدائرية" فحسب، وإنَّما "الاستقامة"، فالقائلون بـ"النفي المُطْلَق والخالص" يفهمون كل جديد في التطوُّر التاريخي على أنَّه شيء، أو حال، لا أثر فيه أبدًا للماضي، فـ"القديم" يُقْضى عليه قضاءً مبرمًا، ليحل مكانه "الجديد" الذي لا يحتفظ أبدًا بأيِّ شيء من "القديم المنفي"، ولو كان عنصرًا ضروريًّا أو مفيدًا أو إيجابيًّا.ومن هذا الاتِّجاه الفلسفي "العدمي" يتفرَّع، في عالم السياسة والثقافة، "اتِّجاه العدمية السياسية والثقافية"، الذي يريد أصحابه ابتناء كل جديد من هدم وتدمير تامين لكل قديم.و"الحلزونية"، التي هي شكل التطوُّر على وجه العموم، إنْ أحسنَّا فهمها، أي إنْ فهمناها فهمًا جدليًّا، إنَّما هي التقويم للتناقض، أو التضاد، بين "الدائرية" و"الاستقامة"، فإنَّها تشبه "الدائرية" لكونها تتضمَّن "عودة (مختلفة، وعلى مستوى أعلى) إلى الماضي"، وتشبه "الاستقامة"؛ لكونها تتضمَّن معنى "الصعود"، أو معنى "السير إلى الأمام"، فالتاريخ، الذي سهمه هو نفسه سهم الزمن، لا يعود أبدًاإلى الوراء، وإنْ كانت "الثلاثية الهيجلية" هي قانون حركته.إنَّ "العودة الجدلية الهيجليةإلى الماضي" نراها في كثيرٍ من الأحداث والتطوُّرات والنظريات والنُّظم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية..؛ ولكنَّنا نسيء فهمها إذا ما أسَأْنا فهم "النفي" نفسه Negation."النفي (الذَّاتي)" هو جوهر التطوُّر (في الطبيعة والتاريخ والمجتمع والفكر).إنَّه اجتماع ووحدة "لحظتين" هما "لحظة النشوء" و"لحظة الزوال"، فإنَّكَ لا تستطيع أبدًا أن تتحدَّث عن أي تغيير من غير أن تعنيَ أنَّ شيئًا ما قد "وُلِدَ من موت" آخر، فاللحظتان هما لحظة واحدة.و"النفي"، حتى نُحْسِن فهمه، ولا نظلُّ أسرى فهم خاطئ له، لا يعني أبدًا "الفناء التام"، أو القضاء على الشيء الذي نُفي "قضاءً مبرمًا"، فإنَّ "النفي"، في معناه الحقيقي الجدلي الهيجلي، هو الفعل الذي بفضله "يُغْلَب (يُقْهَر، يُهْزَم)Over come القديم، أي الشيء الذي تعرَّض للنفي، و"يُحافَظ عليه (يُسْتَبْقى، يُحْتَفَظ به)" في الوقت نفسهPreserved.وفي مثال بسيط، أقول إنَّني "أنفي" قطعة اللحم عندما آكُلُها؛ ولكن هل فَنِيَت قطعة اللحم إذ أكَلْتُها؟لا شكَّ في أنَّها "نُفِيَت"، بمعنى ما؛ ولكن هذا "النفي" تضمَّن أيضًا معنى "الاستبقاء"، ففي عملية الهضم، أو عملية التمثيل الغذائي، يحتفظ جسمي بكل ما هو ضروري ومفيد من قطعة اللحم التي نُفِيَت.وفي الطريقة نفسها، يمكننا، وينبغي لنا، فهم "نفي" نظرية ما، أو مدرسة فكرية ما، أو عقيدة ما.وفي تاريخ العقائد، نرى أنَّ كل عقيدة جديدة لا تنفي "العقيدة القديمة" إلاَّ بهذا "المعنى المزدوج" لـ"النفي"، فـ"الجديدة" تلغي "القديمة"، وتحل مكانها؛ مُحْتَفِظَةً، في الوقت نفسه، بكل ما هو ضروري ومفيد وإيجابي وجدير بالبقاء من عناصر وجوانب وأفكار ومفاهيم "القديمة"، أي تلك العقيدة التي نُفِيَت. إنَّ "العقيدة الجديدة (النافية)" تمتص، وتتشرَّب، وتستوعب، عناصر من "العقيدة القديمة (المنفية)"، جاعلةً تلك العناصر جزءًا لا يتجزأ من بنيتها وتكوينها.ربَّما سمعتم بما يسمى "حَجَر الفلاسفة".. ففي العصور الوسطى استبدَّت بتفكير "الكيميائيين" القدامى فكرة تحويل بعض المعادن الرخيصة، كالرصاص، إلى ذهب، فكانت "الأطروحة" من "الثلاثية الهيجلية" هي فكرة أو نظرية "تحويل العناصر".ولقد بذل "الكيميائيون" القدامى جهودًا مضنية في سبيل تحويل الرصاص إلى ذهب؛ ولكنَّ كل جهودهم منيت بالفشل؛ ومع ذلك، لم يكن هذا الفشل خالصًا مطلقًا، فهم، وفي سياق محاولاتهم العبثية، توصَّلوا إلى اكتشاف كثير من الحقائق، وأنشأوا وطوَّروا كثيرًا من الأدوات، فالمرء لا يمكنه أن يفشل في تحقيق أمر ما من غير أن يتوصَّل، في الوقت نفسه، إلى أشياء تجعل الفشل أُمَّ النجاح.محاولاتهم، ومن حيث المبدأ، افتقرت إلى "الحكمة"، فهم لو نجحوا في تحويل الرصاص إلى ذهب لانتفى الدَّافِع لديهم إلى ذلك؛ فإنَّ إنتاج مزيد من الذهب، من خلال تحويل الرصاص إلى ذهب، سيؤدِّي لا محالة إلى جَعْل الذهب معدنًا رخيصًا!ومع نشوء وتطوُّر الصناعة الرأسمالية، دُحِضَت (نُفِيَت) فكرة "تحويل المعادن"، وحلَّت مكانها فكرة مضادة هي "المعادن غير قابلة للتحويل". وهذه الفكرة المضادة الجديدة إنَّما تمثِّل "النقيض" من "الثلاثية الهيجلية".وفي القرن العشرين، تطوَّر علم الفيزياء النووية، وأصبح ممكنًا، من ثمَّ، تحويل عنصر إلى عنصر، كتحويل الرصاص إلى ذهب، فعاد العلماء إلى الأخذ بفكرة "تحويل العناصر"؛ ولكن شتَّان ما بين "الفكرة القديمة" و"الفكرة الجديدة"، فالعودة إلى الماضي، في هذا المثال، كانت مختلفة في كثير من الجوانب، وظهرت على مستوى أعلى.إذا كان المرء ساذجًا في تفكيره، يرى أوجه التماثل أو التشابه القليلة بين شيئين من غير أن يرى في الوقت نفسه أوجه الاختلاف والتباين الكثيرة، فإنَّه سيفهم العودة إلى فكرة "تحويل العناصر" على أنَّها خير دليل على أنَّ "التاريخ يعيد ويكرِّر نفسه"!إذا تجرَّأتُ وقُلْتُ الآن، في مستهل القرن الحادي والعشرين "أجل، إنَّ الأرض هي محور الكون"، فهل أكون بقولي هذا قد عُدتُّ إلى "الفكرة القديمة"، التي لا يعتقد بها عاقل اليوم؟قديمًا كانت "الأطروحة" هي "الأرض محور ومركز الكون، والشمس هي التي تدور حولها".هذه الفكرة نُفِيَت، وحلَّت مكانها فكرة "الأرض ليست بمركز الكون".واليوم، أستطيع أن أقول، استنادًاإلى نظرية "الانفجار الكبير" Big Bang، وإلى نظرية "النسبية العامة" لآينشتاين، إنَّ الأرض، وبمعنى ما، هي مركز الكون؛ ذلك لأنَّ كل نقطة في كوننا المتمدِّد، المتسارِع تمدُّدًا، يمكن اتِّخاذها مركزًا للكون (الذي ليس له مركز).