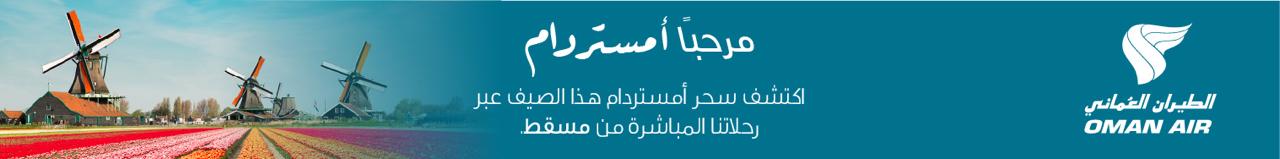سُميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أقسم فيها بأداة الكتابة وهى (القلم) ففضلت السورة بهذا الاسم تعظيما للقلم، وسُميت أيضا "نون والقلم" وسورة (القلم)، وهي مكية من المفصل آياتها (52) ترتيبها الثامنة والستون نزلت بعد العلق . بدأت باسلوب القسم (ن والقلم وما يسطرون)، لم يذكر لفظ الجلالة في السورة، اسم السورة (القلم). الجزء (29)، الحزب (75).تناولت هذه السورة ثلاثة موضوعات أساسية هى: موضوع الرسالة، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبدالله وقصة أصحاب الجنة (البستان) لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى، والآخرة وأهوالها وشدائدها، وما أعد الله للفريقين المسلمين والمجرمين، ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) .. فالى التفسير مع الامام القرطبي.قال تعالى:(لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ).قوله تعالى:(لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ) قراءة العامة (تداركه). وقرأ ابن هرمز والحسن (تداركه) بتشديد الدال، وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال. وهو على تقدير حكاية الحال، كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس وابن مسعود:(تداركته) وهو خلاف المرسوم، و(تَدَارَكَهُ) فعل ماض مذكر حمل على معنى النعمة لأن تأنيث النعمة غير حقيقي. و(تداركته) على لفظها. واختلف في معنى النعمة هنا، فقيل النبوة، قال الضحاك. وقيل عبادته التي سلفت، قاله ابن جبير. وقيل: نداؤه (لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) قاله ابن زيد. وقيل: نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت ؛ قال ابن بحر. وقيل: أي رحمة من ربه فرحمه وتاب عليه.(لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ) أي: لنبذ مذموماً ولكنه نبذ سقيماً غير مذموم. ومعنى (مذموم) في قول ابن عباس: مليم. قال بكر بن عبدالله: مذنب. وقيل:(مذموم) مبعد من كل خير. والعراء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجر يستر. وقيل: ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ثم نبذ بعراء القيامة مذموما. يدل عليه قوله تعالى: (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)، (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) أي: اصطفاه واختاره، (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) قال ابن عباس: رد الله إليه الوحي، وشفعه في نفسه وفي قومه، وقبل توبته، وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون.قوله تعالى:(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة، (لَيُزْلِقُونَكَ) أي: يعتانونك. (بِأَبْصَارِهِم) أخبر بشدة عداوتهم النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل: كانت العين في بني أسد، حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية، خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثة، ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول: لم أر كاليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعين فأجابهم، فلما مر النبي (صلى الله عليه وسلم) أنشد:قد كان قومك يحسبونك سيداوإخال أنك سيد معيونفعصم الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) ونزلت:(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ)، وذكر نحوه الماوردي. وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً ـ يعني في نفسه وماله ـ تجوع ثلاثة أيام، ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا أحسن، فيصيبه بعينه فيهلك هو ومال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال القشيري: وفي هذا نظر لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض، ولهذا قال:(وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) أي: ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن.قلت: أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرنا، وأن مرادهم بالنظر إليه قتله. ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك. وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد (لَيُزْهقُونَكَ) أي ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير، من زهقت نفسه وأزهقها. وقرأ أهل المدينة (لَيُزْلِقُونَكَ) بفتح الياء. وضمها الباقون، وهما لغتان بمعنى، يقال: زلقه يزلقه وأزلقه يزلقه إزلاقا إذا نحاه وأبعده. وزلق رأسه يزلقه زلقا إذا حلقه. وكذلك أزلقه وزلقه تزليقا. ورجل زلق وزملق، مثال هدبد وزمالق وزملق ـ بتشديد الميم ـ وهو الذي ينزل قبل أن يجامع، حكاه الجوهري وغيره. فمعنى الكلمة إذا التنحية والإزالة، وذلك لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهلاكه وموته. قال الهروي: أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه عداوة لك. وقال ابن عباس: ينفذونك بأبصارهم يقال: زلق السهم وزهق إذا نفذ، وهو قول مجاهد. أي: ينفذونك من شدة نظرهم. وقال الكلبي: يصرعونك. وعنه أيضا والسدي وسعيد بن جبير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقال العوفي: يرمونك. وقال المؤرج : يزيلونك وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال عبدالعزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظرا شزرا بتحديق شديد. وقال ابن زيد: ليمسونك. وقال جعفر الصادق: ليأكلونك. وقال الحسن وابن كيسان : ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعني بطرفه ، وقتلني بعينه.قال الشاعر:ترميك مزلقة العيون بطرفهاوتكل عنك نصال نبل الراميوقال آخر:يتفارضون إذا التقوا في مجلسنظرا يزل مواطئ الأقداموقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله راجع إلى ما ذكرنا، وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم.أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين. وقيل: أي وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به. وقيل : معناه شرف، أي: القرآن. كما قال تعالى:(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) والنبي (صلى الله عليه وسلم) شرف للعالمين أيضا. شرفوا باتباعه والإيمان به (صلى الله عليه وسلم) .. والله اعلم.* (المصدر: تفسير القرطبي)اعداد ـ أم يوسف