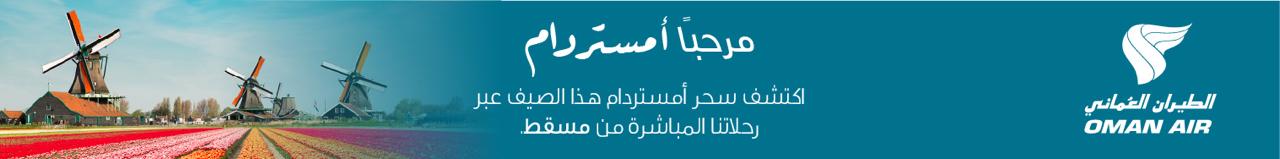يطرح ملف الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان الكثير من التساؤلات المعمقة، ويلقي بظلاله على جهود الدولة الرامية نحو إيجاد حلول مستدامة للتشغيل والتوظيف، وهي قضية باتت شائكة نظرا لكثرة الاجتهادات فيها، وعدم وضوح المسار نحوها، ناهيك عما فرضه دخول المسرحين من أعمالهم في الخط من تعمق أكبر للمشكلة وزيادة الفجوة وتدني الخيارات والبدائل، وما أحدثه ذلك من ارتباك في تحديد الأولويات والأسبقية، وإلى أين يجب أن تتجه بوصلة العمل الوطني في سبيل خلق مساحة من التوازن في ظل ارتفاع سقف التأثير الناتج عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟ هل إلى توظيف الباحثين عن العمل الجدد من مخرجات الدبلوم العام والجامعي على حد سواء أو غيرهم من المتسربين من الدراسة والمنقطعين عنها؟ أم تتجه إلى معالجة جذرية لملف المسرحين من أعمالهم؟ومع ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل من المخرجات التعليمية ـ رغم تضارب المعلومات بشأنها ـ واتجاه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى المعدل في تقدير أعداد الباحثين عن عمل بدلا من الأرقام، إلا أن نتائج الإحصاء السنوي لعام 2020 تشير إلى أن إجمالي الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان بلغ 65438 ألف باحث؛ منهم 47007 باحثين عن عمل من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18 -29) سنة، الذكور منهم 43.4%، بينما الإناث 56.6%، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى إعادة قراءة مسار التوظيف والتشغيل الوطني، ووضع النقاط على الحروف في التعامل مع التحدِّيات والأسباب التي تقف خلفها؛ ويقرأ البعض في مسألة العرض والطلب مبررا في وجود مشكلة الباحثين عن عمل، حيث إن الطلب على الوظائف يفوق المعروض منها للتنافس، إما لأن أكثرها لا يتناسب مع المؤهل العلمي والدراسي والتخصصات المعروضة للمخرجات الجامعية والدبلوم المتوسط، حيث يصل إجمالي الشباب الباحثين عن عمل من حاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى إلى 19031 ألف باحث عن عمل؛ منهم 18.4% من الذكور و81.6% من الإناث، كما يتركز أغلبهم في تخصص المعاملات الإدارية والتجارية بمجموع 5137 باحثا عن عمل، ثم تخصص الهندسة والتقنيات ذات الصلة بمجموع 4269 ألف باحث، ثم تخصص تكنولوجيا المعلومات بمجموع 3276 ألف باحث، ثم المجتمع والثقافة 2797 ألف باحث، ثم العلوم التطبيقية والفيزيائية 1135 ألف باحث عن عمل.ويشير البعض الآخر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بشأن خفض الأجور وعدم ربط المسار الوظيفي بالمؤهل العلمي، أسهمت في إتاحة الفرصة للشركات ـ في ظل تدني مستوى الرقابة عليها في زيادة تسريح العُمانيين ـ، واستقطاب أعداد كبيرة من الأيدي الوافدة للعمل في هذه الشركات والقطاعات، حيث يظهر سيطرة هذه الفئة على عوامل الإنتاج ومدخلات المنافسة في القطاع الخاص والعائلي، ومحاولة إعادة مسار حضور العُمانيين في المهن والوظائف التقليدية المنتجة يفرض هو الآخر تحدِّياته على المنافسة الاقتصادية وقدرة المواطن والشباب العُماني على الدخول في قطاع الإنتاج، وتوفر الفرص الوظيفية والمهنية المناسبة التي يمكن من خلالها أن يصنع فارق الأداء، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 77% من إجمالي المشتغلين في السلطنة في عام 2020 هم وافدون، مقابل 23% عُمانيين، كما أن 67% من إجمالي شاغلي وظائف الإدارة العامة والأعمال في القطاع الخاص والعائلي في عام 2020 هم وافدون، وأن %91 من إجمالي شاغلي المهن الهندسية الأساسية والمساعدة في القطاع الخاص والعائلي في عام 2020 هم وافدون. هذه المؤشرات تلغي مصداقية نظرية العرض والطلب، في ظل الأعداد الكبيرة من الأيدي الوافدة التي تعمل في وظائف هندسية والوظائف العليا بالشركات، في حين يعمل الشباب العُماني في القطاع الخاص في الوظائف المساندة (حارس أو سائق) أو الوظائف التنسيقية والكتابية، وهو ما يعني الحاجة إلى رفع مستوى الثقة في المواطن من جهة، وإعادة تنظيم وهيكلة القطاع الخاص عبر فرض سياسات وطنية ملزمة للشركات في ضمان التزامها بأن يكون ما نسبته من العاملين في الشركات الوطنية والأجنبية في المهن والوظائف المختلفة وبشكل خاص الهندسية والاستشارية والعليا بين 25- 30% للعُمانيين، الأمر الذي سوف يقلل من مسار التسريح، ويفتح المجال للشباب العُماني الكفء من مخرجات التعليم في الالتحاق بهذه المؤسسات والشركات، وفي الوقت نفسه فإن هذا الإجراء سوف يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للمواطن، ويقلل من مزاجيه الشركات في عملية الإبقاء والتوظيف والاختيار للمواطن.ومع استمرار ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، ارتفع عدد المسرَّحين من أعمالهم من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أشار التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان لعام 2021 إلى أن عدد العمال العُمانيين الذين تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا في عام 2021 وحده بلغ (5438) مسرَّحا من 165 شركة، كما أن استمرار عملية التسريح إلى يومنا هذا بصورة منهجية وبطريقة استفزازية رغم تحسُّن الظروف الاقتصادية واستمرار الحوافز الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، يلقي بظلاله على جدية الشركات في وقف عمليات التسريح؛ فإن ما أشار إليه تقرير الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان من أن جهوده تكللت بالحفاظ على أكثر من (45708) من القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص من إنهاء الخدمات الجماعي أو تخفيض الأجور، مؤشر خطير يجب قراءة معطياته وتداعياته المستقبلية، في إشارة إلى أن مسألة التسريح لم تعد ترتبط بالظروف الاقتصادية، بقدر ما هي ممارسات تفرضها الشركات المتنفذة لخلق مزيد من الفجوة وأزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ومحاولة فرض واقع جديد يؤسس في المواطن قناعة أكيدة بعدم جدية القطاع الخاص كبيئة أعمال آمنة وضامنة لاحتواء واستقطاب الكفاءة العُمانية.من هنا نعتقد بأن ما أشار إليه وكيل وزارة العمل ـ المرجعية الوطنية الأولى في التوظيف في سلطنة عُمان ـ وما تم تناقله حول إشارته إلى ضعف المخرجات الوطنية مهنيا وسلوكيا ومهاريا، حقيقة مؤلمة يجب الوقوف عندها وتأمل مقتضياتها، لتبدأ من الإجابة عن التساؤل: ما مساحة التغيير التي استطاعت وزارة العمل تحقيقها في إطار إعادة الهيكلة والصلاحيات؟ وهل استطاعت وزارة العمل كسب الرهان والثقة في الباحثين عن عمل؟ فالمسألة على ما يبدو أنها ضاعت في أولوية التركيز على إعلانات التشغيل أكثر من الجلوس مع مؤسسات التعليم في رسم ملامح ومستقبل التشغيل والتوظيف والوظائف؛ لذلك فإننا على قناعة الآن أن مؤشر أعداد الباحثين عن عمل يجب أن يكون حاضرا وبقوة كمبرر لإعادة هيكلة وتقييم ومسار التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتي تضع ثقلها في الرأسمال البشري الاجتماعي القادر على بعث الرؤية ومنحها القوة والريادة والتأثير؛ فإن التعليم إن لم يستطع إنتاج مخرجات تعليمية قادرة على أن تتعاطى مع عمليات التوظيف والتشغيل بكفاءة، وتمتلك الممكنات والقدرات والمهارات والاستعدادات التي تصنع لها حضورا وقوة، فهو في خطر، ويعاني من أزمة حقيقية يجب التعامل معها بجدية، ووفق أطر واستراتيجيات تقييمية تنقل التعليم في إطار الحوكمة من حالة التكرارية إلى الإنتاجية، ومن التخبط والعشوائية إلى التخطيط السليم وإعادة إنتاج الواقع الاجتماعي الوطني.لقد جاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في عاطر خطاباته السَّامية، وفي أثناء ترؤُّسه لاجتماعيات مجلس الوزراء الموقَّر، مستلهمة حقيقة التحوُّل التي يجب أن يصنعها التعليم في بناء عُمان المستقبل وفي التعامل مع ملفات التشغيل والتوظيف، من حيث ما يتعلق منها بالتنويع في المسارات التعليمية، وأن يتجه التعليم في مراحل مبكرة إلى توسيع الخيارات المهنية والتقنية والفنية والتخصصية، بالإضافة إلى الأكاديمية حتى تستطيع المخرجات أن تتعامل مع مستجدات التعليم والتحوُّلات في قطاعات الإنتاج والصناعة والطاقة بسهولة، وتتكون لديهم قناعات ومهارات يمكنهم من خلالها سد ذريعة الموثوقية في القدرات العُمانية، والرد على التكهنات بأن المخرجات العُمانية غير مؤهلة، بحيث يرتبط تعليم المخرجات في المواقف التعليمية بالتعليم المدرسي والعالي بالتركيز على المهارات الحياتية والمهارات الرقمية والمهارات الناعمة، والجاهزية المهنية والفكرية والتشريعية، وتوظيف الملكات النفسية والفكرية والجسدية في قدرة المخرجات على التعامل مع الوظائف، وعبر تطوير طرائق التعليم وأساليب التعلم ونظم التقييم وإعداد المُعلِّم العُماني والقوانين والأنظمة والتشريعات المنظمة للتعليم، والتركيز على التطبيقات العملية والابتكار والمواهب والشركات الطلابية والتدريب على مقاعد الدراسة أو المقرون بالوظيفة، والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي والمدارس والشركات، أو كذلك من خلال إعادة تقييم ومراجعة التخصصات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية (جامعة السُّلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية)، منعًا من التكرارية في التخصصات، وسعيًا نحو التركيز على تخصصات المستقبل التي تتناغم مع رؤية عُمان 2040 وتحقق أولويات سلطنة عُمان من الوظائف، في ظل التوجهات الوطنية نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء والحياد الصفري واللوجستيات وقطاعات الصناعات التحويلية في الدقم وصحار وصلالة، وتعزيز جاهزية وكفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات وتطويرها، بالإضافة إلى تطوير أساليب ونظم العمل في القطاع الخاص، وموقع المواطن فيه، والحوافز والأجور والمكافآت، ونظم الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن وغيره من الخيارات التي باتت تؤسس لمجتمع صناعي «ومواطن صنايعي» يمتلك حس الصناعة وتطوير الحرفة وعصرنتها وإعادة إنتاجها، وتمكين روَّاد الأعمال ومشاريع الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانخراط الشباب العُماني في العمل الحر، وتعزيز ثقافة بناء مشاريع الشباب الاحترافية، كما تتجه الاستثمارات الوطنية فيه إلى المصانع التي تستقطب أعدادا كبيرة من الباحثين عن عمل والمسرَّحين بدلا من موضة الاستثمار في الأبراج.أخيرا، كفى مثالية أو تحيزا أو إلقاء باللوم في ملف التشغيل والتوظيف على منظومة واحدة ـ رغم القناعة بأن التعليم جزء رئيسي من المشكلة، كما أنه جزء أساسي في الحل ـ إن تمت إعادة هيكلته بصورة متكاملة، إننا بحاجة اليوم إلى منظومة وطنية متكاملة للتشغيل والتوظيف في أطرها التشريعية والتنظيمية والإدارية والضبطية والتقييمية والأدائية والرقابية، وضمان التزامها مسار الحوكمة والمرونة في أساليب العمل والتبسيط في الإجراءات ومنع الهدر والتكرار في العمليات الإدارية، لكننا بحاجة أكثر إلى الجديّة والمصداقية، والإخلاص واحترام المسؤولية، والتنازل على الفردانية والفوقية والسلطوية، والانسجام في مكوِّنات البيت المؤسسي الوطني في كل ما يرفع من مؤشر الباحثين عن عمل كمؤشر قوة ونجاح في قراءة وتبسيط تفاصيل الرقم الصعب للباحثين عن عمل والمسرَّحين العُمانيين من أعمالهم. د.رجب بن علي العويسي[email protected]