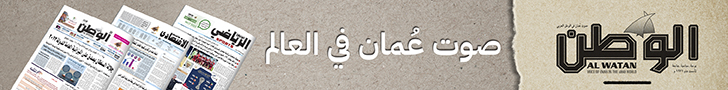سعود بن علي الحارثي:هل تصلح منصَّة "تويتر" لاحتضان الحوارات الفكرية ـ الفقهية المتخصصة في قضايا وملفات وموضوعات جدلية، تدخل فيها المذاهب والعقائد والشعائر والأديان والتاريخ والمنظومة الفقهية؟ هل تحوَّلت وسائل التواصل إلى صراعات ومشادات ومشاحنات وخلافات وساحات للتصفيات والهزائم والانتصارات بين توجُّهات فكرية، تستخدم فيها أسلحة القذف والشتم والتصنيف والتقريع والتكفير والترهيب والتحقير وشيطنة الآخر...؟ ألا نعي بأن هذه المنصَّات بفضائها الواسع تحتضن وتستوعب ويشارك فيها الداخل والخارج، الصغار والكبار، النساء والرجال، المتخصص وغير المتخصص، المتعلم بدرجات عالية، والأقل درجة، أو درجات، العالم والمفكر والباحث، وهم القلة، والكثرة لا يفقهون ولا يدركون ولا يعون ولا يمتلكون مهارات الحوار ولا القدرة على الفهم واستيعاب إشكاليات هذه القضايا التاريخية والمذهبية ولا أوْجُه الخلاف حولها ولا تبعاتها ومقاصد وغايات طرحها والجدل الواسع الذي يدور بشأنها؟ وإلى أي المسارات يقودنا...؟ فلماذا نستدرجهم ونوقعهم في فخ هذه الحوارات المصحوبة بمخاطر وأضرار يعيها ويدركها من يتسبب في هذا الجدل؟ لماذا يسعى البعض، أو القلة القليلة إلى استفزاز واستدراج المجتمع، وطرح قضايا إشكالية تقود إلى التجييش والتهييج والصدام؟ هل المقصد من ذلك طلب الشهرة والولع بالمظاهر وزيادة المتابعين، أو الظهور بمظهر المدافع عن الدين والمنافح عن قِيَم أو حرية المجتمع، وإشاعة أجواء الحوار والحق في الرأي؟ أم لمجرد شعور بالراحة والبهجة والغبطة يخيم عليهم، عندما يثيرون غضب وغيرة البعض ويوقعونهم في شراك الصراع والمهاترات والجدل العقيم، وهم في غرفهم المغلقة وفي المقاهي يحتسون القهوة، يتابعون بشغف ما يتسببون فيه من ضغط واستفزاز، كونهم يعشقون أجواء "الاكشن" والصدام مع الآخر؟ أم لكونه تعبيرا عن الرأي منطلقين من حقهم في ذلك؟ أم أن في الأمر أهدافا وغايات لا ندركها بعد؟ ولماذا لا نقدم حُسن الظن على الريبة والشك والاتهام؟ "... أوَلسنا نفاخر ونعتز بمجتمعنا في تسامحه وتعايشه وكرم أخلاقه وروحه النبيلة ولغته المهذبة وكلماته المختارة بعناية، وشخصياته الرصينة التي لا تنجر إلى جدل عقيم ولا تستفز..." كما عبَّرت عن ذلك في حسابي التويتري، فيما عمليا وعلى أرض الواقع تغيب تلك القِيَم عن حواراتنا في منصَّات التواصل، مستخدمين لغة غريبة على مجتمعنا تحتوي على الشاذ من عبارات الشتم والإقصاء والتحقير..؟ لماذا لا ننشئ صالونات ثقافية ومجالس أدبية لهذا النوع من الحوارات على غرار العديد من الدول العربية وبلدان العالم؟ إن ما يحدث في وسائل التواصل من حوارات إقصائية وخلافات عميقة واستخدام عبارات اتهامية حادة ومحاولة التصيُّد في المياه العكرة، وممارسة الوصاية والدخول في النيات وتفسير كل كلمة وفق الهوى والميول، ومراقبة وتقييم ما يكتبه كل إنسان وما يقرأه، كاتبا ومثقفا ومفكرا كان أو فردا عاديا ومحاولة تصنيفه والتشهير به، والتنمر على الآخرين والحط من قدرهم، وطرح موضوعات وقضايا تستفز المجتمع وتثير نوازعهم الدينية والمذهبية والأخلاقية والسخرية من أعرافهم ومحتوى ثقافتهم... مما يثير القلق والخوف على الوحدة الوطنية وما نؤمن به من قِيَم إنسانية، والتوجُّس من أن يقود الحوار أو الجدل الفكري ـ الفقهي في منصَّات "تويتر" إلى إثارة الشحناء والبغضاء والأحقاد و"تغذية التعصب والاصطفافات مع وضد..."، وظهور تحزبات وتيارات تثير الفرقة وتتسبب في إفساد ثقافتنا وبيئتنا وسيرتنا الصحية والنظيفة التي كانت وما زالت نموذجا للعُماني في الداخل والخارج... في حسابه على "تويتر"، كتب الدكتور أحمد الإسماعيلي ما يلي: "1- النسوية. 2- الإلحاد. 3- العلمانية. 4- الوعظ في المدارس والاختلاط. 5- الحجاب. 6- قراءة القرآن في المدارس. 7- الصلاة في المدارس. 8- الخمور. 9- الموسيقى. 10- المثلية. عشرة مواضيع تم نقاشها خلال ستة أشهر فقط في الشأن المحلي العُماني! ظاهرة جديرة بالقراءة في منطقة لا تستوعب كل هذه الأفكار!!!". ألسنا نحمِّل المجتمع فوق طاقته بطرح هذه القضايا وأشباهها، ومناقشتها والاختلاف حولها والدخول كأطراف تتصارع بشأنها؟ أوَلسنا نروِّج ونسوِّق لها ونلفت عناية الناس إليها من حيث نعتقد أننا نحاربها ونعيق نموَّها وانتشارها؟ هل لدينا إحصائيات ومعلومات وأرقام وبيانات وتحليلات وقراءات علمية ودراسات موثقة نستند إليها في كل ما نطرحه ونعلن عنه ونتناوله ونهاجمه ونحذر منه؟ هل أصبحت تغريدة واحدة لشخص مغمور أو مستهتر أو لديه أجندات وغايات مخبأة لا نعرفها، أو بحُسن نية، أو لأنه يعبِّر عن رأيه "المشروع" في فضاء ندعو فيه إلى حرية التعبير والرأي و"عدم تكميم الأفواه"... تثير مجتمعا بأكمله، فنظل أياما وليالي وأسابيع وأشهرا نتداولها ونضخها في مئات المجموعات الواتسابية ووسائل التواصل، ونجعل منها مركز اهتمامنا ونقاشنا فنحقق بذلك غايته ونعمر قلبه بالفرحة والغبطة والبهجة؛ لأنه أصبح معروفا مشهورا قادرا على إثارة واستفزاز الرأي العام وزيادة متابعيه بالآلاف...؟ وهذا ما عبَّرت عنه في إحدى تغريداتي في "تويتر" عندما كتبت "من المؤسف أننا نحقق مقاصد وغايات عدد محدود جدا من المغردين، بالترويج لهم وزيادة عدد متابعيهم وتعريف المجتمع بهم، وتحويلهم إلى أشخاص مشهورين، بل إن بعضهم يشعر بالسعادة ويملأ فراغه في أجواء "الأكشن" والاستفزاز والصدمة التي يخلقها بأفكاره وآرائه، التي لا تموت إلا بإهمالها وتجاهلها"، ولكننا للأسف الشديد لا نميتها بالصمت والتجاهل، وإنما نعلي من قيمتها ونرفع من قدرها ونحييها من جديد حتى بعد موات، فبعض التغريدات، تدور في مجموعات الواتساب حتى بعد أشهر أو سنوات من إطلاقها. لقد عبَّرت عن رأيي بكل وضوح حول هذا الموضوع في حسابي على "تويتر"، الذي لقي صدى واسعا وتعليقات مؤيدة، مع استثناءات لم تسلم ـ للأسف ـ من الغلو والتعصب في الطرح واستخدام الكلمات الحادة، تضمنت تغريدتي الآتي "ما يحدث في وسائل التواصل من نقاش فكري ـ فقهي وما يصحبه من لغة حادة، وتجييش للعواطف، ليس موقعه ـ من وجهة نظري ـ التويتر الذي يضم فضاؤه مختلف الأعمار والمستويات والانتماءات، وسواء كنا من المؤيدين أو المعارضين لهذا الرأي أو ذاك، فنحن نسهم جميعا في هذا التأجيج والتأزم والشحن وتقديم رسالة مغلوطة". وفي نقاشي مع أحد الأصدقاء الذين تحدث آراؤهم في وسائل التواصل جدلا واسعا وتتسبب في الكثير من البلبلة والتهييج، أكدت أن الجهر بهذه الأفكار لا تفيد في شيء إلا أنها تقود إلى إحداث صدمة في عقل ومشاعر الإنسان البسيط، كبير السن، الطفل، المرأة، في المدينة، في القرية، داخل السلطنة وخارجها، في تغريدة تلف الدنيا، وتوزع على آلاف المجموعات الواتسابية، فيما يتساءل أفراد المجتمع: من هذا الذي يتجرأ فيقول هذا الكلام المهول، الذي يقذف به في فضاء "تويتر"، مبررا للطرف الآخر إقناع الناس وتخويفهم وتشغيل مكينة إعلامية ضده؟ إن النقاشات والحوارات في القضايا الفكرية والوجودية والموروث الفقهي والتاريخي والثقافي... لم تكن يوما غائبة عن المشهد الإسلامي في جميع عصوره ومراحله التاريخية ومدنه وبلدانه وحواضره ومراكزه المزدهرة.. ولكنها تجرى وتنظم وفق آليات واشتراطات معروفة أساس أطرافها الغزارة العلمية والتبحر في حقول المعرفة واللغة، والثقافة الواسعة والخبرة الحياتية وتقبُّل الرأي والنقد، والمهارة والقدرة على التحاور... فهل تمتلك الأطراف "التويترية" هذه المكنات والقدرات والغزارة العلمية؟ وتتم في الصالونات والحلقات والأندية العلمية والثقافية، وفي مجالس الخلفاء والأمراء والوجهاء والعلماء والمرجعيات... في سرية وحضور محدود للخاصة دون العموم والبسطاء من الناس، أما ما يحدث هذه الأيام من جدل واسع وصراع شرس مبعثهما هذا النوع من الموضوعات في فضاء التواصل الاجتماعي وبمشاركة أو فرجة العامة في الداخل والخارج، الذين شغلتهم الحياة بهمومها وغلاء المعيشة بمشاكلها وفي برنامجهم اليومي ملفات وقضايا أهم بكثير، والتي تستخدم فيها اللغة الحادة والإقصاء والشتائم وتفتقد إلى الخطاب الواعي المهذب و"الحوار المتمدن" والتي تغلب عليها العاطفة والحمية و"تتجاوز حدود الأدب" والقدرة "على ضبط النفس"... أحيانا، فهي غير صحية البتة، وضررها أكبر من نفعها بكثير، وستؤدي حتما إن لم نتداركها إلى تغذية التعصب وإثارة النعرات وتهييج المجتمع والافتقاد إلى الاستقرار والسكينة. ومن الجانب الآخر، فإن وسائل التواصل فرضت واقعها، وعلينا أن نستثمر هذا التحول العميق، في تعزيز حرية التعبير لا تكميمها، والتواصل مع الآخر وفهم مقاصده وغاياته وتطوير أساليب الحوار معه، واستخدام خطاب راقٍ جذاب في النقاش، يحدث أثره الإيجابي على النفس وثقافة المجتمع، فوسائل التواصل فضاء عالمي ليست حكرا علينا، تطلب مسؤولية الحوار في منصَّاته الابتعاد عن اللغة الإقصائية والاتهامية والعبارات الحادة النابية التي تسيء للإنسان وتضعف حججه.