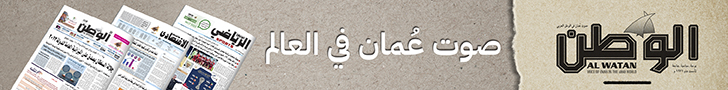ШҘШЁШұШ§ЩҮЩҠЩ… ШЁШҜЩҲЩҠ:Щ…Ш§ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© ШӘЩҒШ§ШөЩҠЩ„ ЩҒЩҠ Щ…ЩҶШӘЩҮЩү Ш§Щ„ШҜЩӮШ©ШҢ ЩӮШҜ ШӘШ®Щ„Ш· Ш§Щ„ШӯШіШ§ШЁШ§ШӘ ЩҲШӘШӯЩҠШұ Ш§Щ„Ш№ЩӮЩҲЩ„ШҢ ЩҒШӘШ®ШӘЩ„Ш· Щ„ШҜЩҠЩҶШ§ Ш§Щ„ШӯШҜЩҲШҜ Ш§Щ„ЩҒШ§ШөЩ„Ш© ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҶШёЩ„ ЩҶШіШӘШ№ШұШ¶ ЩҲЩҶШіШӘШ№ШұШ¶ ШӯШӘЩү ШӘШөЩҠШЁЩҶШ§ Ш§Щ„ШӯЩҠШұШ© ЩҮЩ„ Щ…Ш§ ЩғЩҶШ§ ЩҶШ№ШҜЩҮ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҮЩҲ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© ШЈЩ… ШЈЩҶЩҮ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ©Шҹ Щ„ШӘЩғЩҲЩҶ Ш§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш¬ШҜЩҠШҜШ© ШЈЩҲ ШҘШұЩҮШ§ШөШ§ШӘ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© ШЈШ®ШұЩү Щ„ЩҶ ШӘШӘШ¬Щ„Щү Щ„ШҜЩҠЩҶШ§ ШҜЩҲЩҶ ШӘЩҒШ§ШөЩҠЩ„ Ш¬ШҜЩҠШҜШ©. ЩҲЩ„Щ„ШӘЩҲШ¶ЩҠШӯ ЩҲЩҒЩҠ Ш®Ш¶Щ… Щ…Ш§ ЩҠШҙЩҮШҜЩҮ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… Ш§Щ„ШўЩҶ Щ…ЩҶ ШӯШұШЁ ШұЩҲШіЩҠШ© ШЈЩҲЩғШұШ§ЩҶЩҠШ© ШЁШҜШЈШӘ ЩҲЩ„Ш§ ЩҶШ№ШұЩҒ Ш№ЩҶШҜ ШЈЩҠ ШӯШҜ ШіШӘШӘЩҲЩӮЩҒ ЩҒЩҠ ШҙШұЩӮ ШЈЩҲШұЩҲШЁШ§Шҹ ШЈЩ… ШЈЩҶЩҮШ§ ШіШӘЩ…ШӘШҜ ЩҒЩҠ ЩғШ§ЩҒШ© ШұШЁЩҲШ№ Ш§Щ„Щ…Ш№Щ…ЩҲШұШ©Шҹ ЩҒШҘШ°Ш§ ШЈШұШҜЩҶШ§ ШӯЩғЩ…Ш§ ШҜЩӮЩҠЩӮШ§ Ш№Щ„Щү ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӯШұШЁ Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҶШ№ШҜЩҮШ§ ШЁШҜШЈШӘ Ш§Щ„ШўЩҶ ЩҒШіЩҶШәШұЩӮ ЩҒЩҠ ШӘЩҒШ§ШөЩҠЩ„ ЩғШ«ЩҠШұШ©ШҢ ЩӮШҜ ШӘШөЩ„ ШЁЩҶШ§ Щ„ШӘШөЩҲШұ ШЈЩҶ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„Ш§ШӘШӯШ§ШҜ Ш§Щ„ШіЩҲЩҒЩҠШӘЩҠШҢ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШұШЈЩҠЩҶШ§ЩҮШ§ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Щ„ШҜЩҲЩ„Ш© ЩғШЁШұЩүШҢ ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮЩҠШ© Щ„Щ…Ш§ ЩҶШ№ЩҠШҙЩҮ Ш§Щ„ШўЩҶШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠШұЩү Ш§Щ„ЩҲШ§ЩӮЩҒЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®ЩҶШҜЩӮ Ш§Щ„ШұЩҲШіЩҠ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Щ„Ш№ЩҲШҜШ© Ш§Щ„Ш«ЩҶШ§ШҰЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ЩҒЩӮЩҲШҜШ©ШҢ ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠШұШ§ЩҮШ§ ШЈШөШӯШ§ШЁ Ш§Щ„Щ…ШөШ§Щ„Шӯ Ш§Щ„Щ…Ш¶Ш§ШҜШ© ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Щ„Ш№ЩҮШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠ.ШЈЩ…Ш§ ЩҶШӯЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӘШ¶ШұШұЩҲЩҶ Щ…ЩҶ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӯЩ…Ш§ЩӮШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШұШӘШЁШ·Ш© ШЁШЈШ·Щ…Ш§Ш№ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩғШЁШұЩү ЩҒЩҠ Щ…ЩӮШҜШұШ§ШӘЩҶШ§ ЩҒЩҶШұШ§ЩҮШ§ Ш§Щ…ШӘШҜШ§ШҜШ§ Щ„Щ…Ш§ ЩӮШұШЈЩҶШ§ЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШЁ ЩҲШ§Щ„ШЁШ№ЩҠШҜШҢ Ш№ЩҶ ШҜШ§ШҰШұШ© Щ…ШӘЩҲШ§ШөЩ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ Щ…ШӘЩ„ШӯЩҒШ© ШЁШҙШ№Ш§ШұШ§ШӘ ЩҲШ·ЩҶЩҠШ© ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…Ш№ШіЩғШұ ШЈЩҲ Ш°Ш§ЩғШҢ ШӘЩӮЩҲШҜ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ЩҶШӯЩҲ Ш§Щ„Ш¬ЩҶЩҲЩҶШҢ ЩҲШіШӘШіШӘЩҶЩҒШҜ Ш«ШұЩҲШ§ШӘЩҮ ШЁЩ…ШІШ§Ш№Щ… ЩғШ§Ш°ШЁШ©ШҢ ШіЩҠЩҒШұШ¶ЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘШөШұШҢ ЩҲШіШӘШёЩ„ ШЈЩғШ§Ш°ЩҠШЁ Ш§Щ„Щ…ЩҮШІЩҲЩ… ЩҒЩҠ Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„Ш®Ш§ЩҶШ©. ЩҒШ§Щ„Щ…ЩҶШӘШөШұЩҲЩҶ ЩҮЩ… Щ…ЩҶ ЩҠЩғШӘШЁЩҲЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩҲЩ„Ш№Щ„ ЩӮШұШ§ШЎШ© Щ…ШӘШЈЩҶЩҠШ© Щ„Щ…Ш§ ШӯШҜШ« ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҶШёЩҶ ШЈЩҶЩҮ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Щ„Щ„ШӯШұШЁ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠШ© Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ ШіЩҠЩӮЩҲШҜЩҶШ§ Щ„ЩҲШ§ЩӮШ№ЩҶШ§ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҶШ№ЩҠШҙЩҮШҢ ЩҒШ§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® Ш§Щ„Щ…ЩғШӘЩҲШЁ ЩҠШӘШӯШҜШ« Ш№ЩҶ ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ ЩҮШӘЩ„ШұШҢ ЩҒЩҠ ШҜЩҲЩ„ Ш§Щ„Ш¬ЩҲШ§ШұШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠ Ш§ЩҶШ·Щ„ЩӮ ШЁШ§Ш¬ШӘЩҠШ§Шӯ ШЁЩҲЩ„ЩҶШҜШ§ ШӘШӯШӘ ШІШ№Щ… (ШӯЩ…Ш§ЩҠШ© Ш§Щ„ШӯШҜЩҲШҜ ЩҲШ§Щ„ШЈЩӮЩ„ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШ§Ш·ЩӮШ© ШЁШ§Щ„ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ©)ШҢ ЩҲШӘЩҲШ§ШөЩ„ ШӘШӯШӘ ШөЩ…ШӘ ШЈЩҲ (Ш®ЩҲЩҒ) ШәШұШЁЩҠШҢ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§Ш¬ЩҮШ© ЩҲШ§Щ„Ш§ЩғШӘЩҒШ§ШЎ ШЁЩҖ(Ш§Щ„ШӘЩҶШҜЩҠШҜ ЩҲШ§Щ„Ш§ШіШӘЩҶЩғШ§Шұ)ШҢ ШЁШұШәЩ… ШЈЩҶ Ш°Ш§Щғ Ш§Щ„ШәШұШЁ ШӘШ№ЩҮШҜ Щ„ШЁЩҲЩ„ЩҶШҜШ§ ШЁШ§Щ„ШӯЩ…Ш§ЩҠШ©ШҢ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© ЩғШ§ЩҶШӘ ШіШӘЩғШӘШЁ ШЁШ·ШұЩҠЩӮШ© ШЈШ®ШұЩү Щ„ЩҲ Ш§ЩҶШӘШөШұ Ш§Щ„ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶ ЩҲШ§Щ„Щ…ШӯЩҲШұШҢ ЩҲШіШӘШӘШӯЩҲЩ„ ШЈЩ„ЩҒШ§Шё ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШЈЩ„ЩҒШ§Шё Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШЁШұШІ ШЈШӯЩӮЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘШөШұ Ш§Щ„ШЈШ®Щ„Ш§ЩӮЩҠШ© ЩҒЩҠ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӯШұШЁ.Щ„ЩғЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮШ© ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ШҙЩҮШҜ Щ„Щ… ЩҠЩғЩҶ ЩӮШ· ЩҮЩҲ Ш§ЩҶШ·Щ„Ш§ЩӮ ШҙШұШ§ШұШ© Ш§Щ„ШӯШұШЁ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠШ© Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ Щ„ЩғЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮЩҠШ©ШҢ ЩғШ§ЩҶШӘ Щ…Ш№ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШӯШұШЁ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ЩүШҢ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҠ ЩҶШӘШ¬ Ш№ЩҶЩҮШ§ ШӘШіЩҲЩҠШ§ШӘ ШЈШҜШӘ Щ„ЩӮЩҮШұ Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҮШІЩ…ЩҠЩҶ ЩҒШЈШЁШұЩ…ШӘ Щ…Ш№Ш§ЩҮШҜШ§ШӘ Ш№ЩӮШ§ШЁЩҠШ© ШЈШ®Ш°ШӘ Ш·Ш§ШЁШ№ Ш§Щ„Ш§ЩҶШӘЩӮШ§Щ… Ш¶ШҜЩҮЩ…ШҢ Щ…Щ…Ш§ ШЈЩҲШ¬ШҜ Ш¶ШәЩҠЩҶШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩҒЩҲШі Ш§Щ„ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҲЩғШ§ЩҶШӘ Щ…ЩҒШӘШ§Шӯ Ш§Щ„ШӘШ¬ЩҠЩҠШҙ ЩҲШ§Щ„ШӘШӯШҙЩҠШҜ Ш§Щ„Щ„Ш°ЩҠЩҶ Ш§Ш№ШӘЩ…ШҜ Ш№Щ„ЩҠЩҮЩ…Ш§ ЩҮШӘЩ„Шұ ЩҒЩҠ ШҘШ№Ш§ШҜШ© ЩҮЩҠШЁШ© ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© Щ…ШұШ© ШЈШ®ШұЩүШҢ Щ„ШӘШ®ШӘЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯШҜЩҲШҜ Ш§Щ„ЩҒШ§ШөЩ„Ш© ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҶШҜЩҲШұ ЩҒЩҠ ШҜШ§ШҰШұШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ ЩҲШ§Щ„ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ Ш§Щ„Щ…ШӘШЁШ§ШҜЩ„Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШәШұЩҠШЁ ШЈЩҶ ЩҒЩҠ ЩҲШ·ЩҶЩҶШ§ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Щ…ЩҶ Щ„Ш§ ЩҠШІШ§Щ„ ЩҠШӯШ§ЩҲЩ„ ШЈЩҶ ЩҠЩӮЩҒ Щ…Ш№ Ш·ШұЩҒ Ш¶ШҜ Ш§Щ„ШўШ®ШұШҢ ЩҲЩҮЩҲ ШЈЩ…Шұ ШЈШҙШЁЩҮ ШЁЩ…Ш§ ШұЩҲЩҠ Ш№ЩҶ ШөШұШ§Ш№ ШЈЩ… ЩғЩ„Ш«ЩҲЩ… ЩҲШЈШіЩ…ЩҮШ§ЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯШұШЁ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠШ© Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠШ©.ШЁШәШ¶Щ‘Щҗ Ш§Щ„ЩҶШёШұ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ§ШӘ ШЈЩҲ Ш§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ§ШӘШҢ Щ„ЩғЩҶ Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮШ© Ш§Щ„ЩғШЁШұЩү Ш§Щ„Ш¬Щ„ЩҠШ© ШЈЩҶ Щ…Ш§ ЩҒШ§ШӘ ЩҲЩ…Ш§ ЩҮЩҲ ЩӮШ§ШҜЩ…ШҢ ШіЩҲШ§ШЎ ЩғШ§ЩҶ ШӯШ§Ш¶ШұШ§ ШЈЩҲ ШӘШ§ШұЩҠШ®Ш§ШҢ ШЈЩҲ ШӯШӘЩү Щ…ШіШӘЩӮШЁЩ„Ш§ Щ„Ш§ ШЁЩҸШҜЩ‘ЩҺ ШЈЩҶ ЩҶШ№ЩҠ ШЈЩҶЩҮ ШөШұШ§Ш№ ШЁЩҠЩҶ ШҜЩҲЩ„ ЩғШЁШұЩү Ш·Ш§Щ…Ш№Ш© ЩҒЩҠ ШіЩҠШ§ШҜШ© Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ЩҲШіШұЩӮШ© Щ…ЩӮШҜШұШ§ШӘЩҮШҢ ЩҲШЈЩҶ ШҙЩҮЩҲШ© Ш§Щ„ШіЩҠШ§ШҜШ© Щ„ШҜЩҠЩҮЩ… ЩҮЩҠ Ш§Щ„Щ…ШҜШ®Щ„ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШіЩ„ЩғЩҮ ШІШ№Щ…Ш§ШӨЩҮЩ… Щ„ЩӮЩҠШ§ШҜШӘЩҮЩ… ЩҶШӯЩҲ Ш§Щ„ШӘЩҮЩ„ЩғШ©ШҢ ШӘЩҮЩ„ЩғШ© ЩҠШҜЩҒШ№ЩҮШ§ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ШЈШ¬Щ…Ш№. ЩҲШ§Щ„ШәШұЩҠШЁ ШЈЩҠШ¶Ш§ ШЈЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҒШӘШұШ¶ ШЈЩҶ Щ…Ш§ ЩҠЩ…ЩҠШІ Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶ ШҜЩҲЩҶ ШіШ§ШҰШұ Ш§Щ„Щ…Ш®Щ„ЩҲЩӮШ§ШӘ ЩҮЩҲ ЩӮШҜШұШӘЩҮ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШӘШ№Щ„Щ…ШҢ ЩҲШ§Щ„ШӘШ·ЩҲШұ Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ЩҠШҢ Щ„ЩғЩҶ ЩҠШЁШҜЩҲ ШЈЩҶ Ш§Щ„ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ ЩҲШҙЩҮЩҲШ© Ш§Щ„ШіЩҠШ§ШҜШ© ШӘЩ„ШәЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҠШІШ©ШҢ ЩҲЩҶШөШЁШӯ ЩғЩ…Ш§ ШЈЩ…ШіЩҠЩҶШ§ ШҜЩҲЩҶ ШӘШ№Щ„Щ… Ш§Щ„ШҜШұЩҲШіШҢ ЩҲЩ„Щ„ШӘШЈЩғЩҠШҜ ШЈЩҶШёШұ Щ„Щ„ШӯШ§Щ„Ш© Ш§Щ„ШӯШ§Щ„ЩҠШ© ШЁШӘЩ…Ш№ЩҶШҢ ЩҲШ§ШіШӘШЁШҜЩ„ ШЈШіЩ…Ш§ШЎ ЩҲЩ…ШіЩ…ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„ШҢ ШЈЩҲ Ш§Щ„ШЈШҙШ®Ш§ШөШҢ ЩҒШіШӘШ¬ШҜ ШІШ№ЩҠЩ…Ш§ ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ§ Ш¬ШҜЩҠШҜШ§ ЩҠШӘШӯШҜШ« Ш№ЩҶ ШӯЩ…Ш§ЩҠШ© ШӯШҜЩҲШҜЩҮ ЩҲШ§Щ„ЩҶШ§Ш·ЩӮЩҠЩҶ ШЁЩ„ШәШӘЩҮШҢ ЩҲШіШӘШ¬ШҜ ШЁЩҲЩ„ЩҶШҜШ§ Ш¬ШҜЩҠШҜШ© Ш§ШіШӘЩ…Ш№ШӘ Щ„ЩғШЁШ§Шұ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ШҢ ЩҲШіШӘШ¬ШҜ ШЈЩҶ ЩҮШӨЩ„Ш§ШЎ ШӘШ®Щ„ЩҲШ§ ШЈЩҠШ¶Ш§ Ш№ЩҶЩҮШ§ ЩҲШӘШұЩғЩҲЩҮШ§ ЩҲШӯШҜЩҮШ§ШҢ ШӯШӘЩү ШӘЩӮШӘШұШЁ Ш§Щ„ШЈШ®Ш·Ш§Шұ Щ…ЩҶЩҮЩ… ЩҒШӘЩҶШҙШЁ ШӯШұШЁ ШҜЩ…ЩҲЩҠШ© ЩҶШҜЩҒШ№ ЩҶШӯЩҶ Ш«Щ…ЩҶЩҮШ§.ЩҲЩ„Ш§ ШЈШ№Щ„Щ… ЩҲЩӮШӘЩҮШ§ Щ…ЩҶ ШіЩҠЩғШӘШЁ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® Щ„ЩҠШӯШҜШҜ ЩҮЩ„ ЩғШ§ЩҶШӘ Ш§Щ„ШЈШ·Щ…Ш§Ш№ ЩҮЩҠ Щ…ЩҶ ШӘШӯШұЩғ ШұЩҲШіЩҠШ§ ЩҲШӘШҜЩҒШ№ЩҮШ§ Щ„Ш§ШӘШ®Ш§Ш° Ш®ЩҠШ§ШұШ§ШӘЩҮШ§Шҹ ШЈЩ… ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® ШіЩҠЩғШӘШЁ ШЁШЈЩҠШҜЩҚ ШұЩҲШіЩҠШ© ЩҲШіЩҠШұЩҲЩҠ Щ…Щ„ШӯЩ…ШӘЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҜЩҒШ§Ш№ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҙЩ…ЩҲШ® Ш§Щ„ЩҲШ·ЩҶЩҠШҹ ЩҲЩғЩҠЩҒ ШЈЩҶ Щ…ЩҲШіЩғЩҲ ШӯШ§ШұШЁШӘ ЩҲЩҶШ§Ш¶Щ„ШӘ Щ…ЩҶ ШЈШ¬Щ„ Ш№ЩҲШҜШ© ШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҮШ§ШҢ ЩҲШҘШЁШ№Ш§ШҜ Ш§Щ„Ш·Ш§Щ…Ш№ЩҠЩҶ Ш№ЩҶ Щ…ШӯЩҠШ·ЩҮШ§ Ш§Щ„ШҘЩӮЩ„ЩҠЩ…ЩҠШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ ШӘШ¬ШұШЈЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ЩҲШЈШҜЩҲШ§ ШҘЩ„Щү Ш§ЩҶЩҮЩҠШ§Шұ ШҜЩҲЩ„ШӘЩҮШ§ Ш§Щ„ЩғШЁШұЩү ЩҒЩҠ ШЈЩҲШ§ШҰЩ„ ШӘШіШ№ЩҠЩҶЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШұЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҶШөШұЩ…Шҹ ШЈЩ… ШіЩҠЩғШӘЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…ЩҠШ№ ШЁЩ…Ш§ ШӯШҜШ« ШӯЩӮЩҶШ§ Щ„ШҜЩ…Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§ЩҠЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЁШҙШұШҹ ЩҲШіЩҠШ№Щ„Щ…ЩҲЩҶ ШЈЩҶЩҮ Ш№Ш§Щ„Щ… Щ„Щ„Ш¬Щ…ЩҠШ№ШҢ ЩҲШ№Щ„Щү ЩғШ§ЩҒШ© Ш§Щ„ШЈШ·ШұШ§ЩҒ Ш§Щ„Щ…ШӘШӯШ§ШұШЁШ© ЩҲЩ…ЩҶ ЩҠШҜШ№Щ…ЩҮЩ… ШЈЩҶ ЩҠЩӮШұШЈЩҲШ§ Ш§Щ„Щ…Ш§Ш¶ЩҠ Щ„ЩҠШ№Щ„Щ…ЩҲШ§ ШӯШ¬Щ… Ш§Щ„ЩғШ§ШұШ«Ш© ШҘШ°Ш§ ЩғШұШұЩҶШ§ Щ…Ш§ ШӯШҜШ« ШЁЩ…Ш§ ЩҶЩ…Щ„ЩғЩҮ Щ…ЩҶ ШЈШҜЩҲШ§ШӘ.