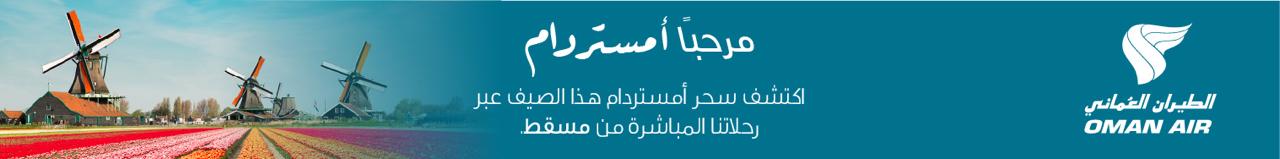سعود بن علي الحارثي:الكتاب من تأليف المؤرخ الإسباني المعروف "إجناسيو أولاجوي"، صدر عن "مركز نهوض للدراسات والنشر" تصل عدد صفحاته إلى "٦٨٨". أستطيع أن أقيمه كدراسة عميقة أخذت المنهج العلمي، ونفس الباحث الطويل كان بارزا في إعدادها ومضامينها الشاملة، وصفها المحققون بأنها "على درجة عالية من الدقة العلمية والتوثيقية والمعرفية، ومسلحة ببليوجرافيا نقدية واسعة ومتنوعة ومعقدة جلها من النصوص القديمة" المؤرخ من الشخصيات الأكاديمية المعروفة في إسبانيا خاصة وأوروبا على وجه العموم، سعى "إجناسيو أولاجوي" إلى إثبات رؤيته بأن "الوجود الإسلامي في الأندلس لم يكن "فتحا عسكريا" أو جهادا مسلحا، مبتغيا تمددا دينيا، بل كان حركة أفكار متصارعة ومتشابكة، تقدمت فيها "الفكرة/القوة" التي عمقت رؤية العالم للإسلام على أنه دين الفكرة والحضارة بدلا من الرؤية "الأسطورة" دين العنف والقوة"، "لقد استطاعت قوة الأفكار بسهولة كبيرة أن تملأ الفراغ الكبير الذي كان موجودا آنذاك، فالفترة حينئذ كانت مناسبة لذلك، حيث أجواء تطور الأفكار الدينية والفكرية، فحينها كانت الحضارة العربية قد ارتقت مرتقى حار الإسبان جميعا أمامه، وعندما وصلت هذه الأفكار التي جاءت من الشرق استطاعت أن تثير جموع الشعب التي كانت متهيئة لاستقبالها، وأن تطلب صياغة تلك الحالة الجديدة والفريدة مزيدا من الوقت. ورويدا رويدا بلغت الثقافة العربية الأندلسية قمم عبقريتها في القرن الحادي عشر". قدم الكاتب شروحات تفصيلية لتطور الأفكار الدينية في مرحلة ما قبل الوجود الإسلامي في إسبانيا وتنافسها بين العقيدة التوحيدية وعقيدة الثالوث والآريوسية صحبتها صراعات وحروب أهلية بين عدد من الممالك والحكام ورجال الدين، في وقت ضرب فيه الجفاف القاسي البلاد وأهلك الحرث والنسل، وهي جميعها مهدت البيئة الحاضنة للإسلام. أما أسطورة الغزو أو الفتح المسلح، وفقا لمصادر اعتمد عليها الكاتب فقد انطلقت في الأساس من مصر على شكل قصص وحكايات شعبية، وتسربت من هناك إلى إسبانيا، نقلها طالب يدرس في القاهرة، واستثمرت وضخمت في فترات زمنية لاحقة من قبل المتعصبين المسيحيين المناوئين للإسلام لبث الكراهية والحقد وتأسيس بنية اجتماعية سياسية عسكرية لطرد العرب فيما بعد. وعلى هذا التأسيس التاريخي، فإن الحقيقة التي توصل إليها الكاتب بالحجة والأسانيد لتتوافق مع رؤيته، صدمت إسبان اليوم الذين تشكلت مناهجهم وثقافتهم وعقولهم على حقيقة أن المسلمين المستعمرين ما هم إلا رعاع همج قساة القلوب بدو أجلاف يأكلون لحوم البشر، وتسببوا في دمار الإرث والتاريخ والثقافة الإسبانية وارتكبوا المذابح ونكلوا بالإسبان... "أنا مولود في قرطبة أئن وأتألم تحت نير حكم العرب القاسي" "كيف سمح الرب بمثل هذه الأمور البغيضة، كيف أيد الرب أعداء السيد المسيح؟". لهذا السبب رفضت جميع دور النشر الإسبانية طباعة الكتاب لعدَّة سنوات، فاستخدم مؤلفه علاقته الوثيقة بالمؤرخ الفرنسي "فرنان بروديل" لـ"يتوسط له في نشر كتابه، وبفضله أماطت عنه اللثام إحدى كبريات دور النشر الفرنسية، فلقي شهرة كبيرة في الوسط الفرنسي"، ما أجبر بعض دور النشر في إسبانيا إلى طباعته فيما بعد، لكنها غيرت العنوان، كي لا يتعارض مع ذائقة الإسبان الذين اعتادوا وعاشوا على ثقافة أن العرب غزاة، لتفاجئهم هذه الدراسة بنتائج مختلفة تماما بعد أن نفى الكتاب "حدوث استعمار عربي لإسبانيا، حيث يعد أن نشأة الحضارة الإسلامية في الأندلس كانت نتيجة تقبل الإسبان لها بسبب التقارب الكبير بين العقيدة المسيحية الأريوسية التي كانت سائدة قبل مجيء المسلمين. لأن اعتقاد الإسبان بتلك العقيدة التوحيدية التي ترفض الثالوث، جعلهم يرون في الإسلام دينا منسجما مع تصورهم الاعتقادي؛ مما سهل نفوذه في وجدانهم الديني". الكاتب قرأ مئات المراجع الأوروبية والإسلامية والإسبانية، خصوصا الحوليات القديمة تاريخية وجغرافية، ووضع سيناريوهات الطرق التي سلكتها جيوش الفتح من البربر والعرب التي انضوت تحت لواء الإسلام، وحدد مسافاتها والزمان الذي تطلبته على أساس المنطق السائد القائم على الفتح المسلح آنذاك، وحلل الشواهد البيولوجية ووسائل التغيرات المناخية كي "يتمكن من إعادة فهم التأثير المناخي في الماضي" والتي قادته إلى استحالة إثبات حقيقة مشروع الغزو الذي تم التسويق له طوال الفترة التاريخية الطويلة منذ القرن السابع الميلادي وحتى اليوم، فالرقعة الجغرافية الشاسعة بين مركز الخلافة الإسلامية، والمرحلة الزمنية للفتوحات الإسلامية المقررة بحوالي ستين عاما سنة التي تم فيها اكتساح مصر ومناطق شمال إفريقيا وإسبانيا، والطرق الصحراوية الطويلة والشاقة والوعرة الفاصلة بين كل هذه المناطق، وما تتطلبه الجيوش الجرارة من وسائل نقل برية وبحرية وقدرات تموينية جميعها تنسف فكرة الغزو من أساسه، لذا شكل الفتح الإسلامي مشروعا تجاوز المنطق في تلك الفترة فنظر إليه كل طرف من منظور ديني لتفسيره، فقد أعتبره المسيحيون عقوبة إلهية لفساد الإسبان وتسليط من الرب أن سهل لهؤلاء البدو الهمج السيادة عليهم، فيما فسره المسلمون معجزة إلهية تؤكد على عظمة الإسلام وأنه الدين الحق المؤيد من الله... ومع ذلك فإن الكتاب لا يخلو من الضبابية واللبس والخلط والازدواجية أحيانا، حيث ظلت أسئلة مهمة كثيرة مبهمة، معلقة بدون إجابات، ولم يقدم الكاتب سيناريوها واضح المعالم يعطي تفسيرات مقنعة لوجود الإسلام في الأندلس خارج حقيقة الفتح المسلح الذي تحدثت عنه كتب التاريخ، إلا كونها قوة أفكار وجدت بيئة ممهدة لتقبلها وانتشارها، فكيف وصلت هذه الأفكار؟ هل عن طريق الجيوش المسلحة أم الأفراد والجماعات المدنية؟ ومن هم هؤلاء الأفراد؟ وكيف استقبلهم الإسبان؟ وكيف أصبح العرب ملوكا فسيطروا على عموم إسبانيا وأجزاء من البرتغال وفرنسا؟ الكاتب لم يقدم تفصيلا واضحا لتاريخ ومراحل وصول العرب إلى الجزيرة الآيبيرية بحجة غياب المعلومات وتدمير الوثائق التي تؤرخ لتلك الفترة، لذلك فإن الحجج والدلائل التي قدمها لا تزال غير كافية، ولا يمكن الاطمئنان إليها بدرجة عالية، ولا التسليم بالنتائج التي توصل إليها، وستبقى الحقائق التاريخية التي تضمنتها المصادر العربية والإسلامية هي الأقرب لسيناريو الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا. أنصف الكاتب الإسلام في شواهد كثيرة تضمنها كتابه، ما يضعه في قائمة الكتَّاب الموضوعيين الذين يستحقون الاحترام وتقديم حسن النية من غاياته وأهدافه بإصدار كتابه القيِّم، "الإسلام هو أكثر الديانات المنزلة الثلاثة قدرة على النفاذ إلى الجماهير، الأمر الذي يفسر انتشاره السريع"، "علا شأن الدين الجديد المؤيد بالقرآن، وارتقت اللغة العربية حتى وصلت إلى الذروة الأدبية. لقد توسع الإسلام والحضارة العربية بفضل القوة الفكرية الرئيسة" "إن ما يميز هذه الميتافيزيقيا وما يلفت الانتباه إليها هو بساطتها الشديدة، حيث تقتصر على أن الله واحد، وهذا مكمن عظمتها، وهي المكمن الذي يتسم بنقاء العقيدة الإسلامية، وهي تتفوق ببساطتها الشديدة على الميتافيزيقا المسيحية، وبهذا يفهم أن التوحيد الإسلامي كان قادرا على جذب الجماهير.." "تحولت الأندلس إلى مركز حضاري مهم، فيها من الثروات ما فيها، وربما كانت أهم حضارة أقيمت في الغرب مقارنة بما كان موجودا قبل ذلك في القسطنطينية أو في بغداد، وأصبحت أحد المراكز الرئيسة للحضارة العربية أو حضارة الثقافة العربية الأندلسية، التي بدأت تؤتي أكلها في القرن التاسع الميلادي". ولكي يكون منصفا أورد شهادات تعبِّر عن التسامح والتعايش في ظل الدولة الإسلامية "نعيش بين هؤلاء دون أن يزعجنا أحد في ممارسة طقوس عقيدتنا". الكاتب قدم كذلك عرضا موسعا للتاريخ الإسلامي منذ نشأته، وفند الكثير من المسلمات، فاعتبر النصوص والأخبار والأقوال وسرد الأحداث التاريخية التي وثقتها كتب المسيحيين الإسبان أو المسلمين معظمها خرافة، ومن بين النماذج التي أشار إليها "الحملة الإسلامية الثانية الموجهة ضد الغساسنة" إذ أكد المؤرخون على "أن الجيش الإسلامي مكوَّن من عشرة آلاف فارس، واثني عشر ألف جمل"، وعلق الكاتب على أن الدراسات العلمية أثبتت بأن الخيل والإبل لا يمكن أن تعيش وتنسجم معا لاختلاف خصائصها، و"تنافر الخيل والجمال" بسبب "الرائحة الصادرة عن كل" منها. كما أن شح المياه والغذاء في الجزيرة العربية يستحيل أن تصلح لتربية وعيش هذا العدد من الخيول للكميات الهائلة التي تحتاجها من الأكل والشرب. ومن الجانب الآخر فإن معركة "بواتييه" التي هلل لها الغرب واعتبرها المسيحيون نجاحا باهرا وتوفيقا من الله لـ"شارل مارتل" لأنه "قضى فيها على المد العربي نحو الغرب" يراها الكاتب من منظور مختلف لا تعدو "أن تكون مجرد معركة بسيطة، واجه فيها أناس من الجنوب أناسا آخرين في شمال فرنسا"، متسائلا الكاتب باستغراب "لماذا أضفى المؤرخون المسيحيون على هذه المعركة ـ والذين كتبوا أحداثها بعد ذلك بوقت طويل ـ الصفة الأسطورية، واعتبروا أنها هي التي أنقذت الحضارة المسيحية؟ أليس يعد ذلك خرافة ظلت متداولة حتى عصر الذرة؟" ولو سلمنا بكل ما أورده الكاتب من حجج ورؤى، فماذا نصنع بالشخصيات الأشبه بـ"الأسطورة" في تاريخنا إذن، تاريخ فتح الأندلس؟ طارق بن زياد، موسى بن نصير، عبد الرحمن الداخل "صقر قريش"... الأول وبحسب ما توصل إليه الكاتب ـ ملك قوطي على "طنجة" تم تحريف اسمه إلى "طارق" ليتوافق مع الأسطورة "كان طارق ومن معه ينتمون إلى نفس الفريق السياسي لأبناء غيطشة، وكذلك كان حاكما لمقاطعة طنجة طبقا للتراث البربري" والثاني شيخ فقيه، وصل الأندلس كداعية إسلامي "إما أن يكون موسى شخصية أسطورية أو أحد أوائل الدعاة إلى الإسلام في شبه الجزيرة الآيبيرية". فما ادعته كتب التاريخ من نزاع خطير وغيرة مستعرة استفحل أوارها بين الاثنين على كنز حصل عليه الأول في طليطلة كادت أن تمسح إنجازاتهما العسكرية، حتى تم استدعاؤهما إلى مركز الخلافة في دمشق للصلح بينهما، ما هي إلا واحدة من تلك الأساطير التي حشيت بها كتب التاريخ وفقا لرؤية الكاتب، أما عبد الرحمن الداخل فهو داهية ادعى نسبه إلى بني أمية القرشيين في وقت كان فيه الشغف والتنافس على أشدهما بين العرب والإسبان للانتساب إلى عائلات شريفة كوسيلة لتقلد المناصب والحصول على الامتيازات، ومنهم عبد الرحمن الذي ساعدته حكمته في تحقيق طموحاته ببلوغ السيادة والحكم. ولا يفوت الكاتب أي فرصة لطرح التساؤلات المشككة في النصوص التاريخية المتوارثة "الأسطورة" التي استمدت قوتها التاريخية بمرور الأيام، وأصبحت مرجعا مهما للمؤرخين المتأخرين دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتفكير والتحليل المنطقي وإخضاع الأخبار إلى العقل، وإلا كيف وصلت كل تلك القبائل وزعاماتها من القيسية واليمانية لتتقاتل على سيادة الأرض الإسبانية؟ فيأتي بعد سنوات عبد الرحمن هذا ليخضعهم لسيفه ويقودهم للإجماع على خلافته ومبايعته، والإسبان في موقف الفرجة لا يحركون ساكنا، وكأن لا وجود لهم؟ "وإذا ما تم تطبيق المنهج العلمي بأمانة ونزاهة سوف نجد أن نصف ما تتحدث عنه النصوص من أحداث جرت في الأزمنة القديمة يجب شطبه". خصص الكاتب فصلا كاملا عن "جامع قرطبة" عبأه بقراءات وتحليلات وتفسيرات للمصادر الشحيحة أصلا، وتقديم مقارنات لفنون العمارة الآيبيرية والشرقية الإسلامية وتمازجهما، وطرح تساؤلات عن الغاية الأساسية من إنشاء الجامع، هل للعبادة والصلاة؟ أم لأغراض أخرى؟ وهل كان معبدا أو كنيسة رمم وعدل في بنائه ليصبح جامعا إسلاميا؟ أم بناء جديدا أسس كمسجد؟ وبذل المؤلف جهدا كبيرا لتأسيس نتيجة قوامها أن "جامع قرطبة" كان مبنى كنسيا حوله المسلمون إلى جامع للصلاة، "هل كانت غابة الأعمدة أو الأروقة ابتكارا عبقريا للمهندس المعماري الذي شيد دار العبادة هذا؟ أم كان تقليدا لنموذج سابق"؟ ولكنه لم ينجح في ذلك، فترك المسألة متأرجحة بين فرضيتين، الأولى: "أن عبد الرحمن هو المشيد الحقيقي لهذا الأثر". الثانية "وجد الأمير البناء مهيأ من داخله، وبالتالي قام بالحفاظ عليه فيما بعد، وفقط في عام ٧٨٥م، قام ببعض التغييرات قليلة الشأن". الكاتب يرى أن الوجود الإسلامي في الأندلس لم يكن فتحا، وإلا ما استمر لعدة قرون وكان له هذا الأثر البالغ "فالفتوحات بالأسلحة سريعة الزوال عندما لا تكون نتاج التوجيه الفكري، وقد كان تاريخ البشر ثمرة لعبة قوة الأفكار، التي تنتشر بدفع من طاقتها، وتتقهقر حال ضحالتها". لا شك لدي بأن مضامين الرسالة الإسلامية المنفتحة والشاملة ومثله الإنسانية العظيمة، وقوة الجيوش العربية وهمم الرجال وإيمانهم العميق اجتمعت كلها لصناعة تلك "الأسطورة" الحقيقة، فأنشأت حضارة عربية إسلامية كانت اللبنة المؤسسة للحضارة الإنسانية المعاصرة. وهذا لا يمنع أن ننصف الكتاب فنضعه في الدرجة الرفيعة قيمة وثراء ويستحق القراءة، ويطرح تساؤلات وفرضيات ويتوصل إلى نتائج وخلاصات الكثير منها بني على أسس وحقائق علمية يصعب تجاهلها.