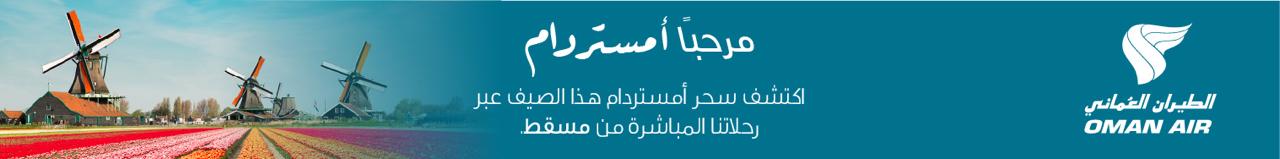[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2017/03/rajb.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. رجب بن علي العويسي[/author]يبدو أن التعامل مع الانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية مثل: أمراض الفشل الكلوي والسكري عند الأطفال والكبار، وأمراض الكبد والقلب والشرايين الرئوية والرئتين، وأمراض العظام، ونقص الدم وفقره، وزيادة السمنة والكولسترول والسرطانات بأنواعها والضغط وزيادة الجلطات والنوبات القلبية والوعكات الصحية المفاجئة وغيرها في مجتمع السلطنة والمخاطر الناتجة عنها وما ترتب عليها من أزمات صحية ونفسية واجتماعية خطيرة على المستوى الوطني والاجتماعي والأسري والشخصي؛ لم يعد حالة اختيارية مزاجية مؤسسية أو فردية في ظل تزايد الحالات واتساعها وانتشارها بين أبناء المجتمع الأطفال منهم والشباب والكبار بصورة لافتة، ولم يعد الوقت مناسبا لتوجيه اللوم أو محاولة تبرير المواقف أو وضع المواطن في قفص الاتهام والإشارة إليه بأنه من يعنيه هذا الأمر أو بأنه شخصيا قد تسبب في الوصول إلى هذا المستوى خصوصا عند الحديث عن الأمراض غير المعدية الناتجة عن أسباب غير وراثية؛ بل أصبح الأمر خيارا استراتيجيا، وأولوية وطنية يجب التعاطي مع مسبباتها ودوافعها ومعطياتها بحزم، وأن تتكاتف جهود المؤسسات والأفراد والجهات ذات العلاقة بالصحة عامة أو المعنية بإنتاج الغذاء وتسويقه أو حتى تلك التي تقدم خدماتها الموجهة لتعزيز الصحة النفسية والترويحية واللياقة البدنية، وعبر الاتفاق على عمل مشترك تجتمع حوله كل الجهود وتتقاسم في سبيله تحقيق مسؤوليات العمل في توفر البيئات الصحية الداعمة لإنتاج صحة المواطن، وإعادة إنتاج أو توفير الحلول الاستراتيجية للحد من انتشارها أو إيقاف حالة اتساعها؛ لتدق ناقوس الخطر وتعلن حالة الطوارئ القصوى التي يجب أن تتجه لها القطاعات المعنية بالصحة والغذاء والنظافة والرياضة، عبر رفع سقف الجاهزية الوقائية والعلاجية والتشخيصية للمواطن في الحد من انتشارها أو وقف اتساعها وانتشارها بين أوساط أبناء المجتمع وبناته.وحتى نكون أكثر قربا في تشخيص الحالة، فإن المسح الوطني للأمراض غير المعدية الذي دشنته وزارة الصحة وبدأت ملامح عمله منذ عام 2017، أعطى رسالة البدء في عمل وطني مشترك ومسار مؤسسي مجتمعي مقنن، واعتراف وطني بالحاجة إلى إعادة إنتاج الوضع الصحي للمواطن العماني بصورة مستعجلة تفوق كل الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، في ظل ما أبرزه من حقائق، وقدّمه من شواهد، وسلّط عليه من مفارقات، وأعطى صورة واضحة حول مؤشر مستقبل الأمراض غير المعدية ومخاطرها على الموارد البشرية الوطنية، فإن ما حمله من نتائج عبّرت عنها الإحصائيات ومؤشرات التقييم كفيلة بدق ناقوس الخطر، لتصبح الأمراض غير المعدية الموت البطيء القادم في عمان الذي فتك بحياة الكثيرين من أبناء هذا الوطن الغالي وبناته، خصوصا في ظل ما تشير إليه إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2018 بأن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن حوالي 72% من إجمالي الوفيات في السلطنة، وأن وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية بلغت ما نسبته 36% وشكلت المرتبة الأولى من بين الأمراض غير المعدية، ثم تلتها مجمل أمراض السرطان بما نسبته 11%. كما بلغت وفيات مرض السكري بنسبة 8%.؛ كما تبلغ نسبة المصابين به في السلطنة 15.7% من البالغين، ونسبة ارتفاع ضغط الدم 33.3%، وارتفاع الكولسترول 35.5% مع ارتفاع في نسبة استخدام التبغ 15%، واستهلاك الملح مع عدم كفاية النشاط البدني لدى 38.6 % من البالغين؛ وفي المقابل شكل زيادة الوزن والسمنة المفرطة، التي صنفت كأحد الأمراض المزمنة، تحولا خطيرا في صحة المواطن حيث تجاوزت نسبة السمنة 66%، وإن حوالي 25% من إجمالي الوفيات في مستشفيات السلطنة في عام 2016 كانت نتيجة أمراض القلب والشرايين التي تعد السمنة أحد أهم مسبباتها؛ كما ارتفعت نسبة المصابين بالسكري من العام 2008 وحتى 2018 أكثر من 3%، وهناك أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا، حيث يعتبر مرض السكري المسبب الأول للفشل الكلوي؛ وما أشارت إليه نتائج المسح من وجود مجموعة ما قبل السكري على وشك الإصابة به أو معرضة لارتفاع مستوى السكر في الدم إن لم تتدارك أمرها أو تجد العناية والاحتواء لها من قبل الجهات المعنية.وعليه تطرح مؤشرات الصحة العامة في مجتمع السلطنة، العديد من المعطيات والخيارات والبدائل واستراتيجيات العمل الوطنية القادمة التي يجب أن تعطى فرصة أكبر من الاهتمام والمتابعة والتشخيص والعلاج وتبني سياسات صحية أكثر نضجا واستدامة وفاعلية وتناغما مع خصوصية الإنسان العماني ومرتبطة بكل معطيات حياته اليومية وقادرة على تحقيق تناغم إيجابي وتوليد شعور ذاتي وقناعة ذاتية راسخة لدى المواطن بالقيمة المضافة الناتجة من التزامه هذه الموجهات أو تعاطيه مع الخطوات والإجراءات والمتطلبات، قادرة على تغيير قناعاته حول الصحة والمرض والغذاء والنشاط الرياضي البدني، وتقدم في الوقت نفسه محطات عمل تؤسس لشراكة وطنية في الإعلاء من فرص بناء العادات الصحية السليمة والسلوك الغذائي المتزن وأنماط الحياة الراقية القائمة على الوعي والتشخيص المبكر، فإن ما ارتبط بهذه الأمراض من مشكلات نفسية واجتماعية وصحية انعكس سلبا على أداء الفرد الحامل للمرض ونشاطه وقناعاته حول نفسه والمحيط الذي يعيشه وقدرته على مواصلة مشوار النجاح والتميز في حياته، والوساوس والمعكرات المزاجية التي أنتجت حالة من الخوف والقلق والاضطراب السلوكي والوعكات الصحية خصوصا في ظل الإشارة إلى دور هذه الأمراض كأحد مسببات الوفيات، كما ارتبط نشاطها أيضا ببعض العادات المجتمعية كالخمول وقلة النشاط البدني والممارسات الغذائية غير الصحية والعادات الغذائية العشوائية والاستهلاكية غير المقننة، إذ جميعها عوامل أدت إلى تزايد انتشار هذه الأمراض وتفاقم وضعية المصاب بها، لتمثل تهديدا لحياة الفرد، وتحديا سافرا لتنميته صحيا وجسميا ونفسيا وعقليا ومهنيا وانطلاقته لبناء مستقبله في ظل هاجس المرض الذي يراوده ويزرع فيه علامات والرهبة والخوف والقلق والألم والشعور بالوحدة وتراكم الأزمات النفسية التي تزيد من تأثيرات هذه الأمراض، فيرسخ في ذهنه قناعات سلبية وأفكارا تحمل في ذاتها الوهن والضعف وينتزع منه رغبة التقدم والتطور في حياته الشخصية والمهنية، وهو يشاهد بأُم عينيه من يعانون من هذه الأمراض يتساقطون أمامه فرادى وجماعات.من هنا تأتي أهمية توجيه المسار وإعادة إنتاج الواقع الصحي للمواطن، مستشرفا تغيير النظرة وتقنين الممارسة وتوجيه السلوك الغذائي وضبط كل الممارسات الأخرى التي تؤثر سلبا في سلامة المواطن، وتضعه أمام صورة مكبرة عن الواقع الصحي ذاته، في تعدد هذه الأمراض وأسبابها الدقيقة ومسبباتها العميقة وآليات التعاطي معها وأدوات الوقاية منها، وتقديم حزم صحية وقائية وعلاجية تضع المواطن أمام مسؤولية التغيير في عاداته وممارساته الصحية وأنماطه الغذائية، بحيث لا تقتصر المسألة الصحية على تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية والمحاضرات والندوات والزيارات والمتابعات، بل نقلها من حيز التنظير إلى الممارسة عبر إيجاد برامج عملية تؤسس لصحة المواطن، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك اليومي للغذاء أو في تأكيد نوعية الأغذية والوجبات والتوقيتات المناسبة لها، وأن تقوم المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في متابعة ذلك من خلال إحصائيات الغذاء والاستهلاك اليومي للمواطنين والوقوف على ذلك بصورة دورية، بالإضافة إلى توفير السياسات الصحية الضبطية الموجهة للقطاعات الأخرى غير الصحية ـ أي مؤسسات الإنتاج والتوريد للغذاء ـ بالشكل الذي يضعها أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية ووطنية لضمان قدرة هذه القطاعات المعنية بالاستهلاك والإنتاج الغذائي النباتي والحيواني وغيرها، التزام سياسات واضحة للحد من عوامل الخطورة المسببة لهذه الأمراض خصوصا تلك المتعلقة بإنتاج أو استهلاك واستيراد الأطعمة والمواد الغذائية المهدرجة أو غيرها كالزيوت والدهون والأملاح والسكر من جهة، أو تلك المنتجة للمواد الأخرى كالمشروبات الغازية والتبغ والتدخين وغيرها.ومع التأكيد على أن صناعة الفارق في إنتاج مفهوم الصحة الجسدية والنفسية والشخصية بعموميته في ثقافة المواطن منذ نعومة أظفاره، يستدعي تحولا يتناول مختلف المؤثرات المرتبطة بهذا المجال وقراءته في إطار منظومة عمل متكاملة، تبدأ بطريقة تدريس مفاهيم الصحة والتغذية والبناء السليم للجسد والنشاط البدني والرياضي، في مؤسسات التعليم ومناهجه وتتدرج معه بشكل يتناغم مع طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها، مع التعريج للأمراض التي تمثل خطرا على الفرد في هذه المراحل من واقع الإحصائيات والمؤشرات الصحية، لبناء سياج صحي قائم على وعي الفرد وفهمه وإدراكه لقيمة الصحة وأهمية التغذية السليمة والممكنات التي يمكن أن يستفيد منها في نهضة الوعي الصحي لديه، والفرص التي يستثمرها في سبيل وقايته من الأمراض المعدية، وفي الوقت نفسه طبيعة الدور المحوري للمؤسسة الصحية وقدرتها على تأطير فلسفة التشخيص الصحي والإقناع به وتوجيه الفرد إليه برغبة واستشعار لأهميته في تحديد الدورة الصحية التي يمر بها والظروف التي تزيد أو تقلل منها والموجهات التي يمكن من خلالها بناء مسار صحي قادر على تجاوز بعض المشكلات الصحية الناتجة عن العوامل البيولوجية الداخلية المرتبطة بانفعالات الفرد وسلوكه الاجتماعي والنفسي وحالة الضيق أو الغضب وسرعة الانفعال وثوران النفس والاندفاع، بما يؤسس لجهود أخرى تقوم بها مختلف المؤسسات الدينية والصحية والاجتماعية والأسرية والإعلامية في تعزيز مفاهيم الإيجابية وإدارة الذات وحكمة التصرف وإدارة المشاعر وتوليد فرص التصالح الذاتي وتعميق روح التناغم والانسجام والتعايش الفكري مع الذات والآخر، مستمدة في ذلك من نهج الإسلام ومبادئه السمحة التي تدعو إلى الحكمة وحسن التصرف وحس المسؤولية وكظم الغيض والترفع عن الاندفاع والامتناع عن الغضب المفضي إلى التهور الأدبي والضرر النفسي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تأتي أهمية تعزيز السياسات والتشريعات والقوانين الضبطية في عمليات الترويج للمواد الاستهلاكية والسلع الغذائية الموجهة للأطفال أو غيرهم من أفراد المجتمع، في التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية للحد من استخدام الغذاء غير السليم والتغذية غير الصحية، وما يحصل من حالات الغش والتدليس وتغيير تواريخ الصنع ومدد الصلاحية أو إضافة بعض المواد المسرطنة إلى المواد الغذائية، أو ما يتعلق منها بمراقبة عمليات إعداد الأطعمة وآليات الحفظ والتبريد والتزام شروط النظافة لدى القائمين على إعداد الوجبات الغذائية في المطاعم والمقاهي وإنتاج الألبان وأنواع الخبز وغيرها، وأماكن إعداد وبيع الوجبات السريعة والبيتزا والفطائر أو كذلك الحلويات وغيرها من الأنشطة التجارية المعنية بإنتاج وإعداد وبيع وترويج أو تسويق المواد الغذائية والأدوات المستخدمة فيها.على أن تحقيق هذا التحول في فقه المواطن وسلوكه الصحي والغذائي؛ مرتبط بوجود ممارسة أصيلة للفرد نابعة عن قناعة ذاتية وسلوك شخصي وإحساس فطري بقيمة الصحة، ومبادرة ذاتية تأخذ في الحسبان تراكمية الخبرات والمعلومات والأفكار والموجهات والمفاهيم التي طبعت على حياة الفرد وفقهه وسلوكه، سواء من المدرسة ومحاضن التربية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية أو مواقف الحياة اليومية والمشاهدات التي يعايشها الفرد في واقعه الاجتماعي؛ غير أن التفاؤل بقيمة هذه المعطيات في رسم ملامح التغيير وإدارة المسار الصحي والمساعدة في تغيير العادات الغذائية والصحية واكتساب الأفضل منها والإبقاء على الأجود والأنسب الذي يتناغم مع أعلى سقف المعايير الصحية للوصول إلى سلوك غذائي رشيد ونهج صحي سليم وممارسة صحية تتسم بالتوازن والايجابية والاعتدال والحفاظ على مستويات أعلى للياقة البدنية والجسدية؛ يستدعي جملة من الحزم التطويرية والممكنات الصحية والنفسية والغذائية التي يحتاج الفرد إلى أن يتقن آلياتها ويدرك ملامحها ويفهم معطياتها ويتدارك نفسه عند الشعور بعلاماتها فيبادر إلى إنقاذ نفسه، مما يعني أن يجد الفرد المواطن في سبيل الوصول إلى أبجديات الفعل والدخول في استراتيجيات العمل جهدا آخر يفوق ما يقوم به، ليجد فيه مساحة للتكيف معه والالتزام به، من هنا تأتي قيمة وأهمية الترويج للصحة العامة والتسويق لها في حياة المجتمع كقيمة مضافة تبرز مستوى التحضر والوعي والثقافة والمهنية والذوق التي وصل إليها المجتمع، وتعبر عن إرادة مواطنية وسعيهم إلى بناء مجتمع القوة: صحة في البدن وعافية في الجسد وسلامة في الفكر ورقيا في الوعي، فيمارسها بدافع ذاتي وشعور بأهمية أن يكون في مستوى من اللياقة البدنية والصحة النفسية والجسدية، فيمتنع عن تناول الغذاء غير الصحي أو الإفراط في تناول الأملاح والسكريات والدهون والحلويات والمشروبات الغازية والوجبات السريعة، وفي الوقت نفسه يبادر في ممارسة النشاط البدني ورياضة المشي وتقنين السلوك الغذائي لديه؛ لتبقى عمليات التوعية المستمرة المؤثرة إيجابا والقادرة على صناعة التغيير وإعادة هندسة العمليات الداخلية في حياة الفرد لتحقيق نواتج أكثر عملية على الأرض تظهر في وجود تغيير في سلوكه وقناعاته الغذائية والصحية، مدخل لنمو ثقافة الصحة لديه، وبروز هاجسها في نفسه، والتزام مساحات الأمان التي تحققها ليستفيد منها في يناء شخصية قوية جسميا وعقليا، تمتلك مناعة ذاتية في مقاومة المرض، وقناعة في أهمية الاستفادة من كل الفرص والموجهات والنصائح الطبية والإرشادات التي تؤسس لبناء ثقافة صحية متوازنة تنتقل من مجرد معلومات يرددها الفرد أو يتداولها؛ إلى ممارسة أصيلة وسلوك يومي يظهر في النمط الغذائي الذي يعتمده والممارسة الصحية التي ينتجها، والنشاط الرياضي الذي يمارسه لتصحيح مسارات التعاطي مع الأمراض والحد من مخاطرها على نفسه ومجتمعه، ودوره في مساعدة الآخرين للعيش في حياة صحية آمنة مطمئنة.ومع التأكيد على الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة بالسلطنة في هذا الشأن تبقي المسؤولية المشتركة بين مختلف القطاعات، وكفاءتها في توليد بدائل للحل، ومشاركة الجميع في تحمل المسؤولية وابتكار أدوات وآليات تعزز من إنتاج الصحة العامة في حياة المواطن، وتعزز من وجود الأنماط الغذائية الصحية عبر توفير فرص نمو هذه الثقافة وتعزيزها في أوساط المواطنين والمقيمين كتوفير بيئات صحية لممارسة رياضة المشي وتوفير الصالات الرياضية وتيسير تواجدها وانتشارها والتوسع فيها، وسن التشريعات والقوانين المعززة للصحة ومراقبة الأغذية الاستهلاكية ووضع الاشتراطات الداعمة لحماية المنتج الاستهلاكي من دخول أي مواد مسرطنة أو غيرها، بالإضافة إلى إيجاد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه إقلاق صحة المواطن عبر الغش في المواد الاستهلاكية وتغيير سنوات الإنتاج والصلاحية أو بيع مواد منتهية الصلاحية والترويج لها أو استخدام المطاعم لمنتجات ملوثة او منتهية الصلاحية أو عدم التزام هذه المنشآت بالمعايير الصحية والشروط ذات العلاقة بسلامة الغذاء وجودة الدواء؛ تعتبر الرهان في إحداث تحول في مسيرة الوعي الصحي للوصول إلى مجتمع عماني آمن في وطنه صحيح في جسده معافى في بدنه قوي في بنيته معتدل في غذائه، عندها لن يكون لهذه الأمراض أية حضور في قاموس مجتمع آمن بقيمة الصحة وأدرك أثرها في حياته وعزز حضورها في ممارساته وجعل منها خطا أحمر لبناء حياة الأمن والأمان والصحة والعافية، على أن تحقيق ذلك مرهون بجملة من الإجراءات وآليات العمل التي أشرنا إلى بعضها سلفا، وهي بحاجة إلى تشريعات وقوانين وأنظمة عمل واضحة ودقيقة تحفظ صحة المواطن وتؤسس فيه العادات الصحية السليمة وتبني فيه روح المسؤولية والتي يمكن مع ترقية أو رفع سقف برامج التوعية والتثقيف والإعلام وزيادة مسارات التحصين، أن تشكل مرحلة متقدمة في إنتاج مسار صحي يصنعه المواطن وينتج أدواته ويوفر بيئته في بيته ومؤسسته ومع أسرته ومجتمعه، فهل سنشهد في قادم الوقت جهودا أكثر عملية واستدامة وقوة وتأثيرا في الحد من حالة القلق والرعب التي ولدتها الأمراض غير المعدية والمزمنة في حياة العمانيين؟ وهل يتحول الخطر الصحي للأمراض غير المعدية إلى حراك وطني وخطة عمل واضحة المعالم مفهومة من قبل كل فئات المجتمع، متناغمة مع طبيعة هذه الأمراض والظروف التي يتعايش معها الفرد تتسم بتعددية القطاعات وتكامل الأدوات وتناغم الحلول وتفاعل المسارات، يضع حدا لكل الممارسات الغذائية غير الصحية ويؤسس لمرحلة جديدة في إعادة إنتاج الصحة العامة في حياة المواطن اليومية تقوم على احترام ثقافة النشاط البدني والرياضي وتقدير قيمة الصحة والغذاء السليم؟