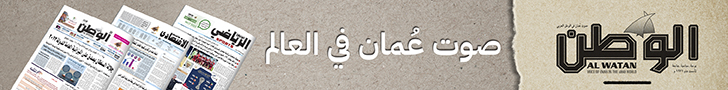في عصرنا المتداخل والمعقّد فإننا نحتاج إلى استحضار الآية الكريمة كثيراً وفي مواقف مختلفة، فالإنسان في العصر الحالي تحيط به كثيراً من الضغوط، فقد لا تغرب شمس يوم الواحد منا إلا وقد امتلأ ذهنه، وتكدّر خاطره بأمور كثيرة، ومنها ما يكون قد أخذه في خاطره على أخوانه وأصحابه، وهذا حال الكثير من الناس الذين يتأثرون بما قد يأتيهم من حديث من الآخرين ولو كان غير مقصود.فمن المواقف التي قد يتساهل فيها كثير من الناس هو الاسترسال في المزاح، وكم من مواقف مزاح انتهت أسوء نهاية، وكذلك كم من كلمة أُخِذت من سياقها فقادت إلى القطيعة والبغضاء بين الأصدقاء.والمواقف من ذلك كثير كل واحد منا الآن وهو يقرأ هذه الكلمات تمر في ذهنه العديد من المواقف في ذات المجال، فما حال من صار في ذلكم الموقف؟!.تكاد البشرية أجمعت على حسن هذا الخلق الإنساني الرفيع، ومثله بقية الأخلاق كالصدق والأمانة، والشجاعة والكرم .. وغيرها الكثير، وهذا الإجماع بسبب أن هذه الأخلاق ورد الحث عليها في الكتب السماوية، كما أن التجربة الإنسانية على مر العصور أثبتت جدواها ونجاعتها في التأصيل لمبدأ التعايش بين أجناس البشرية على هذه البسيطة، ولذلك أصبح خلق العفو من الأخلاق الفاضلة، وصار من يتحلى به محمود السيرة والأثر بين الناس،ولنا القدوة المثلى والمثل الأعلى فيمن كان حليما على العالمين أجمعين، نبينا محمد بن عبدالله (صلى عليه الله وسلم)، حيث جاء من طريق أبي هريرة روي أن أعرابياً جاء النبي (صلى عليه الله وسلم) يطلب شيئاً، فأعطاه ثم قال:أأحسنت إليك يا أعرابي؟ قال: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم (صلى عليه الله وسلم) أن كفواً، ثم قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئاً، ثم قال له: أأحسنت إليك؟ قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، فقال له النبي (عليه الصلاة والسلام): إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد جاء فقال النبي (صلى عليه الله وسلم)، إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك يا أعرابي؟. قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، أما التعليق تعليق النبي (عليه الصلاة والسلام) على هذه الحادثة، فقد قال (عليه الصلاة والسلام):(مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عنه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً، فقال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم بها، فتوجه لها بين يديها، فأخذ من قُمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها، وقال (عليه الصلاة والسلام): إني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار)، فنرى أن النبي (عليه الصلاة والسلام) عفى عن هذا الرجل في وقت أغلظ فيه الكلام علىى النبي (عليه الصلاة والسلام) أمام أصحابه وفي مجلسه معهم، فما كان من رسول الرحمة إلا أن يرسل له من العطاء ما يسترضيه به حتى يرضى، وما أن رضى الأعرابي لم يرض النبي (عليه الصلاة والسلام) أن يترك الأعرابي في حاله ذلك، بل أراد أن يزيل ما قد يكون حاك في صدور الصحابة ضد ذلكم الأعرابي، والهدف الأعلى والأسمى من ذلك هو أن الصحابة لو قتلوا ذلكم الأعرابي لكان في النار، ولكنه (عليه الصلاة والسلام) منعهم من ذلك، فهنا العفو في أسمى منازله وهو العفو عند المقدرة.ومن هنا وجب علينا أن نسعى جاهدين في تطبيق هذا المبدأ في حياتنا، وليست هي مجرد كلمات نحفظها، أو مبادئ نرددها، الحق أن نسعى لتطبيقها على واقع حياتنا العملية، وتكون نيتنا من ذلك التأسي بسيرة وأخلاق النبي الكريم ـ عليه من ربي أزكى صلاة وسلام ـ ولنا في موقف آخر من مواقف الحبيب (عليه الصلاة السلام) عبرة وعظة في ذلك وهي ما حصل منه في فتح مكة، وإليكم القصة بتفصيلها: فها هو النبي الكريم يدخل مكة فاتحاً بعدما أخرجته منه وحيدا مع صاحبه طريداً، فها هو يدخل مكة التي بذلت في قتله الشيء الكثير، وجعلت دمه مسفوحا بل ووعدت من يفعل ذلك بالجوائز العظام، إنها هي مكة التي أخرجته، مكة التي عذبت أصحابه، مكة التي شردت أصحابه والجأتهم للهجرتين نحو الحبشة، كي يكونوا لاجئين، نعم هي نفسها وهم نفسهم من حزبوا الأحزاب لواقعة الخندق، هم أنفسهم من آذوا النبي الكريم في بدنه، ولم يرضوا بأن يرجع لداره بعد رجوعه من الطائف، وكم نعدد من الأذى الذي ألحقوه به وبأهله وأصحابه، ها هو يدخل عليهم ظافرا برقابهم، وهم قد القوا السلاح، ومدوا أعناقهم ليحكم فيهم ما يرى، إنهم في قبضته وتحت أمره، بل إن حياتهم جميعاً تحت أمر يخرج من عنده، وعدد جنده عشرة آلاف بإشارة واحدة يأتمرون بأمره.لقد دخلها (عليه الصلاة والسلام) يوم الفتح ـ فتح مكة ـ دخول المتواضعين، معترفا بعظم الفضل، ولم يدخلها دخول المتكبرين المتجبرين ثملاً بنشوة النصر، لقد سار النبي (عليه الصلاة والسلام) في موكب النصر يوم فتح مكة حانياً رأسه حتى تعذر على الناس رؤية وجهه، وحتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، مردداً بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر المبللة بالدموع.سأل أعداءه بعد أن استقر به المقام: يا معشر قريش، ويا أهل مكة فاشرأبت إليه الأعناق، وزاغت الأبصار، سألهم ما تظنون أني فاعل بك؟ وصاحت الجموع الوجلة بكلمة واحدة، كأنما كانوا على اتفاق في ترديدها، قالوا: خيراً، أخٌ كريم وابن أخٌ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.أي عفوا أوسع من هذا؟! هل حوى رحم التاريخ من قام بهذا الفعل متناسيا كل ما كان منهم من أذى على مختلف الأصعدة، الأذى البدني والنفسي، الإتهام بأبشع التهم الجنون السحر الكذب .. إلخ، التضييق الكبير عليه وعلى أصحابه، ودعوته التي يكافح من أجلها، من أجل توصيل رسالة ربه للعالمين، للناس أجمعين، فنجد أن الصلبين والمغول والتتر وغيرهم قد ارتكبوا مجازر عظيمة في حق الشعوب التي انتصروا عليها، فبسببهم تلونت مياه الأنهار بالدم وغلب عليها اللون الأحمر، بدلا من صفاء لون الماء ونقاوته.ورجوعاً إلى زماننا الحاضر فكيف لنا أن نجعل مبدأ العفوا واقعاً معاشاً في حياتنا اليومية: فأنت في زحام المرور، وفي شدة الحر قد يخطئ عليك أحدهم، أو يأخذ غير مجاله، فهنا يتجلى العفو، بأن تعفوا وتجعلها لله، وقد يصل إليك كلام من أحدهم ينقل لك قولا قيل فيك من شخص آخر، فلا تتعب نفسك، وتكدر خاطرك، وتضيع عليك يومك، بل خذ بالفعو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتتهم بالباطل، ويلقى عليك اللوم، وقد يتقصدك أحدهم بذلك بسوء، ثم يأذن الله تعالى ببراءتك، وتبين الحقيقة، وتكون أنت في موقف القوي بعد أن كنت في موقف الضعيف المستهدف، فهنا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، تسمع وترى من احدهم يأتيك بوجه وخلفك يكون بوجه آخر، ويطلعك الله على حقيقة أمره، فبدلا من أن تنتقم لنفسك، استحضر: من كظم غيظه، وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً.. وغيرها الكثير من المواقف التي ينبغي على الواحد منا أن يستحضر العفو، وكيف يمكنك أن تجعلها لله، بدلا من أن تكسر ما بينك ويبن أخيك الإنسان من ود وألفة. مصطفى بن ناصر الناعبي