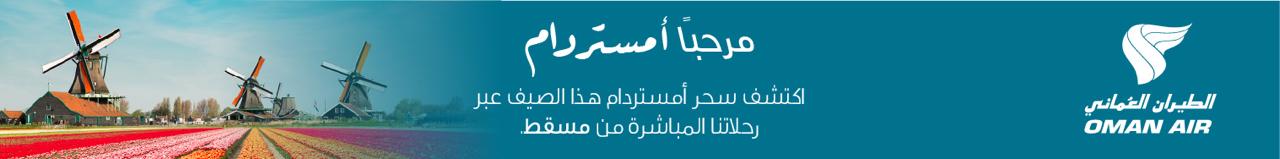بتاريخ 11 يناير 2018م، طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة، بمرسومٍ سُلطانيٍّ سَامٍ، رقم:(7 /2018)، بإصدارِ قانونٍ مُستحدَثٍ وجديد، أطلق عليه المشرِّع (قانون الجزاء) وقضى المرسوم في مادته الثانية بإلغاء قانون الجزاء العُماني (القديم) رقم:(7 /1974) وإلغاء كلّ ما يخالف أحكامه، أو يتعارض معه. هذا، وبالنظر إلى أن القانون الماثل أكَّدَ صراحةً، في المادة (5) منه، على مبدأ عدم الاعتداد بعذر الجهل بالقانون، فإن (المجتمع والقانون)، وتنفيذًا لرسالتِها التوعويَّة، أخذت على عاتقِها مسئولية تبصير العامة بأهم أحكام هذا القانون، لاسيَّما تلك التي وسَّعَ فيها المشرِّع من نطاق التجريم، أو لم تكُن أصلاً مجرَّمة. ونورد تاليًا الجزء العاشر من أهم تلك الومضات ..استعرضنا في حلقة الأسبوعِ المنصرم، الباب الحادي عشر من القانون، بشأنِ (الجرائم الواقعة على الأموال)، وتناولنا منه تحديدًا الفصل الأول فقط، الخاص بـ (السرقة وابتزاز الأموال)، المواد (335 – 348) وعليه، فإن الحلقة الماثلة، سنُخصِّصها لاستعراض جريمة الاحتيال، الواردة في الفصل الثاني، من الباب ذاته.ـ عالجت المادة (349) من القانون مفهوم الاحتيال، وذلك بأن نصَّت على الآتي:(يعاقب بالسَّجن مدَّة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) ريال عُماني، ولا تزيد على (300) ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصَلَ من الغيرِ على نفعٍ غيرِ مشروعٍ لنفسِه، أو للآخرين، باستعمالِه إحدى طُرق الاحتيال، أو باتخاذ اسمٍ كاذبٍ أو صفةٍ غير صحيحة وتشدَّد العقوبة، على ألا تتجاوز الضعف، إذا وقعَ الاحتيال على شخصٍ دون الثامنة عشرة من العُمر، أو على بالغٍ لا يملك كامِل قُواه المميّزة. ـ على غرار ما فعل المشرع في القانون الملغي، فلم يضع تعريفًا للطرق الاحتيالية، تاركًا ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء، اللذين استقرا بأنها كلّ كذبٍ مصحوب بوقائع خارجية، أو أفعال مادية، من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق الجاني، بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعيةً واختيارًا. ـ ولترجمة هذا المقال إلى واقعٍ عمليٍّ، يفهمُه العامة، غير المتخصِّصة، وهي الفئة المستهدفة من هذه الومضات، نقول أنه يحدث أحيانًا أن يتقدَّم آحاد الناس إلى الضبطية القضائية (الشرطة أو الادِّعاء العام) ببلاغٍ ضد آخر، مُتهمًا إيَّاه بالاحتيال عليه، موضحًا ذلك بالقول: أن الجاني أوهمه بأن لديه مشروع تجاريّ واعد؛ ورسم له صورة ورديَّة عن المشروع، الأمر الذي دفعه إلى تسليمه مبلغًا من المال، بعد أن صدَّق مقاله، ليتضح له لاحقًا أن المشروع وهميٌّ، لا أساس له من الواقع، وأنه وقعَ ضحية احتيال.يُفهم من الفرضيَّةِ المتقدِّمة، أن الجاني كذَبَ على المجني عليه بوجودِ مشروعٍ تجاريٍّ واعد، خلافًا للحقيقة، وأن المجني عليه صدَّق الجاني، دون أن يستعِن الأخير بأيِّ مظهرٍ خارجيٍّ، لتدعيم كذبته؛ وهو الأمر الذي يجعل جريمة الاحتيال غير مُتحقِّقةِ الأركان. مثال على ما تقدَّم: نفترض أن (أ) من الناس، الذي يعمل في الوساطة العقارية، عرض على (ب) قطعة أرض للبيع، وأطلعه على نسخة من الرسم المساحي للأرض، وربما نسخةً من الملكية أيضًا، بل وربما أوقفه على الأرض، لتحفيز المشتري على المضيّ قُدمًا إلى إبرام الصفقة، وطلب منه مبلغًا من المال لحجز القطعة، إيذانًا بمباشرة إجراءات المبايعة أمام المرجع المختص في وزارة الإسكان، فسلَّمه (ب) المبلغ المطلوب، بعد أن أبدى إعجابه بالقطعة. ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن نُسَخ الوثائق التي عرضها الجاني (الوسيط) على المجني عليه، لا ترقى إلى عدَّها مظهرًا من المظاهر الخارجية التي يجب أن يستخدمها الجاني لتدعيم مشروعه الإجرامي (كذبته)، لاستقامة جريمة الاحتيال، ويختلف الأمر حال قيام المتهم مثلاً بالتنسيق مع صديقٍ له، وهو صاحب مكتبٍ للخدمات العقارية، بأن يسمح له باستقبال ضحاياه في المكتب، فيتظاهر أمامهم أنه صاحب المكتب؛ أو على الأقل، يعمل فيه سمسارًا عقاريًا، فيدعم بذلك شوكة مشروعه الوهمي فتنطلي بذلك الكذبة على الرَّجل العادي. ويتحقَّق الاحتيال أيضًا من خلال استعانة الجاني بشخصٍ آخر لتأييد ادعاءاته الكاذبة أمام المجني عليه؛ سيَّما وإذا ما كان هذا الغير له صفةٍ خاصة، تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصدق الكذبة، كما لو كان الشخص مسؤولاً كبيرًا في الدولة، أو عالم دين، أو من العاملين في منظومة العدالة الجزائية، وما إلى ذلك من الوظائف العامة، وينبغي في هذه الحالة أن يكون الجاني هو من استعان بصاحب الصفة الخاصة هذه، أو بالغير بشكلٍ عام، لدعم مزاعمه الباطلة لا أن يكون الغير تدخَّل من تلقاء نفسه، أو بدافع الفضول، أو بمحض الصُّدفة. ومع ذلك، نؤكد هنا أن الكذب المجرد، غير المصحوب بمظهرٍ خارجيٍّ، وفق البيان المتقدِّم؛ وإن تعذَّرَ معه القول باستقامة جريمة الاحتيال إلا أنه لا يعني، بحالٍ من الأحوال، فقدان المجني عليه للحماية القانونية بالكُليَّة؛ إذ يبقى الطريق المدني مُتاحًا أمامه، لاقتضاءِ حقه، مع ملاحظة أن الاحتيال، في قانون الجزاء، يقابله (التغرير) في قانون المعاملات المدنية، وتحديدًا في المادة (103) منه، التي تنص على الآتي:(التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر، بوسائل احتيالية قولية أو فعلية، تحمله على إبرام عقد، لم يكن ليبرمه لولاها، ويعد تغريرًا، تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ إذا ثبت أن المغرور لو علم به ما كان ليبرم العقد)، وعليه فإذا كان المتفق عليه، فقهًا وقضاءً، يشير إلى أن الكتمان أو السُّكوت لا يقوم معه فعل الاحتيال الجزائي فإن تعمد السُّكوت لدفع الضحية إلى الدخول في صفقةٍ ما، يقوم معه فعل التغرير وتبقى بالتالي الحقوق المدنية محفوظة. ـ يلاحظ أن فصل الاحتيال في قانون الجزاء الملغي اشتمل على مادتين فقط؛ بينما القانون الماثل، وسَّع فيه المشرِّع من باب التجريم، ليشتمل على سبعِ مواد، وهي المواد (349 – 355). فإلى جانب المادة العامة المتقدِّمة، التي أوضح فيه المشرِّع ماهية الاحتيال وأركانه، جرَّم أيضًا كلُّ من تصرَّف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له، وليس له حق التصرُّف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه، أو التعاقد عليه؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، أوجد المشرع لهذه الأفعال عقوبةً رادعة، في المادة (350)، تصل إلى السَّجن لمدة (3) سنوات. ـ كما قرَّر المشرع العقوبة ذاتها، لكلِّ من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصَّل منه – إضرارًا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبَّت لدين أو مُخالصة، أو إلى إلغاء هذا السَّند أو إتلافه أو تعديله. وتصل عقوبة السَّجن حتى (5) سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة وليًا، أو وصيًّا، أو قَيِّمًا على المجني عليه؛ أو كان مُكلَّفًا بأيِّ صفةٍ برعاية مصالحه، أو كان من ذوي السُّلطة عليه.ـ وعلى غرار ما فعله المشرع في القانون الملغي، فلقد جرَّم كل من تناول طعامًا أو شرابًا، في محل معدّ لذلك؛ وكذلك، كل من شغل غرفة في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.ـ ترقبوا في الأسبوع القادم المزيد من الومضات في هذا القانون.