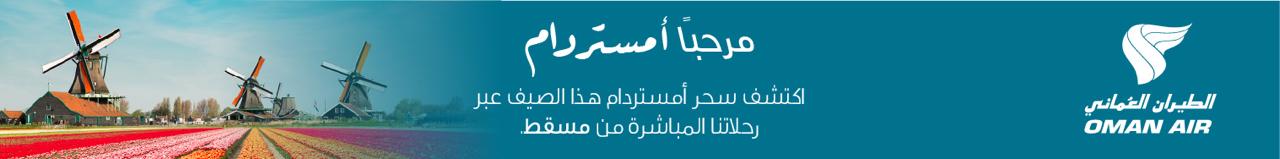في ظل المتغيرات العصرية التي يشهدها العالم عقب الحداثة، وما صاحبها من انهيار في الأسس والتقاليد الرصينة في الأدب والفن. فقد ازداد الجدل حول مفهوم الأصالة والمعاصرة في المسرح العربي .و كانت البدايات الأولى للدعوة لمسرح عربي أصيل مستوحى من التراث مع الكاتب المسرحي المصري (يوسف إدريس) ،والذي نادى بمسرح عربي أصيل شكلا ومضمونا، وأولى مسرحياته التراثية (الفرافير) . ثم جاء الكاتب توفيق الحكيم الذي سعى لتوظيف التراث الشعبي والحكواتي في المسرح. مع الحرص على تشرب مسرحه بعدد من القضايا والموضوعات المعاصرة آنذاك .كما كتب (سعد الله ونوس) من سوريا مسرحيته (الملك هو الملك) مناديًّا بتسييس المسرح التراثي ، وبالمثل ظهر في لبنان (روجيه عساف ) والذي عرف بمسرحة الحكواتي ، وفي المغرب ظهرت تجربة (الطيب الصديقي) التراثية في مسرحية (سيدي عبد الرحمن المجذوب)، كما كتب (عبد الكريم برشيد ) مسرحية (ابن الرومي في مدن الصفيح)... أما في الجزائر فقد كانت هناك دعوة لتأصيل المسرح العربي، المتمثلة في مسرحيات (علولة ) ومسرحيات (القوال، الأجواد، اللثام ). فيما طالب (عز الدين مدني) من تونس بترك النموذج الغربي ، والسعي نحو تأسيس مسرح عربي احتفالي.وهكذا يتضح بأن الدعوة لتأصيل مسرح عربي ليست وليدة الراهن، ولكنها ظلت هاجسًّا يقض مضجع المبدعين والمفكرين العرب، خصوصًا في ظل إشكالية التكوين للنهوض بمسرح عربي شكلا ومضمونَا . وعلى الرغم من مضي أكثر من نيف وقرن من الزمان على دخول المسرح إلى العالم العربي، إلا أنه لم يتأصل في بنية النسيج الاجتماعي للشعوب العربية، مثل (الشعر ، الموسيقى، القصة ..) ...وغيرها.ومن هنا انطلقت الكثير الفرضيات التي نظرت للتأصيل لمسرح عربي من خلال توظيف التراث الشعبي والرمز الأسطورة لإبداع رؤية بصرية معبرة ، مهما اختلفت أشكالها، وتنوعت موضوعاتها، شريطة أن تعكس تلك الموضوعات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية المعاصرة . وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه محمد عزام في كتابه : " سعدالله ...بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي" والذي رأى أهمية توظيف التراث في المسرح المعاصر، كونه يشكل جزءًا من الهوية، لذا فإن المبدع المسرحي يتوسل به لملامسة وجدانه. وفي عصر النهضة، ارتد الأدباء والمثقفون إلى التراث، بغية استكشاف موضوعاته.وفي ظل ثورة الاتصالات والفنون البصرية الأخرى (الفضائيات، السينما) تعالت نبرة المطالبة بتأصيل مسرح عربي، حيث أصبح المسرح مهددًا بالانحسار وبرغم تميز(المسرح) كفن حي، حيث ما بين الفن الرابع والفن السابع بون شاسع...ومن منطلق ذلك تتابعت الجهود لتوظيف المواد التراثية والتاريخية ، والتي بشرت بظهور المسرح الذي يطرح موضوعاته برؤية عامة تعبر عن نفسها عن طريق الرمز والاستعارة، بحيث تصبح الواقعة المحددة رمزًا. إضافة إلى ذلك، فإن المسرح الشعبي يعبر عن وجدان الناس في ماضيها وحاضرها، كما أنه يجمع الكثير من المجالات من نظم سياسية وموروثات اجتماعية وثقافية وأخلاقية، وتقاليد وعقائد وشعائر، وكل ما متأصل في اللاوعي الجمعي في شكل أساطير وحواديت ورموز وغيرها.وفي السلطنة تحظى الفنون الشعبية العمانية باهتمام الجهات الراعية للتراث والموروث الشعبي القصصي والموسيقي. وهناك الكثير من الأغاني والرقصات الشعبية الفلكلورية العمانية التي تشكل ظواهر شعبية، والتي يمكن تقديميا كفنون درامية، يمكن أن تعكس ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده ا الموروثة والمتناقلة عن الأجداد والتاريخ بما فيها من أحداث وملاحم بطولية.وجدير بالذكر أن الفنون التراثية تشكل فرجة شعبية معبرة عن الفرح والحزن وغيرها من المناسبات الاجتماعية الأخرى، ومن هذه الفنون الرزحة، والعازي والعيالة، والميدان، والمسبع، وفن الباكت - فن سمر وتسلية يؤديه الرجال، والذي يجمع بين الغناء الشعبي والأداء التمثيلي، حيث يعتبره البعض مسرحًا شعبيَّا متحركا- إلى جانب فن التغرود، والرزحة، والميدان، وكاسر، وهمبل...وغيرها من فنون البحر، والرعي ، والقنص.وهناك أكثر من طريقة يمكن أن يتبعها الكاتب المسرحي عند تعرضه للتراث الشعبي والتاريخي، أولها: المحافظة على القصة التراثية أو التاريخية كما هي، وثانيها إضافة أحداث وشخصيات من وحي خيال المؤلف. والمتابع للمصادر التراثية المروية المتوفرة، سيجد هناك اجتهادات من الباحثين لتدوين التراث القصصي الذي يرويه الأجداد وتتناقله الأجيال ، مثل : كتاب (البصراويان والعماني) لعيسى الشعيلي و كتاب (حكايات شعبية ظفارية) للدكتور محمد المهري وقصص (سيرة الحجر: حكايات قروية ) لزهران القاسمي وغيرها من الكتب القصصية التراثية.ولابد من الإشارة إلى أن مراحل توظيف التراث الشعبي في المسرح العربي المعاصر، أولها: مرحلة البحث عن مضمون تراثي للمسرح، وهذه المرحلة بدأت منذ نشأة المسرح العربي الحديث في منتصف القرن التاسع عشر وحتى يومنا فقد استلهمت موضوعاتها من التاريخ، والتراث الديني والوطني والأدبي والأسطوري والشعبي.وثانيها: مرحلة البحث عن (شكل) تراثي للمسرح. ولقد تأخرت عملية البحث عن (شكل) تراثي إلى مطلع الستينيات من القرن المنصرم، والتي تمثلت في الظواهر المسرحية التراثية التالية:( طقوس العبادة، والقصص والأخبار، والأسمار، ومجالس المنذرين..وفي مواكب الخلفاء ، والإسراء والمعراج ، والحكواتي، وخيال الظل).وثالثها : مرحلة التنظير لمسرح عربي جديد...والتي تمثلت في دعوة (السامر) الشعبي الذي اقترحه يوسف إدريس في مصر، وكذلك في مقدمة بيانات (المسرح الاحتفالي) في المغرب، كما تمثل ذلك في دعوة توفيق الحكيم إلى (قالبنا) المسرحي، وفي (بيانات لمسرح عربي جديد ) لمبدع المسرح السوري سعدالله ونوس .ختاما، لكل أمة إرثها الحضاري الذي تحرص على استغلاله وتوظيفه في الأعمال الفنية الإبداعية العصرية التي تخاطب وجدان الناس وتمتع أعين النظارة ..وهذا يجعلنا نتوقف عند تجربة المسرح العربي ، ونتساءل إلى أي مدى استطاع المشتغلين في المجالات الفنية استغلال الإرث الشعبي (المروي، المؤدى) والتاريخي، في رسم ملامحه ؟..والمتابع للمسرح العربي والخليجي بشكل عام سيجد أن هناك محاولات متباينة في موضوعاتها وأشكالها، وطرق استغلال الموروث الشعبي المروي. في حين هناك ضعف واضح في توظيف الأشكال التراثية باستثناء البعض منها ، وعادة تكتفي العروض المسرحية المقدمة في الاحتفاء بالتفاصيل المكانية التي من شأنها أن ترتبط بصلات وشيجة مع الحدث التراثي المروي أو الأغاني أو التاريخي.دونما شك، بأننا بحاجة إلى مزيد من الجهود في مجال البحث في الموروث الشعبي وكيفية توظيفه في الفنون البصرية . ..خاصة إذا علمنا بأنه ليست جميع مواد التراث الشعبي، يمكن معالجتها دراميا يمكن أن يعبر عن قضايا الشعوب العربية في ظل الانفتاح الثقافي ، وانهيار الكثير من الأنظمة السياسية وانتشار الفوضى في أكثر من قطر عربي حاليا . عزة القصابية