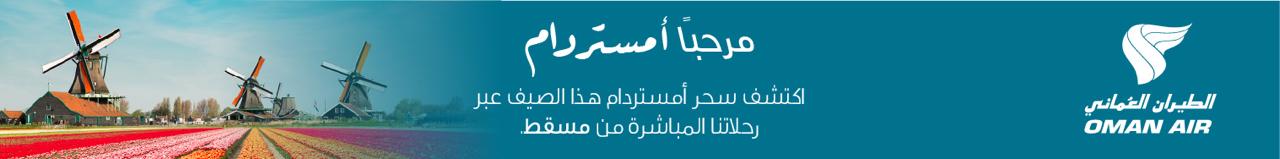Щ„Ш№Щ„Щ‘ Щ…ЩҶ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш§ ЩҠЩҸШ№ШЁЩ‘Шұ ШЁЩҮ Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠЩҲЩҶ Ш№ЩҶ Ш§Ш№ШӘШІШ§ШІЩҮЩ… Ш§Щ„ЩғШЁЩҠШұ ЩҲШӘЩ…ШіЩғЩҮЩ… ШЁШҜЩҠЩҶЩҮЩ…ШҢ ЩҲШӯШЁЩҮЩ… Ш§Щ„ШҙШҜЩҠШҜ Щ„Щ„ШұЩ‘ШіЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШЈЩҒШ¶Щ„ Ш§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШЈШӘЩ… Ш§Щ„ШӘШіЩ„ЩҠЩ…ШҢ Ш®Ш§ШұШ¬ ШҘШ·Ш§Шұ Ш§Щ„Ш№ШЁШ§ШҜШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ЩҒШұШ§ШҰШ¶ ЩҲШ§Щ„ШіЩҶЩҶ Ш§Щ„ЩҲШ§Ш¬ШЁШ©ШҢ ЩҮЩҲ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩ…Ш§ШұШіШ§ШӘ Ш§Щ„ШӯШіЩҶШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩӮЩҲЩ…ЩҲЩҶ ШЁЩ…Щ…Ш§ШұШіШӘЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Щ…ЩҲШ§ЩӮЩҒ ШӯЩҠШ§ШӘЩҮЩ… Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ©ШҢ ЩғЩ…Ш§ ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„ ЩҒЩҠ ШЈШҜШ§ШҰЩҮЩ… Щ„ШЁШ№Ш¶ ШЈЩҶЩ…Ш§Ш· Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩӮЩҲЩ… Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШөШӯЩҲШЁ ШЁШ§Щ„ШӯШұЩғШ© Ш§Щ„Ш¬ШіШҜЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Щ…Щ„ЩҠШЎ ШЁШ°ЩғШұ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш¬Щ„Щ‘ ЩҲШ№Щ„Ш§ШҢ Щ…Ш«Щ„ Щ…Ш§ ЩҠШӯШҜШ« ЩҒЩҠ ШЈШҜШ§ШҰЩҮЩ… Щ„ШЈЩҶЩ…Ш§Ш· : Ш§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜ ШЈЩҲ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ШЁШЈЩҶЩҲШ§Ш№ЩҮ: Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„ШҜЩҠШЁШ№ЩҠШҢ ЩҲЩғШ°Щ„Щғ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҠЩ…ЩҠЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШӘШіШЁЩҠШӯШҢ ЩҲШәЩҠШұЩҮШ§Шӣ ШӯЩҠШ« ЩҠШ¬ШҜЩҲЩҶ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈЩҶЩ…Ш§Ш· Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ© Щ…Ш¬Ш§Щ„Ш§ЩӢ ШұШӯШЁШ§ЩӢ Щ„Щ„ШӘШ№ШЁЩҠШұ Ш№Щ…Щ‘Ш§ ШӘШ¬ЩҠШҙ ШЁЩҮ ШөШҜЩҲШұЩҮЩ… Щ…ЩҶ ШөШ§ШҜЩӮ Ш§Щ„ШӯШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҮЩҸЩҠШ§Щ… Щ„Щ„Ш®Ш§Щ„ЩӮ Ш¬Щ„Щ‘ШӘ ЩӮШҜШұШӘЩҮ ШЈЩҲЩ‘Щ„Ш§ ЩҲЩӮШЁЩ„ ЩғЩ„ ШҙЩҠШЎШҢ ЩҲ Щ„ШұШіЩҲЩ„ЩҮ Ш§Щ„Ш№ШёЩҠЩ…ШҢ ШіЩҠШҜЩҶШ§ Щ…ШӯЩ…ШҜ ШЁЩҶ Ш№ШЁШҜШ§Щ„Щ„ЩҮ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…ШҢ Ш«Щ… Щ„ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШҜЩҠШ§Шұ Ш§Щ„Щ…ЩӮШҜШіШ© Ш§Щ„Ш·Ш§ЩҮШұШ©ШҢ ЩҲШ®Ш§ШөШ© ШЁЩҠШӘ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШӯШұШ§Щ… (Ш§Щ„ЩғШ№ШЁШ© Ш§Щ„Щ…ШҙШұЩҒШ©) ШЁЩ…ЩғШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШұЩ…Ш© ЩҲШ§Щ„Щ…ШіШ¬ШҜ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҲЩҠ Ш§Щ„ШҙШұЩҠЩҒ ШЁШ§Щ„Щ…ШҜЩҠЩҶШ© Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҲЩ‘ШұШ©. ЩҲЩ„Ш°Ш§ШҢ Щ„ЩҠШі Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҸШіШӘШәШұШЁ ШЈЩҶ ЩҶШіЩ…Ш№ ЩҒЩҠ ШЈШ«ЩҶШ§ШЎ ШЈШҜШ§ШЎ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈЩҶЩ…Ш§Ш· Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШұШҜЩҲШҜ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№ЩҠШ© ЩҒЩҠ Ш°ЩғШұ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„Щү ЩҲ ШӘЩҲШӯЩҠШҜЩҮ ЩҲШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш№Щ„Щү ЩҶШЁЩҠЩ‘ЩҮ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ….ЩҲШӘШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§Щ„ШҜШҢ ЩҲШ®Ш§ШөШ© ЩҒЩҠ Щ…Ш§Щ„ШҜ (Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©) Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҲШұЩӮШ©ШҢ ШЁШ§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШҙЩғШ§Щ„ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШӘШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ ШЈШҙЩғШ§Щ„ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШЁШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ Ш§Щ„ШЈШҜЩҲШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ЩҒШөЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…ШӘШӘШ§Щ„ЩҠШ© ЩҒЩҠ ЩғЩ„ Щ…ЩҶЩҮШ§ШҢ ЩҲШӘШЈШ®Ш° Ш·ШұШІШ§ЩӢ ЩҲШЈЩ„ЩҲШ§ЩҶШ§ЩӢ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒШ©ШҢ ЩҒЩҮЩҶШ§Щғ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ЩҒШұШҜЩҠ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШӘЩҲЩ„Щү ЩҒЩҠЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҶШҙШҜ Ш§Щ„ЩҒШұШҜ Ш§Щ„ШҜЩҲШұ Ш§Щ„ШЁШ§ШұШІ ЩҲШ§Щ„ШЈШіШ§Ші ЩҒЩҶШұШ§ЩҮ ЩҠШЁШҜШ№ ЩҒЩҠ ШӘЩҶШәЩҠЩ… ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„ШӘШұЩҶЩ… ШЁЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ШЈШҙШ№Ш§Шұ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ЩғЩҲШұШ§Щ„ЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№ЩҠ Ш§Щ„Щ…ШӘШҜШ§Ш®Щ„ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШӘЩ… ШЁШ§Щ„ШӘШЁШ§ШҜЩ„ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„Щ…ШӨШҜЩҠЩҶШҢ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…ШӘШҜШұЩ‘Ш¬ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШ№Ш©: ШЁШӯЩҠШ« ЩҠШЁШҜШЈ ШЁШ·ЩҠШҰШ§ЩӢ Ш«Щ… ЩҠШӘШҜШұЩ‘Ш¬ ЩҒЩҠ ШіШұШ№ШӘЩҮ Щ…ШӘЩҲШ§ШІЩҠШ§ЩӢ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ Щ„Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© ШӯШӘЩү ЩҠШөЩ„ ШҘЩ„Щү Ш°ШұЩҲШӘЩҮ Щ…Ш№ ШҜЩӮ Ш§Щ„ШіЩ‘ЩҗЩ…ЩҺШ§Ш№ЩҺШ§ШӘ (Ш§Щ„Ш·Ш§ШұШ§ШӘ ШЈЩҲ Ш§Щ„ШҜЩҒЩҲЩҒ).ЩҲ ЩҠШӘЩ… Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩҒЩҠ Щ…Ш§Щ„ШҜ (Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©) ШЁЩҶШөЩҲШөЩҚ Щ…Ш®ШӘШ§ШұШ©ЩҚ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШҢ Щ„ШЈШҙЩҮШұ ШҙШ№ШұШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒЩҠЩҶ ЩҒЩҠ Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ЩҲШ§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ Ш§ШҙШӘЩҮШұЩҲШ§ ШЁШ№ШҙЩӮЩҮЩ… ЩҲЩҮЩҸЩҠШ§Щ…ЩҮЩ… Ш§Щ„ШҙШҜЩҠШҜ Щ„Щ„Ш®Ш§Щ„ЩӮ Ш¬Щ„Щ‘ ЩҲШ№Щ„Ш§ШҢ ЩҲШЁШӘШ¶ШұЩ‘Ш№Ш§ШӘЩҮЩ… ЩҲШ§ШЁШӘЩҮШ§Щ„Ш§ШӘЩҮЩ… Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҲШЁЩ…ШҜШӯ ЩҲШӯШЁ Ш§Щ„ШұШіЩҲЩ„ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… ЩҲШ§Щ„ШӘШәШІЩ‘Щ„ ШЁЩ…ЩҶШ§ЩӮШЁЩҮ ЩҲШЁШөЩҒШ§ШӘЩҮШҢ ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠЩҸШ№ШұЩҒ ШЁШҙШ№Шұ (Ш§Щ„Щ…ШҜЩҠШӯ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҲЩҠ ШЈЩҲ Ш§Щ„ЩӮШөШ§ШҰШҜ Ш§Щ„Щ…ШӯЩ…Щ‘ШҜЩҠЩ‘Ш©)ШҢ ЩҲЩҮЩҠ Ш№ШЁШ§ШұШ© Ш№ЩҶ ЩӮШөШ§ШҰШҜ Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш© ШӘЩҸШ№ШұЩҒ ШЁШ§ШіЩ… (Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШёЩҠЩ…) ЩҲЩҮЩҲ Ш§Щ„Ш§ШіЩ… Ш§Щ„ШЈЩғШ«Шұ ШҙЩҠЩҲШ№Ш§ЩӢ ЩҲШӘШҜШ§ЩҲЩ„Ш§ЩӢ ШЁЩҠЩҶЩҮЩ… ШҢ ЩҒЩҠЩӮШ§Щ„: ЩҮШ°ЩҮ Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠ ШЈЩҲ Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶ ШЈЩҲ Ш§Щ„Ш¬ЩҠЩ„Ш§ЩҶЩҠШҢ ЩҲШәЩҠШұЩҮЩ….Щ…ЩҺШ§Щ„ЩҺШҜЩҸ (Ш§Щ„Щ’ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…ЩҺШ©)ШӘШ№ШұЩҠЩҒ:Щ…Ш§Щ„ШҜ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш© ШЈЩҲ "Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ" ЩғЩ…Ш§ ЩҠЩҸШ·Щ„ЩӮЩҲЩҶ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШӘЩ…ЩҠЩҠШІШ§ЩӢ Щ„ЩҮ Ш№ЩҶ ШЁЩӮЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩҶЩҲШ§Ш№ Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩү ЩғШ§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ ЩҲШ§Щ„ШЁШӯШұШ§ЩҶЩҠ ЩҲШ§Щ„ШҜЩҠШЁШ№ЩҠШҢ ЩҮЩҲ ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҢ Щ…ЩҸЩҶШәЩ‘Щ…ЩҢ Щ„Щ„ЩӮШөШ§ШҰШҜ ЩҲ ШЈШҙШ№Ш§Шұ Ш§Щ„ШӘЩ‘ШөЩҲЩ‘ЩҒ ЩҒЩҠ ШӯШЁ Ш§Щ„Ш°Щ‘Ш§ШӘ Ш§Щ„ШҘЩ„ЩҮЩҠЩ‘Ш© ЩҲЩҒЩҠ ШӯШЁЩ‘ Ш§Щ„ШұШіЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… ЩҲЩ…ШҜШӯЩҮ ЩҲШ§Щ„ШӘШәШІЩ‘Щ„ ШЁЩ…ЩҶШ§ЩӮШЁЩҮ ЩҲШіШ¬Ш§ЩҠШ§ЩҮ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… Ш§Щ„ШӘЩҠ ШЈЩ„Щ‘ЩҒЩҮШ§ ЩҲШЈШЁШҜШ№ЩҮШ§ ШЈШҙЩҮШұ ШҙШ№ШұШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒШӣ ЩҲЩҠЩ…ШӘШІШ¬ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШЁШЈШҜШ§ШЎ ШӯШұЩғЩҠ ЩҠЩҸШ№ШЁЩ‘Шұ ЩҒЩҠ Щ…Ш¶Щ…ЩҲЩҶЩҮ Ш№ЩҶ Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„ШӯШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҮЩҸЩҠШ§Щ…ШҢ ЩҲЩҮЩҲ ШҙЩғЩ„ЩҢ Щ…ЩҶ ШЈШҙЩғШ§Щ„ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘШҙШұШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҸЩ…Ш§ШұШіШ© Щ…ЩҶ ЩӮШЁЩ„ ЩҒШұЩӮ Ш§Щ„Щ…ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ШұЩҠШҜЩҠЩҶ ЩҒЩҠ ЩҶЩҲШ§Шӯ Щ…ШӘЩҒШұЩӮШ© Щ…ЩҶ ШЁЩ„ШҜШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ЩҲШ§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШҢ ЩҠЩҸЩ…Ш§ШұШіЩҲЩҶЩҮ ЩғЩ„ЩҢ ШӯШіШЁ Ш·ШұЩҠЩӮШӘЩҮ ЩҲШӘЩӮШ§Щ„ЩҠШҜ Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ЩҮШҢ ШәЩҠШұ ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҸШӨШҜЩҠЩҮ ЩҮЩҶШ§ ЩҒЩҠ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Ш§ ЩҠШӘЩ‘ШөЩҒ ШЈЩҒШұШ§ШҜЩҮШ§ ШЁШ§Щ„ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒ ЩҲЩ„Ш§ ЩҠЩҶШӘШіШЁЩҲЩҶ ШҘЩ„ЩҠЩҮЩ…ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶЩҮЩ… Щ…ЩҶ Ш№Ш§Щ…Ш© Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩҠШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІЩҲЩҶ ШЁШӯЩҒШё ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈШҙШ№Ш§Шұ ЩҲШ§Щ„ЩӮШөШ§ШҰШҜ ЩҲШЁШ§Щ„ШЁШұШ§Ш№Ш© ЩҒЩҠ ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҮШ§ Щ…Ш№ ШӯШіЩҶЩҚ ЩҲШ¬Щ…Ш§Щ„ЩҚ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШөЩҲШӘ ЩҲШҘЩ„Щ…Ш§Щ…ЩҚ ШӘШ§Щ…ЩҚ ШЁЩӮЩҲШ§Ш№ШҜ ЩҲШЈШөЩҲЩ„ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ…Ш·.ШҘЩҶЩ‘ Щ…ШөШ·Щ„Шӯ (Щ…ЩҺШ§Щ„ЩҖЩҺШҜ)ШҢ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ„ЩҮШ¬Ш© Ш§Щ„ШҜШ§ШұШ¬Ш© Щ„ШЁШ№Ш¶ ШЈЩҮЩ„ Щ…ШӯШ§ЩҒШёШ© Ш§Щ„ШЁШ§Ш·ЩҶШ© ЩҮЩҲ ШӘШөШӯЩҠЩҒ Щ„ЩғЩ„Щ…Ш© (Щ…ЩҺЩҲЩ’Щ„ЩҗШҜ)ШҢ ШЈЩҠ Щ…ЩҲШ¶Ш№ Ш§Щ„ЩҲЩ„Ш§ШҜШ© ЩҲЩҲЩӮШӘЩҮШ§ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠЩҸЩӮШ§Щ… ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ…Ш· ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШөЩ„ Ш§ШӯШӘЩҒШ§Щ„Ш§ЩӢ ШЁЩ…ЩҶШ§ШіШЁШ© Щ…ЩҲЩ„ШҜ Ш§Щ„ШұШіЩҲЩ„ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…ШҢ ЩҲЩ…ЩҶ ЩҮЩҶШ§ Ш¬Ш§ШЎШӘ ШӘШіЩ…ЩҠШӘЩҮ ШЁЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш§ШіЩ…. ЩҲ Щ…ШөШ·Щ„Шӯ (ЩҮЩҸЩҲЩҺШ§Щ…ЩҺШ©Щ’) ЩҠЩҸШ·Щ„ЩӮ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸШӨШҜЩҠЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҸШҙШ§ШұЩғЩҲЩҶ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШЈШ¬ШІШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…ЩғЩҲЩ‘ЩҶШ© Щ„ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ…Ш·ШҢ ЩҲЩҮЩҲ Щ…ШҙШӘЩӮЩҢ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҠШ§Щ…: ЩҮШ§Щ…ЩҺ ЩҠЩҮЩҠЩ…ЩҸ ЩҮЩҸЩҠШ§Щ…Ш§ЩӢ ЩҲ ЩҮЩҠЩ…Ш§ЩҶШ§ЩӢШҢ ЩҲЩҮЩҲ ШЈШ№Щ„Щү ШҜШұШ¬Ш§ШӘ Ш§Щ„ШӯШЁ ЩҲШ§Щ„Ш№ШҙЩӮШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ШҙШ§ШұЩғЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ (ЩҠЩҮЩҲЩ…ЩҲЩҶ)ШҢ ШЈЩҠ ЩҠЩҸШӨШҜЩҲЩҶ ШӯШұЩғШ§ШӘЩҮЩ… Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҮЩҠ ШӘШ№ШЁЩҠШұЩҢ ШөШ§ШҜЩӮ Ш№ЩҶ Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„Ш№ШҙЩӮ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ШӘЩғЩҶЩҮ Ш§Щ„ШөШҜЩҲШұ Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„Ш№Щ„ЩҠ Ш§Щ„ЩӮШҜЩҠШұ ЩҲЩ„ШұШіЩҲЩ„ЩҮ Ш§Щ„Щ…ШөШ·ЩҒЩү Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШЈЩҒШ¶Щ„ Ш§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШЈШӘЩ… Ш§Щ„ШӘШіЩ„ЩҠЩ….ЩҠЩҸЩӮШ§Щ… Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШІЩ„ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш¬Ш§Щ„Ші Ш§Щ„ЩҲШ§ШіШ№Ш© ЩҲШ§Щ„ШіШ§ШӯШ§ШӘ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ…Ш© ЩҲШәЩҠШұЩҮШ§ШҢ ЩҲЩҠЩҶШӘШҙШұ ШЈШҜШ§ШЎЩҮ ЩҒЩҠ ЩҲЩ„Ш§ЩҠШ§ШӘ Щ…ШӯШ§ЩҒШёШ© Ш§Щ„ШЁШ§Ш·ЩҶШ© (ШҙЩ…Ш§Щ„ЩҮШ§ ЩҲШ¬ЩҶЩҲШЁЩҮШ§) ЩҲЩҲЩ„Ш§ЩҠШ§ШӘ Щ…ЩҸШӯШ§ЩҒШёШ© Щ…ШіЩӮШ· ЩҲЩ…ЩҸШӯШ§ЩҒШёШ© Щ…ШіЩҶШҜЩ…ШҢ ЩҲЩҠЩҸЩ…Ш§Ш«Щ„ЩҮ ЩҒЩҠ Щ…ШӯШ§ЩҒШёШ© ШёЩҒШ§Шұ Ш§Щ„ЩҶЩ…Ш· Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒ ШЁШ§ШіЩ… (ШЈШӯЩ…ШҜ Ш§Щ„ЩғШЁЩҠШұ).ЩҲ ЩҠЩҸШӨШҜЩү Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҒЩҠ Щ…ЩҶШ§ШіШЁШ§ШӘЩҚ Ш№ШҜЩҠШҜШ©ШҢ ШҘШ° Щ„Ш§ ЩҠШұШӘШЁШ· ШЁЩ…ЩҶШ§ШіШЁШ© Ш§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҲЩҠ Ш§Щ„ШҙШұЩҠЩҒ ЩҒЩӮШ·ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶЩҮ ЩҠЩҸЩӮШ§Щ… ЩҒЩҠ Щ…ЩҸЩҶШ§ШіШЁШ§ШӘ Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ©ШҢ Щ…Ш«Щ„: Ш§Щ„ШЈШ№ШұШ§Ші ЩҲШ§Щ„Ш§ШӯШӘЩҒШ§Щ„ ШЁШ§Щ„Ш·ЩҮЩҲШұ ЩҲ ЩҲЩҒШ§ШЎ Ш§Щ„ЩҶШ°ЩҲШұ Ш§Щ„Щ…ШҙШұЩҲШ№Ш©ШҢ ШЈЩҲ Ш§Щ„Ш§ЩҶШӘЩӮШ§Щ„ ШҘЩ„Щү ШҜШ§ШұЩҚ Ш¬ШҜЩҠШҜШ©ЩҚ ЩҠШұЩҠШҜ ШЈЩҮЩ„ЩҮШ§ ШҘШ¶ЩҒШ§ШЎ Ш§Щ„ШЁШұЩғШ© ЩҲШ§Щ„ЩҠЩҸЩ…ЩҶ Ш№ЩҶШҜ ШіЩҸЩғЩҶШ§ЩҮШ§ ЩғЩ…Ш§ ЩҮЩҲ ШіШ§ШҰШҜ ЩҒЩҠ Щ…Ш№ШӘЩӮШҜЩҮЩ…ШҢ ШЁЩ„ ЩҲЩҒЩҠ Щ…Ш№ШёЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҶШ§ШіШЁШ§ШӘШҢ ШҜЩҠЩҶЩҠШ© ЩғШ§ЩҶШӘ ШЈЩҲ Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ©ШҢ ЩҒШЁЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш·ЩӮЩҲШі Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩҸЩ…Ш§ШұШіЩҲЩҶЩҮШ§ ШҘЩҶЩ…Ш§ ЩҠЩҸШӨЩғШҜЩҲЩҶ ШөЩ„ШӘЩҮЩ… ШЁШұШЁЩҮЩ… Ш®Ш§Щ„ЩӮЩҮЩ… ЩҲШұШ§ШІЩӮЩҮЩ… ЩҲ ЩҠШӘШЁШұЩ‘ЩғЩҲЩҶ ШЁЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҠШЎ ШЁШ§Щ„Ш°ЩғШұ Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…Щ„ЩҠШЎ ШЈЩҠШ¶Ш§ЩӢ ШЁШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш№Щ„Щү ШұШіЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… ЩҲШіЩҠШұШӘЩҮ Ш§Щ„Ш№Ш·ШұШ©.Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„Щ…ШӨШҜЩҠЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ:ШӘЩҸШіЩ…Щ‘Щү Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҸШӨШҜЩ‘ЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ (ШӯЩ„ЩӮШ©) ЩҲШӘШӘШЈЩ„ЩҒ Щ…ЩҶ:ЩҖ Ш§Щ„Ш®Щ„ЩҠЩҒШ©ШҢ ЩҮЩҲ ШұШҰЩҠШі Ш§Щ„ШӯЩ„ЩӮШ©ШҢ ЩҠЩӮШөШҜЩҮ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші Щ„ШҜШ№ЩҲШ© ШӯЩ„ЩӮШӘЩҮ Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШіШЁШ§ШӘШҢ ЩҲЩҮЩҲ ШұШ¬Щ„ Ш§Щ„ШӯЩ„ ЩҲШ§Щ„Ш№ЩӮШҜ ЩҒЩҠЩҮШ§ШҢ ЩҲШҘЩ„ЩҠЩҮ ШӘШӨЩҲЩ„ ЩғЩ„ Ш§Щ„ШЈЩ…ЩҲШұ Ш§Щ„Щ…ЩҸШӘШ№Щ„ЩӮШ© ШЁШ§Щ„ШӯЩ„ЩӮШ© ЩҲШЈШ№Ш¶Ш§ШҰЩҮШ§ШҢ ЩҲЩ„ЩҮ ЩҶШ§ШҰШЁ.ЩҖ ЩҶШ§ШҰШЁ Ш§Щ„Ш®Щ„ЩҠЩҒШ©ШҢ ЩҠЩҶЩҲШЁ Ш№ЩҶ Ш§Щ„Ш®Щ„ЩҠЩҒШ© ЩҒЩҠ ШәЩҠШ§ШЁЩҮ ШЈЩҲ Щ…ШұШ¶ЩҮШҢ ЩҲЩҠШӯЩ„ Щ…ЩғШ§ЩҶЩҮ ШЁШ№ШҜ ЩҲЩҒШ§ШӘЩҮШҢЩҖ Ш§Щ„ШҙЩ‘Ш§ЩҲЩҲШҙШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩӮЩҲЩ… ШЁШҘШЁЩ„Ш§Шә ШЈШ№Ш¶Ш§ШЎ Ш§Щ„ШӯЩ„ЩӮШ© ШЁЩ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШІЩ…Ш§ЩҶ ШҘЩӮШ§Щ…Ш© Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ ЩҲШӘЩҮЩҠШҰШ© ШЈШҜШ§Ш© Ш§Щ„ЩҶЩӮЩ„ ШҘШ°Ш§ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ШЁШ№ЩҠШҜШ§ЩӢ (ЩҒЩҠ ЩӮШұЩҠШ© ШәЩҠШұ ЩӮШұЩҠШӘЩҮЩ…)ШҢ ЩҲ ЩҠЩҸШҙШұЩҒ Ш№Щ„Щү ШӯШ¶ЩҲШұЩҮЩ…ШҢ ЩҲЩҠЩӮЩҲЩ… Ш№Щ„Щү Ш®ШҜЩ…ШӘЩҮЩ… ЩҒЩҠ ШӘЩҠШіЩҠШұ ЩғЩ„ Ш§Щ„ШЈЩ…ЩҲШұШҢ ШҘЩ„Щү ШәЩҠШұ Ш°Щ„Щғ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ№Щ…Ш§Щ„.* Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲЩ‘ЩҠЩ…ЩҺШ©ШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ ЩҠЩӮЩҲЩ…ЩҲЩҶ ШЁШ§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ ЩҲШ§Щ„Щ…ШҙШ§ШұЩғШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШұШҜЩҲШҜ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҠШ©.Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ:ЩҠЩҸШӨШҜЩ‘Щү Щ…Ш§Щ„ШҜ (Ш§Щ„ЩҮЩҲШ§Щ…Ш©) Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШөЩҒЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШұШ¬Ш§Щ„ ЩҠШ¬Щ„Ші ШЈШӯШҜЩҮЩ…Ш§ Щ…ЩӮШ§ШЁЩ„ Ш§Щ„ШўШ®ШұШҢ ЩҮЩ…Ш§: (ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ) ЩҲ (ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш©)ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠЩҸШӨШҜЩҠ ЩҮШ°Ш§ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШіЩ…Ш§ЩҶ ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ШҘЩҶШҙШ§ШҜШ§ЩӢ Щ…ЩҸШӘШЁШ§ШҜЩ„Ш§ЩӢ ЩҠЩҸШөШ§ШӯШЁЩҮ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ ШЈШ¬ШІШ§ШҰЩҮ ШЈШҜШ§ШЎЩҢ ШӯШұЩғЩҠЩҢ ЩҠШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІ ШЁЩҮ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ…Ш·.ЩҲ ЩҠЩҸЩӮШ§Щ… Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҒЩҠ ШЈШҜЩҲШ§ШұШҢ ЩҠШӘЩҶШ§ЩҲШЁ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҶШҙШҜЩҲЩҶ ЩҒЩҠ ШЈШҜШ§ШҰЩҮШ§ШҢ ЩҲЩҠЩҸШ·Щ„ЩӮЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШҜЩҲШұ Ш§Щ„ЩҲШ§ШӯШҜ Щ…ЩҶЩҮШ§ (ЩҒШөЩ„)ШҢ ЩҲШ°Щ„Щғ Щ„ШӘШӯЩӮЩҠЩӮ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШәШ§ЩҠШ§ШӘШҢ Щ…ЩҶЩҮШ§ Щ…Ш«Щ„Ш§: Щ„ЩғЩҠ Щ„Ш§ ЩҠШ¬ШҜ Щ…ЩҶ ЩҠЩӮЩҲЩ… ШЁШЈШҜШ§ШЎ ЩҒШөЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ Ш№ЩҶШ§ШЎЩӢ ЩҲЩ…ШҙЩӮШ©ЩӢ ЩҶШёШұШ§ЩӢ Щ„Ш·ЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩҒШӘШұШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШіШӘШәШұЩӮЩҮШ§ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎШҢ ЩҲЩ„ЩҠШіШӘШұЩҠШӯ Щ…ЩҶ ЩӮШ§Щ… ШЁШЈШҜШ§ШЎ ШҜЩҲШұ ШЈЩҲ ЩҒШөЩ„ШҢ ЩҲЩҠШӘЩҠШӯ Ш§Щ„ЩҒШұШөШ© Щ„ШўШ®ШұЩҠЩҶ Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ЩҒШөЩ„ ШўШ®ШұШҢ ЩҲШЈШ®ЩҠШұШ§ЩӢ Щ„ШҘШ«ШұШ§ШЎ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ШЁШ§Щ„Щ…Ш№Ш§ШұЩҒ ЩҲШ§Щ„Ш®ШЁШұШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШӘШ№ШҜЩ‘ШҜШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ШӘЩҒШ§ЩҲШӘШ© Щ„Щ„Щ…ЩҸШҙШ§ШұЩғЩҠЩҶ ЩҒЩҠЩҮШҢ ЩҲЩ…Ш«Щ„ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘШ¬ШұШ§ШЎШҢ ЩғЩ…Ш§ ЩҶШ№ШӘЩӮШҜШҢ ЩҠЩӮЩҲШҜ ШҘЩ„Щү ШӘЩҲШ§ШөЩ„ Щ…ЩҸШіШӘЩ…Шұ ЩҒЩҠ Ш§ЩғШӘШҙШ§ЩҒ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩҮШЁ Ш§Щ„Ш¬ШҜЩҠШҜШ©ШҢ ЩӮШҜ ШӘЩғЩҲЩҶ Щ…ЩҸШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІШ© ЩҒЩҠ ЩҒШҰШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨШҜЩҠЩҶ Щ„Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ ЩҲЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ ШӘЩғЩ…ЩҶ ШөЩҒШ© Ш§Щ„Ш§ШіШӘЩ…ШұШ§ШұЩҠШ© Щ„Щ„ЩҶЩ…Ш· ЩҲШЁШ§Щ„ШӘШ§Щ„ЩҠ ЩҠЩҸЩғШӘШЁ Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШЁЩӮШ§ШЎ ЩҒШӘШұШ© ШІЩ…ЩҶЩҠШ© ШЈШ·ЩҲЩ„ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШөШ№ЩҠШҜ Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ЩҠ.ШЈШ¬ШІШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ:Ш§Щ„ШҜЩҲШұ ШЈЩҲ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҠШӘЩғЩҲЩ‘ЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҜШ© Щ…ЩҶ ШЈШұШЁШ№Ш© ШЈШ¬ШІШ§ШЎШҢ ШӘЩҸШӨШҜЩү ШӯШіШЁ ШӘШұШӘЩҠШЁЩҮШ§ ЩҲШЈЩҲЩ„ЩҲЩҠШӘЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ШҢ ЩҲШӘЩ„ШӘШІЩ… Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© ШЁШЈШҜШ§ШҰЩҮШ§ ЩҒЩҠ Щ…ЩҸШ№ШёЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩӮШ№ ШҘЩ„Ш§ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„Ш§ШӘ ШәЩҠШұ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩ„ШІЩ…Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШ¬ШІШ§ШЎ ЩҮЩҠ: 1- Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© 2- Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© 3- Ш§Щ„ЩҮЩҲШ§Щ…Ш© 4- Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ.1- Ш§Щ„ШұЩ‘ЩҲШ§ЩҠШ©: ЩҶШөЩҢ ЩҶШ«ШұЩҠЩҢ ЩӮШөЩҠШұЩҢ ЩҲЩ…ШіШ¬ЩҲШ№ШҢ ЩҠШӘЩҶШ§ЩҲЩ„ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШҙЩҲШ§ЩҮШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩҶШЁЩҲЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ШҙШұЩҠЩҒШ© ШЈЩҲ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„Ш®ЩҲШ§ШұЩӮ ЩҲШ§Щ„ШәШұШ§ШҰШЁ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӯШҜШ«ШӘ ЩӮШЁЩ„ ЩҲШЈШ«ЩҶШ§ШЎ ЩҲ ШЁШ№ШҜ ЩҲЩ„Ш§ШҜШ© Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… ШЈЩҲ ШҙЩҲШ§ЩҮШҜ Щ…ЩҶ ШЁШ№Ш«ШӘЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҸШҙШұЩ‘ЩҒШ©ШҢ ЩҠЩӮШұШӨЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…ЩҶШҙШҜ ШЁШ№ШҜ ШЈЩҶ ЩҠШіШӘЩҒШӘШӯ ШЁШўЩҠШ§ШӘЩҚ Ш№Ш·ШұШ©ЩҚ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…ШҢ ЩҠЩҸЩҶШҙШҜЩҮШ§ Щ…ЩҶЩҒШұШҜШ§ЩӢ ЩҲ Щ…Ш¬ШІЩ‘ШЈШ©ЩӢ (ЩҒЩҠ ШЈШ¬ШІШ§ШЎ) Щ„ШӘШұШҜ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© ШЁЩҠЩҶ ЩғЩ„ Ш¬ШІШЎЩҚ ЩҲШўШ®Шұ Щ…ЩҶ ШЈШ¬ШІШ§ШҰЩҮШ§ ШЁШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ ШЁЩӮЩҲЩ„ЩҮЩ…: (ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…) ШЈЩҲ (Ш§Щ„Щ„ЩҮЩ… ШөЩ„Щ‘ ЩҲШіЩ„Щ… Ш№Щ„ЩҠЩҮ)ШҢ ЩҲШӘЩҸШӯЩҒШё ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ§ШӘ Щ…ЩҶ Щ…ШөШ§ШҜШұ Щ…ШӘШ№ШҜЩ‘ШҜШ©ШҢ Щ…Ш«Щ„: ЩғШӘШ§ШЁ (Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„Ш¬ЩҲШІЩҠ) ШЈЩҲ Щ…ЩҶ ЩғШӘШ§ШЁ (Щ…ЩҲЩ„ЩҲШҜЩҢ ШҙШұЩ‘ЩҒ Ш§Щ„ШЈЩҶШ§Щ…) Щ„Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ ЩҲ ШәЩҠШұЩҮЩ…Ш§ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШөШ§ШҜШұ Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩүШҢ ЩҲШӘШЁШҜШЈ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© ШЁЩӮЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҶШҙШҜ / Ш§Щ„ЩӮШ§ШұШҰ (ЩҲШіЩҖЩ„ЩҖЩ‘Щ…Щ’)ШҢ ЩҒЩҠШұШҜ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ЩҲШ§Щ„ШӯШ§Ш¶ШұЩҲЩҶ Щ…Ш№ЩҮЩ… ШЁЩӮЩҲЩ„ЩҮЩ…: Ш§Щ„Щ„ЩҮЩ…Щ‘ ШөЩ„Щ‘ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШӯШЁЩҠШЁ Щ…ЩҸШӯЩ…Щ‘ШҜШҢ ЩҲШ№Щ„Щү ШўЩ„ Щ…ШӯЩ…ШҜЩҚ ШөЩ„Щ‘ ЩҲШіЩ„ЩҖЩ‘Щ….ЩҮШ°ЩҮ ШұЩҲШ§ЩҠШ©ЩҢ Щ„ШЈЩ…Ш«Щ„Ш© Щ…Ш§ ЩҠЩҸЩӮШұШЈ Щ…ЩҶ ШұЩҲШ§ЩҠШ§ШӘ:"Ш§Щ„Щ„ЩҮ .. ЩҲШІШ§ШҜЩҮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… ШҙШұЩҒШ§ЩӢ ЩҲЩ…Ш¬ШҜШ§ЩӢ ЩҲЩғШұЩ…Ш§ЩӢ Ш№Ш§Щ„ЩҠ Щ„ШҜЩҠЩҮ ... Щ…Ш§ Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш№ЩҶШ§ ЩҮЩҮЩҶШ§ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ„ЩҠЩ„Ш© Ш§Щ„Щ…ЩҸШЁШ§ШұЩғШ© ШҘЩ„Ш§Щ‘ Щ„ЩҶЩҸШөЩ„ЩҠ ЩҲЩҶЩҸШіЩ„Щ… ЩҲЩҶЩҸШЁШ§ШұЩғ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ... ШұШЁЩ‘ЩғЩ… ШөЩ„Щү Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШЈЩ…ШұЩғЩ… ШЁШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш№Щ„ЩҠЩҮШҢ ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Щ„ШӘШіШ№ШҜЩҲШ§ ... ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Щ„ШӘЩҸШұШӯЩ…ЩҲШ§ШҢ ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Щ…ЩҶ ШёЩ„Щ‘ЩҖЩ„ШӘЩҮ Ш§Щ„ШәЩ…Ш§Щ…Ш© ... ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Щ…ЩҸШӘЩҲЩ‘Ш¬ ШЁШӘШ§Ш¬ Ш§Щ„ЩғШұШ§Щ…Ш© ... ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҖШЁШҙЩ‘ЩҺШұ ШЁШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ…Ш© ... ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Щ…ШЁШ№ЩҲШ« Щ…ЩҶ ШӘЩҗЩҮШ§Щ…Ш© ... ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҸЩ…ЩҸШҙЩҖЩҒЩ‘Ш№ ЩҒЩҠ Ш№ШұШөШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮЩҠШ§Щ…Ш©.Ш§Щ„Щ„ЩҮ .. ЩҲЩғШ§ЩҶ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… ЩҠШұЩү Щ…ЩҶ Ш®Щ„ЩҒЩҮ ЩғЩ…Ш§ ЩҠШұЩү Щ…ЩҶ ШЈЩ…Ш§Щ…ЩҮШҢ ЩҶЩҸШөШұЩҺ ШЁШ§Щ„ШұЩ‘ЩҸШ№ШЁ Щ…ЩҶ Щ…ШіЩҠШұШ© ШҙЩҮШұШҢ ЩҲЩӮШ§Щ„ ШЈЩҶШ§ ШіЩҠШҜ ЩҲЩ„ШҜ ШўШҜЩ… ЩҲЩ„Ш§ ЩҒШ®ШұШҢ Ш§Ш®ШӘШ§ШұЩҮ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ЩҲШ§ШөШ·ЩҒШ§ЩҮ ШұШЁЩ‘ЩҮ ... ЩҲЩғШ§ЩҶ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… ШӘЩҶШ§Щ… Ш№ЩҠЩҶШ§ЩҮ ЩҲЩ„Ш§ ЩҠЩҶШ§Щ… ЩӮЩ„ШЁЩҮШҢ ШЈШөШҜЩӮ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩӮЩҲЩ„Ш§ЩӢ ЩҲ Ш№ШІЩ…Ш§ ... ЩҲШЈШ№ШёЩ…ЩҮЩ… ШөЩҒШӯШ§ЩӢ ЩҲШ№ШҜЩ„Ш§ЩӢ ЩҲШӯЩ„Щ…Ш§ШҢ ЩғШұЩҠЩ… Ш§Щ„ШҙЩ…Ш§ШҰЩ„ШҢ Щ…Щ„ЩҠШӯ Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰЩ„ШҢ ЩҠЩҺШұЩү ШЁЩҶЩҲШұ Ш§Щ„ЩҮЩҸШҜЩү ШёЩҖЩҸЩ„ЩҖЩҺЩ… Ш§Щ„ШёЩ„Ш§Щ„Ш© ... ЩҲЩҮЩҲ Ш§Щ„Щ…Ш®ШөЩҲШө ШЁЩғЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Ш¶ШЁЩ‘ ЩҲШіЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„ШәШІШ§Щ„Ш©ШҢ Щ…ШӯЩ…Щ‘ШҜЩҢ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… ШЈШІЩғЩү ЩҲШЈЩҒШ¶Щ„ ЩҲШЈШӘЩ… Ш§Щ„ШіЩ„Ш§Щ…".2- Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш©: ЩҮЩҠ Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШҜШ©ШҢ ШӘШЈШӘЩҠ ШЁШ№ШҜ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© Щ…ЩҸШЁШ§ШҙШұШ©ШҢ ЩҲЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШёЩҠЩ… ШЈЩҲ Ш§Щ„ЩӮШөШ§ШҰШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜЩҠЩ‘Ш© ШӘШ№ШӘЩ…ШҜ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШҢ Щ„ШЈШҙЩҮШұ ШҙШ№ШұШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒЩҠЩҶ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ Ш§ШҙШӘЩҮШұЩҲШ§ ШЁШ№ШҙЩӮЩҮЩ… ЩҲЩҮЩҸЩҠШ§Щ…ЩҮЩ… Ш§Щ„ШҙШҜЩҠШҜ Щ„Щ„Ш®Ш§Щ„ЩӮ Ш¬Щ„Щ‘ ЩҲШ№Щ„Ш§ШҢ ЩҲШЁШӘШ¶ШұЩ‘Ш№Ш§ШӘЩҮЩ… ЩҲШ§ШЁШӘЩҮШ§Щ„Ш§ШӘЩҮЩ… Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҲШЁЩ…ШҜШӯ ЩҲШӯШЁ Ш§Щ„ШұШіЩҲЩ„ (ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…) ЩҲШ§Щ„ШӘШәШІЩ‘Щ„ ШЁЩ…ЩҶШ§ЩӮШЁЩҮ ЩҲШЁШөЩҒШ§ШӘЩҮ ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠЩҸШ№ШұЩҒ ШЁЩҖ "Ш§Щ„ЩӮШөШ§ШҰШҜ Ш§Щ„Щ…ШӯЩ…Щ‘ШҜЩҠЩ‘Ш©". ЩҲЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ШҙШ№ШұЩҠШ© ЩҒЩҠ ЩғЩ„ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШёЩҠЩ… Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШЁШҜШ№ЩҮШ§ ЩҮШӨЩ„Ш§ШЎ Ш§Щ„ШҙШ№ШұШ§ШЎ ЩҲЩҮЩ… ЩҒЩҠ ШӯШ§Щ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҮЩҠЩ…Ш§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¬ШұЩ‘ШҜ Щ…ЩҶ Щ…Ш§ШҜЩҠЩ‘Ш§ШӘ Ш§Щ„ШӯЩҠШ§Ш© Щ„Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШӘЩҒШіЩҠШұЩҮШ§ ШЈЩҲ ШҘШҜШұШ§ЩғЩҮШ§ ШҘЩ„Ш§ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Щ…Ш№ШұЩҒШ© ШҜЩӮЩҠЩӮЩҮ ШЁШ§Щ„Щ…Ш№ШӘЩӮШҜ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҸШӘШ№Щ…Щ‘ЩӮ.ЩҲШӘЩҸЩҶШҙШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШёЩҠЩ… ШЁШӘЩҶШәЩҠЩ… Щ…ЩҸЩ…ЩҠШІЩҚ Щ…ЩҲШұЩҲШ« ЩҠШ®ШӘЩ„ЩҒ ЩӮЩ„ЩҠЩ„Ш§ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩҶШәЩҠЩ… ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҠЩӮЩҲЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҶШҙШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҜШ© ШЁШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© ЩҒЩҠ Щ…ЩӮШ§Ш·Ш№ШҢ ЩғЩ„ Щ…ЩӮШ·Ш№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩҠШӘШЈЩ„ЩҒ Щ…ЩҶ ШЁЩҠШӘЩҠЩҶШҢ Щ„ШӘШұШҜ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШЁШ№ШҜЩҮЩ…Ш§ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ШЁШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ… Щ…ЩҶШәЩ‘Щ…Ш© ШЈЩҠШ¶Ш§ Щ…Ш№ ШӯШұЩғШ© Щ…ЩҶЩҮЩ… ШЁШ§Щ„Ш¬ШіЩ… ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШЈЩ…Ш§Щ…ШҢ Ш«Щ… ЩҠЩҸШӘШ§ШЁШ№ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҶШҙШҜ ШЁЩӮЩҠШ© ШЈШЁЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШҜШ© Ш№Щ„Щү Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„ЩҶШӯЩҲ ШӯШӘЩү ШӘЩҶШӘЩҮЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш©ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠЩҸЩҶШЁШҰ Ш№ЩҶ Ш§ЩҶШӘЩҮШ§ШҰЩҮШ§ ЩӮЩҲЩ„ЩҮ: "Шў Щ„Щ„ЩҮ Щ…ЩҖЩҲЩ„Ш§ЩҠ" ШЈЩҲ "ЩҶШЁЩҠЩ‘ЩғЩ… ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҮ".ЩҮШ°Ш§ ЩҶШө Щ„ШҘШӯШҜЩү ЩӮШөШ§ШҰШҜ Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶ Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ЩҶЩҲШұШҜЩҮ ЩғЩ…Ш«Ш§Щ„ Щ„Щ…Ш§ ЩҠЩҶШҙШҜЩҮ Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠЩҲЩҶ Щ…ЩҶ ШЈШҙШ№Ш§Шұ Ш§Щ„ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒ ЩҒЩҠ ЩҒШөЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ(1):ШІЩҗШҜЩ’ЩҶЩҠ ШЁЩҖЩҒЩҖШұШ· Ш§Щ„ШӯШЁ ЩҒЩҖЩҠЩҖЩғ ШӘШӯЩҠЩ‘ЩҖЩҸШұШ§ЩҲШҘШ°Ш§ ШіЩҖШЈЩ„ЩҖШӘЩҖЩҖЩғ ШЈЩҶ ШЈШұШ§Щғ ШӯЩҖЩӮЩҖЩҠЩҖЩӮЩҖШ©ЩӢЩҠШ§ ЩӮЩҖЩ„ШЁЩҸ ШЈЩҶШӘ ЩҲШ№ШҜ ШӘЩҖЩҶЩҠ ЩҒЩҠ ШӯШЁЩ‘ЩҮЩ…ШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШәЩҖШұШ§Щ… ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШӯЩҖЩҠЩҖШ§Ш©ЩҸ ЩҒЩҖЩ…ЩҸЩҖШӘ ШЁЩҖЩҮЩӮЩҖЩҸЩ„ Щ„Щ„ЩҖШ°ЩҠЩҖЩҶ ШӘЩҖЩӮЩҖШҜЩ‘Щ…ЩҲШ§ ЩӮЩҖШЁЩҖЩ„ЩҠ ЩҲЩ…ЩҺЩҖЩҶЩ’Ш№ЩҺЩҶЩ‘ЩҠ Ш®Ш°ЩҲШ§ЩҲШЁЩҗЩҠЩҺ Ш§ЩӮЩ’ШӘШҜЩҲШ§ЩҲЩ„ЩҠ Ш§ШіЩ…Ш№ЩҲШ§ЩҲЩ„ЩӮШҜ Ш®Щ„ЩҲШӘЩҸ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШӯШЁЩҖЩҠЩҖШЁ ЩҲШЁЩҖЩҠЩҖЩҶЩҶШ§ЩҲШЈШЁЩҖШ§Шӯ Ш·ЩҖШұЩ’ЩҒЩҠ ЩҶЩҖШёЩҖШұШ©ЩӢ ШЈЩ…Щ‘ЩҖЩҖЩ„Щ’ЩҖШӘЩҖЩҸЩҖЩҮШ§ЩҒЩҖШҜЩҸЩҮЩҗЩҖШҙЩҖШӘЩҸ ШЁЩҖЩҠЩҖЩҶ Ш¬ЩҖЩ…Ш§Щ„ЩҖЩҮ ЩҲШ¬ЩҖЩ„Ш§Щ„ЩҮЩҒШЈШҜЩҗШұЩ’ Щ„ЩҗШӯШ§ШёЩғ Ш№ЩҶ Щ…ШӯШ§ШіЩҶ ЩҲШ¬ЩҮЩҮЩ„ЩҲ ШЈЩҶЩ‘ ЩғЩ„Щ‘ Ш§Щ„ШӯЩҸШіЩҶ ЩҠЩҸЩғЩ…Щ„ ШөЩҲШұШ©ЩӢ ЩҲШ§ШұШӯЩ… ШӯШҙЩҖШ§ЩӢ ШЁЩ„ШёЩү ЩҮЩҲШ§Щғ ШӘЩҖШіШ№Щ‘ЩҖШұШ§ЩҒШ§ШіЩ…Шӯ ЩҲЩ„Ш§ ШӘШ¬Ш№Щ„ Ш¬ЩҲШ§ШЁЩҠ Щ„ЩҶ ШӘЩҖШұЩүШөШЁШұШ§ЩӢ ЩҒШӯШ§Ш°Шұ ШЈЩҶ ШӘШ¶ЩҠЩӮ ЩҲШӘШ¶Ш¬ШұШ§ШөШЁЩ‘ЩҖШ§ЩӢ ЩҒЩҖШӯЩҖЩӮЩҖЩғ ШЈЩҶ ШӘЩҖЩ…ЩҖЩҲШӘ ЩҲШӘЩҸЩҖШ№ЩҖШ°ШұШ§ШЁШ№ШҜЩҠ ЩҲЩ…ЩҺЩҶ ШЈШ¶ШӯЩү Щ„ШЈШҙШ¬Ш§ЩҶЩҠ ЩҠЩҺЩҖШұЩҺЩүЩҲШӘШӯЩҖШҜЩ‘ Ш«ЩҖЩҲШ§ ШЁЩҖШөШЁШ§ШЁЩҖШӘЩҠ ШЁЩҖЩҠЩҖЩҶ Ш§Щ„ЩҲШұЩүШіЩҖШұЩ‘ЩҢ ШЈШұЩӮЩ‘ЩҸ Щ…ЩҖЩҶ Ш§Щ„ЩҖЩҶЩҖШіЩҖЩҠЩҖЩ… ШҘШ°Ш§ ШіЩҖЩҖШұЩүЩҒШәЩҖШҜЩҲШӘЩҸ Щ…Ш№ЩҖШұЩҲЩҒЩҖШ§ЩӢ ЩҲЩғЩҖЩҶЩҖШӘЩҸ Щ…ЩҸЩҖЩҶЩҖЩғЩ‘ЩҖШұШ§ЩҲШәЩҖШҜШ§ Щ„ЩҖШіШ§ЩҶ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„ Ш№ЩҖЩҶЩ‘ЩҠ Щ…ЩҸЩҖШ®ЩҖШЁЩҖЩҗЩҖШұШ§ШӘЩҖЩ„ЩҖЩӮЩү Ш¬ЩҖЩ…ЩҖЩҠЩҖШ№ Ш§Щ„ШӯЩҸЩҖШіЩҶ ЩҒЩҠЩҮ Щ…ЩҸШөЩҲЩ‘ШұШ§ЩҲШұШўЩҮЩҸШҢ ЩғЩҖЩҖЩҖШ§ЩҶ Щ…ЩҸЩҖЩҮЩҖЩҖЩ„ЩҖЩ‘ЩҖЩҖЩ„Ш§ЩӢ ЩҲЩ…ЩҸЩҖЩғЩҖЩҖШЁЩ‘ЩҖЩҖЩҖШұШ§ЩҲЩ…ЩҶ ШЈШҙШ№Ш§ШұШ§Щ„ШҙЩҠШ® Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ШұШӯЩҠЩ… Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠШҢ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш© (45 ШЁЩҠШӘШ§)ШҢ ЩӮШ§Щ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠ Щ…ШҜШӯ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…(2):ЩӮЩҖЩҸЩ„ Щ„Щ„Щ…Ш·ЩҠ Ш§Щ„Щ„ЩҲШ§ШӘЩҠ Ш·Ш§Щ„ Щ…ШіШұШ§ЩҮЩҖШ§ Щ…ЩҗЩҖЩҶ ШЁШ№ЩҖШҜ ШӘЩҖЩӮЩҖШЁЩҖЩҠЩҖЩ„ ЩҠЩҸЩҖЩ…ЩҶЩҖШ§ЩҮШ§ ЩҲЩҠЩҸЩҖШіШұШ§ЩҮШ§Щ…Ш§ Ш¶ШұЩ‘ЩҮШ§ ЩҠЩҲЩ… Ш¬ШҜЩ‘ Ш§Щ„ШЁЩҠЩҶ Щ„ЩҲ ЩҲЩӮЩҒШӘ ЩҶЩӮЩҖЩҸШөЩ‘ЩҸ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯЩҠ ШҙЩғЩҖЩҲШ§ЩҶШ§ ЩҲШҙЩғЩҲШ§ЩҮШ§Щ„ЩҲ ШӯЩҸЩ…Щ‘Щ„ШӘ Щ…Ш§ ШӯЩ…Щ‘ЩҗЩ„ШӘЩҸ Щ…ЩҶ ШӯШұЩӮ Щ…Ш§ Ш§ШіШӘШ№Ш°ШЁШӘ Щ…Ш§ШЎЩҮШ§ Ш§Щ„ШөШ§ЩҒЩҠ ЩҲЩ…ШұШ№Ш§ЩҮШ§Щ„ЩғЩҶЩҮШ§ Ш№ЩҖЩ„Щ…ЩҖШӘ ЩҲШ¬ЩҖШҜЩҠ ЩҒЩҖШЈЩҲШ¬ЩҖШҜЩҮШ§ ШҙЩҲЩӮЩҠ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҙШ§Щ… ШЈШЁЩҖЩғЩҖШ§ЩҶЩҠ ЩҲШЈШЁЩҖЩғШ§ЩҮЩҖШ§Щ…Ш§ ЩҮШЁЩ‘ Щ…ЩҶ Ш¬ШЁЩ„ЩҠ ЩҶШ¬ШҜ ЩҶШіЩҠЩ… ШөШЁШ§ Ш§Щ„ЩҖШәЩҖЩҖЩҲШұ ШҘЩ„Ш§ ЩҲШЈШҙЩҖШ¬ЩҖШ§ЩҶЩҠ ЩҲШЈШҙШ¬ЩҖШ§ЩҮЩҖШ§ЩҲЩ„Ш§ ШіШұЩү Ш§Щ„ШЁШ§ШұЩӮ Ш§Щ„Щ…ЩғЩҠ Щ…ЩҸШЁШӘШіЩ…Ш§ЩӢ ШҘЩ„Ш§ ЩҲ ШЈШҙЩҖЩҮЩҖШұЩҶЩҠ ЩҲЩҮЩ’ЩҖЩҖЩҶЩҖШ§ЩӢ ЩҲШЈШіЩҖЩҖШұШ§ЩҮЩҖШ§ШӘЩҖШЁШ§ШҜШұШӘ Щ…ЩҶ ШұЩҸШЁЩҖШ§ ЩҶЩҖЩҠШ§ШЁЩҖШӘЩҠ ШЁЩҸЩҖШұЩҺШ№ ЩғЩҖШЈЩҶЩ‘ ШөЩҲШӘ ШұШіЩҖЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ЩҶЩҖЩҖШ§ШҜШ§ЩҮЩҖЩҖШ§ШӯШӘЩ‘Щү ШҘШ°Ш§ Щ…Ш§ ШұШЈШӘ ЩҶЩҲШұ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ ШұШЈШӘ Щ„Щ„ШҙЩ…Ші ЩҲШ§Щ„ЩҖШЁШҜШұ ШЈЩ…ЩҖШ«ЩҖШ§Щ„Ш§ЩӢ ЩҲШЈШҙЩҖШЁЩҖШ§ЩҮЩҖШ§ЩҲЩҮЩҠ ЩӮШөЩҠШҜШ©ЩҢ Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш©ШҢ ЩҠЩӮЩҲЩ„ ЩҒЩҠ ШўШ®ШұЩҮШ§ ЩҲЩҮЩҲ ЩҠШҜШ№ЩҲ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„Щү Щ„ШЈЩ…Щ‘Ш© ШіЩҠШҜ Ш§Щ„Ш®Щ„ЩӮ Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ…:ЩҲЩҮШЁ Щ„ЩҮШ§ Ш§Щ„ШЈЩ…ЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҜШ§ШұЩҠЩҶ ЩҲШ§ШұШ№ЩҺ Щ„ЩҮШ§ ШӯШіЩҶ Ш§Щ„ШёЩҶЩҲЩҶ Щ„ЩҖШҜЩҶЩҖЩҠЩҖШ§ЩҮШ§ ЩҲШЈШ®ШұШ§ЩҮЩҖШ§ЩҲШ§Ш¬Ш№Щ„ Щ„ШЈЩ…ШӘЩҖЩғ Ш§Щ„Ш®ЩҠШұШ§ШӘ Щ…ЩҸЩҶЩӮЩҖЩ„ШЁЩҖШ§ЩӢ ЩҠЩҖЩҲЩ… Ш§Щ„ЩӮЩҖЩҠЩҖШ§Щ…Ш© ЩҲШ§Щ„Ш¬ЩҶЩҖЩ‘Ш§ШӘ Щ…ЩҖШЈЩҲШ§ЩҮЩҖШ§ШөЩ„Щү Ш№Щ„ЩҠЩғ ШҘЩ„ЩҮЩҠ ЩҠЩҖШ§ Щ…ШӯЩ…ЩҖШҜЩҸ Щ…ЩҖШ§ ШҜШ§Щ…ШӘ ШҘЩ„ЩҠЩҖЩғ Ш§Щ„ЩҲШұЩү ШӘШӯШҜЩҲ Щ…Ш·Ш§ЩҠШ§ЩҮЩҖШ§ШӘШӯЩҠЩ‘ЩҖШ©ЩӢ ЩҠЩҶЩҖШҙЩү ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШўЩ„ Ш·ЩҖШ§Щ„Ш№ЩҮЩҖШ§ ШіШ№ШҜШ§ЩӢ ЩҲЩҠЩҒШ¶Шӯ ШұЩҠШӯ Ш§Щ„Щ…ШіЩғ ШұЩҠЩ‘ЩҖШ§ЩҮЩҖШ§ЩҲЩҮШ°Ш§ ЩҶШө Щ„Ш¬ШІШЎ Щ…ЩҶ Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш© (ШЈЩғШ«Шұ Щ…ЩҶ 70 ШЁЩҠШӘШ§ЩӢ) Щ„Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ШұШӯЩҠЩ… Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠШҢ Щ…Ш·Щ„Ш№ЩҮШ§: (Ш·ЩҠЩҒ Ш§Щ„Ш®ЩҠШ§Щ„ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶЩҠШ§ШЁШӘЩҠЩҶ ШіШұЩү)ШҢ ЩӮШ§Щ„ЩҮШ§ ШЁЩ…ЩғШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШұЩ…Ш©ШҢ ЩҠШ°ЩғШұ ЩҒЩҠЩҮШ§ Ш§ШЁШӘЩҮШ§Щ„Ш§ШӘЩҮ ЩҲШӘШ¶ШұШ№Ш§ШӘЩҮ ЩҲШ§ШіШӘШ№Ш·Ш§ЩҒШ§ШӘЩҮ Щ„ШұШЁЩҮ ЩҲЩҮЩҲ ЩҠЩӮЩҲЩ… ШЁШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Щ…ЩҶШ§ШіЩғ Ш§Щ„ШӯШ¬ Щ…Ш№ Ш¬Щ…ЩҲШ№ Ш§Щ„ШӯШ¬ЩҠШ¬ШҢ ЩҲЩҒЩҠЩҮШ§ ЩғШ°Щ„Щғ Ш§ШҙШӘЩҠШ§ЩӮ ШҘЩ„Щү ЩҲЩ„ШҜЩҠЩҮ ЩҶШёШұШ§ЩӢ Щ„Щ…ЩғЩҲШ«ЩҮ ЩҒШӘШұШ© Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш© ЩҒЩҠ Щ…ЩғШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШұЩ…Ш©. ЩҲЩҮЩҶШ§ ЩҠЩӮШӘШ·ЩҒ Ш§Щ„Щ…ЩҶШҙШҜЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ Ш§Щ„Ш¬ШІШЎ Ш§Щ„ШӘШ§Щ„ЩҠ Щ…ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш©(3):Щ„Ш§ ЩғШ§ЩҶШӘ Ш§Щ„ШұЩҠШӯ ШҘЩҶ ШӘЩҖЩҸШЁЩҖШҜЩҠ Щ„ЩҖЩҶШ§ Ш®ШЁЩҖШұШ§ЩӢ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӯШЁЩҖЩҠЩҖЩҶ ШЈЩҲ ШӘЩҖЩҸЩҮЩҖШҜЩҠ Щ„ЩҮЩ… Ш®ШЁЩҖШұШ§ШӯШіШЁЩҠ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҖШҜ ШЈЩҶЩҠ Щ…Ш§ Ш°ЩғШұШӘЩҮЩ…ЩҸ ШҘЩ„Ш§Щ‘ ШӘЩғЩҖЩҒЩғЩҒ Щ…Ш§ШЎ Ш§Щ„Ш№ЩҖЩҠЩҖЩҶ ЩҲШ§ЩҶЩҖЩ’ШӯЩҖШҜШұШ§ШұШӯЩ„ШӘЩҸ Ш№ЩҶЩҮЩ… ШәШҜШ§ШӘ Ш§Щ„ШЁЩҠЩҶ Щ…ЩҶ ШЁЩҸШұЩҺШ№ ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯШҙШ§ Щ„ЩҮШЁ Ш§Щ„ЩҶЩҠШұШ§ЩҶ Щ…ЩҸШіШӘШ№ЩҖШұШ§ЩҲШіШұШӘЩҸ ЩҲШ§Щ„ШҙЩҲЩӮ ЩҠШ·ЩҲЩҠЩҶЩҠ ЩҲЩҠЩҶШҙШұЩҶЩҠ Щ…ЩҖЩҲШөЩ„Ш§ЩӢ ШЁЩҖЩҮЩҖШ¬ЩҖЩҠЩҖШұЩҚ ШЁЩҖЩҖЩҠЩ‘ЩҖЩҖЩҶЩҚ ЩҲ ШіЩҸЩҖЩҖЩҖШұШ§ШӯШӘЩ‘Щү Ш§ЩҶШӘЩҮЩҠШӘ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Щ…ЩҠЩӮШ§ШӘ ЩҒЩҠ ШІЩҸЩ…ЩҺШұЩҚ Щ…ЩҶ ЩҲЩҒЩҖШҜ Щ…ЩғЩҖШ© ЩҠШ§ Ш·ЩҖЩҲШЁЩү Щ„ЩҮШ§ ШІЩҸЩ…ЩҺЩҖШұШ§Ш«Щ…Щ‘ Ш§ШәШӘШіЩ„ЩҶШ§ЩҲШЈШӯШұЩ…ЩҶШ§ ЩҲШіШ§Шұ ШЁЩҶШ§ ШӯШ§ШҜЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҺЩҖШ·ЩҗЩҠЩ‘ ЩҠШ®ЩҖЩҲШ¶ Ш§Щ„ЩҮЩҖЩҲЩ„ ЩҲШ§Щ„Ш®Ш·ШұШ§ЩҲЩ„Щ… ШЈШІЩ„ ШұШ§ЩҒШ№Ш§ЩӢ ШөЩҲШӘЩҠ ШЁЩҖШӘЩҖЩ„ЩҖШЁЩҖЩҠЩҖШӘЩҠ Щ…Ш№ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҖЩ„ЩҖШЁЩ‘ЩҖЩҠЩҖЩҶ Щ…Щ…Щ‘ЩҖЩҶ ШӯШ¬Щ‘ ЩҲШ§Ш№ЩҖШӘЩҖЩ…ШұШ§ШӯШӘЩ‘Щү ШЈЩҶШ§Ш®ЩҖШӘ Щ…Ш·Ш§ЩҠЩҖШ§ЩҶЩҖШ§ ШЁЩҖШ°ЩҠ ЩғЩҖШұЩ… ЩҲЩғЩҖЩ„Щ‘ ЩҲЩҒЩҖЩҖШҜЩҚ Щ„ЩҖЩҖШҜЩҠЩҖЩҖЩҮ ШІЩҸЩ„ЩҖЩҒЩҖШ©ЩӢ ЩҲ ЩӮЩҗЩҖЩҖЩҖШұШ§Ш·ЩҒЩҖЩҶШ§ Ш§Щ„ЩҖЩӮШҜЩҲЩ… ЩҲШөЩ„ЩҠЩҖЩҶШ§ Щ„ЩҶЩҖЩҸШҜШұЩғ Щ…ЩҖШ§ ШұЩҸЩ…ЩҶШ§ ЩҲШ¬ЩҗШҰЩҶШ§ ШЁЩҗШұЩҸЩғЩ’ЩҶ Ш§Щ„ШіШ№ЩҠ ШҘЩҶ ШҙЩғШұШ§Ш«ЩҖЩ…Щ‘ Ш§Ш·Щ…ШЈЩҶЩ‘ ШЁЩҖЩҶЩҖШ§ Ш§Щ„ЩҖШӘЩҖЩ‘Ш№ЩҖШұЩҠЩҖШ¬ ШЁШ№ЩҖШҜШҰЩҖШ°ЩҚ ЩҒЩҠ Щ…ЩҲЩӮЩҒЩҚ Ш¬Щ…Щ‘ЩҖШ№ Ш§Щ„ШіШ§ШҜШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ЩғЩҖЩҸШЁШұШ§ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҒЩҠЩҖШ¶ЩҠЩҶ Ш№ЩҸШҜЩҶШ§ ШӯЩҠЩҶ ШӘЩ…Щ‘ Щ„ЩҮЩ… ШұЩ…ЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Шұ ЩҲЩҮШ§Ш¬ Ш§Щ„ЩҖЩҶЩҒШұЩҸ ШЁШ§Щ„ЩҖЩҶЩҖЩ‘ЩҒШұШ§ШӯШ¬Щ‘ЩҖЩҲШ§ ЩҲШұШ§ШӯЩҲШ§ ЩҠШІЩҲШұЩҲЩҶ Ш§ШЁЩҶ ШўЩ…ЩҶШ©ЩҚ ЩҲШ№ШҜШӘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҒШұЩӮШ© Ш§Щ„Ш¬Ш§ЩҒЩҠЩҶ Щ…ЩҸШіШӘШ·ШұШ§3- Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©: ЩҲШӘШіЩ…Щү (Ш§Щ„ЩҒШөЩ„) ЩғШ°Щ„ЩғШҢ ШЈШ®Ш° Щ…ШөШ·Щ„Шӯ (ЩҮЩҲШ§Щ…Ш©) Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ Щ„Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ ЩғЩ…Ш§ ШЈШіЩ„ЩҒЩҶШ§ ШіШ§ШЁЩӮШ§ЩӢШҢ ЩҲШ®Ш§ШөШ© ШӯШұЩғШ© ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш©ШҢ Щ„ШЈЩҶЩҮЩ… ШЁШЈШҜШ§ШҰЩҮЩ… ЩҲШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҮЩ… Ш°Щ„ЩғШҢ ШҘЩҶЩ…Ш§ ЩҮЩ… ЩҠЩҮЩҠЩ…ЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш№ШҙЩӮ Щ…ЩҲЩ„Ш§ЩҮЩ… ЩҲШ®Ш§Щ„ЩӮЩҮЩ… Ш§Щ„Ш№ШёЩҠЩ… ЩҲЩҒЩҠ ШӯШЁ ШұШіЩҲЩ„ЩҮ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…ШҢ ШЈЩ…Щ‘Ш§ Щ…ШөШ·Щ„Шӯ (ЩҒШөЩ„) ЩҒЩҠШұШ¬Ш№ ШҘЩ„Щү ЩҶШө Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸЩҶШҙШҜ ШЈШ«ЩҶШ§ШЎ ШЈШҜШ§ШЎ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш¬ШІШЎ. ШӘШөЩ„ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈШЁЩҠШ§ШӘ ЩҒЩҠ Щ…ЩҸШ¬Щ…Щ„ЩҮШ§ ШҘЩ„Щү Ш«Щ„Ш§Ш«Ш© ШЈЩҲ Ш®Щ…ШіШ© ШЈШЁЩҠШ§ШӘ ЩҲЩӮШҜ ШӘЩғЩҲЩҶ ШЈЩғШ«ШұШҢ ШӯШіШЁ Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҸЩҶШ§ШіШЁШ©ШҢ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈШЁЩҠШ§ШӘ ШӘЩҸШіЩ…Щ‘Щү (ЩҒШөЩ„).ЩҒШ§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш© ШҘШ°Ш§ЩӢ ЩҮЩҠ ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҢ ШҙШ№ШұЩҠЩҢ Щ…ЩҶШәЩ‘Щ…ЩҢ Щ…ЩҸШӘШЁШ§ШҜЩҺЩ„ЩҢ ЩҲЩ…ЩҸШӘШҜШ§Ш®ЩҗЩ„ЩҢ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„Щ…ШӨШҜЩҠЩҶ Щ„Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ ЩҠЩ…ШӘШІШ¬ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШЁШЈШҜШ§ШЎЩҚ ШӯШұЩғЩҠ Щ…ЩҶ ЩӮШЁЩ„ ШөЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШҙШ§ШұЩғЩҠЩҶ (ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ…ЩҶШҙШҜЩҲЩҶ ЩҲ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш©)ШҢ ЩҲЩҠЩғЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҶШӯЩҲ Ш§Щ„ШӘШ§Щ„ЩҠ:ЩҠЩҸЩҶШҙШҜ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮЩҸШұЩ‘Ш§ШЎ ШЈЩҲЩ‘Щ„ ШЁЩҠШӘЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ ШҙШ№ШұШ§ЩӢ ЩҲЩҶШәЩ…Ш§ЩӢШҢ ЩҲ ШЁШ№ШҜЩҮЩ… ЩҠЩҸШұШҜЩ‘ШҜ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩҶЩҒШі Ш§Щ„ШЁЩҠШӘЩҠЩҶ ШЁШ°Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШәЩ… Щ…Ш№ ЩӮЩҠШ§Щ…ЩҮЩ… ШЁШ§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠШҢ ЩҲШ№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩҠШ№ЩҲШҜ Ш§Щ„ЩӮЩҸШұЩ‘Ш§ШЎ Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШЁЩҠШӘЩҠЩҶ Ш¬ШҜЩҠШҜЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш№Щ„Щү ЩҶЩҒШі Ш§Щ„ЩҶШәЩ…ШҢ ЩҠЩҸШұШҜЩ‘ШҜ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ (Щ„Ш§ ШҘЩ„ЩҮ ШҘЩ„Ш§ Ш§Щ„Щ„ЩҮ) ШЈЩҲ (Ш§Щ„Щ„ЩҮ ЩҠШ§ Ш§Щ„Щ„ЩҮ) ЩҒЩҠ ЩҶШәЩ… ЩҲШҘЩҠЩӮШ§Ш№ Щ…ЩҸШӘШҜШ§Ш®Щ„ЩҠЩҶ ЩҲ Щ…ЩҸШӘШ№Ш§ШұШ¶ЩҠЩҶ Щ…Ш№ ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎШҢ ШәЩҠШұ ШЈЩҶЩҮЩ…Ш§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҸШ¬Щ…Щ„ ЩҠЩҸШҙЩғЩ„Ш§ЩҶ ЩҶШіЩҠШ¬Ш§ Щ„ШӯЩҶЩҠШ§ЩӢ ЩҲШ§ШӯШҜШ§ Щ…ШӘЩғШ§Щ…Щ„Ш§ ЩҲЩ…ЩҸШӘШ¬Ш§ЩҶШіШ§ ЩҮЩҲ ЩҶШәЩ… Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ. ЩҲШӘШӘЩҲШ§ШөЩ„ ШЈШЁЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Щ…ЩҶ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮЩҸШұЩ‘Ш§ШЎШҢ ШЁЩҠЩҶЩ…Ш§ ЩҠЩҸЩғШұЩ‘Шұ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ШЁЩҠШӘЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ЩҠЩҠЩҶ Ш№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩҠЩғЩҲЩҶ ШҜЩҲШұЩҮЩ… ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜШҢ ЩҲЩҮЩғШ°Ш§.ЩҒЩҠ ШЈШ«ЩҶШ§ШЎ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎШҢ ЩҠЩҸЩ„Ш§ШӯШё ШЈЩҶ Ш¬Щ…ЩҠШ№ Щ…ЩҺЩҶ ЩҒЩҠ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ ЩҠЩӮЩҒЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү ШұЩҸЩғШЁЩҮЩ… ЩҲЩҠШӘЩ‘ЩғШҰЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү Ш№ШөЩҠЩ‘ЩҮЩ… ЩҲЩҠШӘЩ…Ш§ЩҠЩ„ЩҲЩҶ ШЁШЈШ¬ШіШ§Щ…ЩҮЩ… ЩҲШұШӨЩҲШіЩҮЩ… ЩҠЩ…ЩҠЩҶШ§ЩӢ ЩҲШҙЩ…Ш§Щ„Ш§ЩӢ ЩҲШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШЈЩ…Ш§Щ…ШҢ ЩҲ ЩҠШ¬Щ„ШіЩҲЩҶ ШЁШ№ШҜ ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩғЩ„Щ‘ ШЁЩҠШӘЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№Шұ. ШЈЩ…Щ‘Ш§ ШӯШұЩғШ© ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ЩҒЩҮЩҠ ШӯШұЩғШ©ЩҢ Щ…ЩҸШӘШҜШ§Ш®Щ„Ш© ЩҲЩ…ЩҸШӘШұШ§ШЁШ·Ш© ШЁШӘШұШ§ШЁЩҸШ· Ш§Щ„ШөЩҒ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸШҙЩғЩ‘Щ„ ЩҒЩҠ ШЈШҜШ§ШҰЩҮ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ ЩғШӘЩ„Ш© ШЁШҙШұЩҠШ© ЩҲШ§ШӯШҜШ© Щ…ЩҸШӘШұШ§ШөЩ‘Ш©ЩӢ ЩҲЩ…ШӘЩғШ§Щ…Щ„Ш© ЩҶШӘЩҠШ¬Ш© Щ„ЩҒ ЩғЩ„ ЩҲШ§ШӯШҜ Щ…ЩҶЩҮЩ… ЩҠШҜЩҮ Ш§Щ„ЩҠШіШұЩү Ш№Щ„Щү ШёЩҮШұ ЩҲШ®Ш§ШөШұШ© Щ…ЩҶ ЩҠШ¬Щ„Ші ШҘЩ„Щү ЩҠШіШ§ШұЩҮШҢ ЩҲШ§Щ„ШӯШұЩғШ© ЩҮЩҠ Ш®Щ„ЩҠШ· Щ…ЩҶ Ш№ШҜШҜЩҚ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӯШұЩғШ§ШӘШҢ ЩғШ§Щ„ШӘЩ…Ш§ЩҠЩ„ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ЩҠЩ…ЩҠЩҶ ЩҲШ§Щ„ЩҠШіШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…Ш§Щ… ЩҲШ§Щ„Ш®Щ„ЩҒ Ш«Щ… Ш§Щ„ШіШ¬ЩҲШҜ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ„ЩҲЩҠШӯ ШЁШ§Щ„ШЈЩҠШҜЩҠ ЩҲШ§Щ„Ш¶ШұШЁ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШұШ¶ ШЈЩҲ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШөШҜШұ ЩҲШ§Щ„ШӘШөЩҒЩҠЩӮШҢ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШӘЩҲШ§ЩҒЩҸЩӮ Ш§Щ„ШӘШ§Щ… ЩҲШ§Щ„ШӘШіЩ„ШіЩ„ Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҠ Щ„Ш¬Щ…ЩҠШ№ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШӯШұЩғШ§ШӘ.ЩҲШӘШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ Ш§Щ„ШЈЩҶШәШ§Щ… ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҒШөЩҲЩ„ ШЁШӘШ№ШҜЩ‘ЩҸШҜ Ш§Щ„ШЁШӯЩҲШұ ЩҲШ§Щ„ШЈЩҲШІШ§ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№ШұЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩҲШЁШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш§ЩғЩҶ ЩҲ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩӮШ№ Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩҸШӨШҜЩ‘Щү ЩҒЩҠЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜШҢ ЩғЩ…Ш§ ШӘШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ ШЈЩҠШ¶Ш§ЩӢ ШЈШҙЩғШ§Щ„ Ш§Щ„ШӯШұЩғШ© Ш§Щ„Щ…ЩҸШөШ§ШӯШЁШ© Щ„Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Щ…ЩҶ Щ…ЩҲЩӮШ№ЩҚ ШҘЩ„Щү ШўШ®Шұ ЩҲШ®Ш§ШөШ© ЩҒЩҠ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш©ШҢ ШӯЩҠШ« ШӘШӘЩғШҙЩ‘ЩҒ Щ„ЩҶШ§ Ш§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҒШұЩҲЩӮШ§ШӘ Ш§Щ„Ш¬ЩҲЩҮШұЩҠЩ‘Ш© ШӯЩҠЩҶЩ…Ш§ ЩҶЩҸЩ…Ш№ЩҶЩҸ Ш§Щ„ЩҶШёШұ ЩҒЩҠ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӯШұЩғШ§ШӘ.ЩҲЩҠЩҸШөШ§ШӯШЁ Ш¬ШІШЎ (Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©) ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩӮШ№ ЩӮШұШ№ Щ„Щ„ШҜЩҒЩҲЩҒ Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩҸШ·Щ„ЩӮЩҸ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ Ш§ШіЩ… (Ш§Щ„Ш·Ш§ШұШ§ШӘ) ШЈЩҲ (Ш§Щ„ШіЩ‘Щ…Ш§Ш№Ш§ШӘ)ШҢ ШӘЩҸШ¶ШұШЁ ШЁШ§Щ„ШЈЩғЩҒЩ‘ШҢ ЩҲЩҠШӘЩ…Щ‘ ШӘШіШ®ЩҠЩҶ ШұЩӮЩ…Ш§ШӘЩҮШ§ ШЁШӘШ№ШұЩҠШ¶ЩҮШ§ Щ„Щ„ЩҶШ§Шұ Щ…ЩҶ ШӯЩҠЩҶЩҚ Щ„ШўШ®ШұШҢ ЩҲЩҠШӘЩҒШ§ЩҲШӘ Ш§ШіШӘШ®ШҜШ§Щ…ЩҮШ§ Щ…ЩҶ Щ…ЩҲЩӮШ№ Щ„ШўШ®Шұ ШӯШіШЁ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҸШӘЩ‘ШЁШ№ ЩҒЩҠ ЩғЩ„ Щ…ЩҲЩӮШ№ШҢ ЩҒЩӮШҜ ШӘЩҸШіШӘШ®ШҜЩ… Щ…ЩҶ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш§ЩғЩҶ ЩҲЩӮШҜ ШӘЩҸШіШӘШ®ШҜЩ… ШЁШ№ШҜ ШҘШӘЩ…Ш§Щ… ЩҒШөЩ„ ШЈЩҲ ЩҒШөЩ„ЩҠЩҶ Щ…ЩҶ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎШҢ ЩҲЩӮШҜ Щ„Ш§ ШӘЩҸШіШӘШ®ШҜЩ… .ЩҲЩ…ЩҶ ШЈЩ…Ш«Щ„Ш© ШҙШ№Шұ (Ш§Щ„ЩҒШөЩ„) Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸЩҶШҙШҜ ЩҒЩҠ Ш¬ШІШЎ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲШ§Щ…Ш©ШҢ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…Ш«Ш§Щ„ Ш§Щ„Щ…ШЈШ®ЩҲШ° Щ…ЩҶ ЩғШӘШ§ШЁ (Ш§Щ„ШұЩ‘ЩҲШ¶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШҰЩӮ):ШөЩ„ЩҖЩҲШ§ Ш№ЩҖЩ„Щү Щ…ЩҖШ№ЩҖШҜЩҶ Ш§Щ„ШҘЩҠЩҖЩҖЩ…ЩҖШ§ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҸШөШ·ЩҒЩү Ш®ЩҠЩҖШұ Щ…ЩҺЩҶ Щ„ЩҖШЁЩ‘ЩҠЩ…Ш§ ШәШұЩ‘ШҜ Ш§Щ„Ш·ЩҠШұ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШәШөШ§ЩҶ ШЈЩҲ Щ…Ш§ ШӯЩҖШҜШ§ ШӯШ§ШҜЩҠ Ш§Щ„ЩҖШұЩ‘ЩғЩҖШЁЩҗЩ…ЩҖШ§ ШЁЩҖЩҖШ§Щ„ Ш¬ЩҖЩҠЩҖЩҖШұШ§ЩҶЩҖЩҖЩҶЩҖШ§ ШЁЩҖШ§Щ„ЩҖШЁЩҖЩҖШ§ЩҶ Щ…Ш§Щ„ЩҖЩҲШ§ Ш№ЩҖЩ„Щү Ш§Щ„ЩҖЩҲШҜ ЩҲШ§Щ„ШӯЩҖШЁЩ‘ЩҗШөЩҺЩҖЩҠЩ‘ЩҖШұЩҲШ§ ШӯЩҖШёЩҖЩ‘ЩҖЩҠЩҺ Ш§Щ„ЩҖЩҮЩҖШ¬ЩҖЩҖШұШ§ЩҶ Щ…ЩҖЩҶЩҮЩҖЩ… ЩҲЩ…Ш§ Ш«ЩҖЩҺЩҖЩ…Щ‘ Щ…ЩҶ Ш°ЩҶЩҖЩҖШЁЩҗШөШұШӘЩҸ Щ…ЩҖЩҶ ШЁЩҖШ№ЩҖШҜЩҮЩҖЩ… ЩҲЩ„ЩҖЩҮЩҖЩҖШ§ЩҶ Щ…ЩҸЩҖШӘЩҖЩҖЩҠЩ‘ЩҖЩ… Ш§Щ„Ш¬ЩҖШіЩҖЩ… ЩҲШ§Щ„ЩҖЩӮЩҖЩҖЩ„ЩҖШЁШӘШ¬ШұЩҠ ШҜЩ…ЩҲШ№ЩҠ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈЩҲШ¬ЩҖШ§ЩҶ ЩғЩҖШЈЩҶЩҖЩҮЩҖШ§ Щ…ЩҖШ§Ш·ЩҖШұ Ш§Щ„ЩҖШіЩҖШӯЩҖЩҖШЁЩҲЩҮШ°Ш§ Щ…Ш«Ш§Щ„ЩҢ Щ„ЩҒШөЩ„ ШўШ®Шұ:ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„Щү Ш®ЩҖЩҠЩҖШұ Ш§Щ„ШЈЩҶЩҖШ§Щ… Щ…ЩҖШӯЩҖЩҖЩ…Щ‘ЩҖШҜЩҚ Щ…ЩҖЩҶ Щ…ЩҖЩҸШ¶ЩҖШұЩ…ЩҖШ§ ЩҶЩҖШ§Шӯ ЩҲШұЩӮ Ш§Щ„ЩҖШӯЩҖЩҖЩ…ЩҖЩҖШ§Щ… Ш№Щ„Щү ШәЩҖШөЩҲЩҶ Ш§Щ„ШҙШ¬ШұЩҠЩҖЩҖЩҖШ§ Щ…ЩҺЩҖЩҖЩҶ ЩҮЩҺЩҖЩҖЩҖЩҖЩҲШ§ЩҮЩҸ ШЈЩӮЩҖЩҖЩҖЩҖШ§Щ… ЩҒЩҠ Щ…ЩҸЩҮШ¬ЩҖШӘЩҠ ЩҲШ§ШіШӘЩҖЩӮЩҖШұШ№ЩҖШ·ЩҒЩҖШ§ЩӢ Ш№ЩҖЩ„Щү Ш§Щ„ЩҖЩ…ЩҸЩҖШіШӘЩҖЩҮШ§Щ… ШЁЩҖЩғЩҖЩ… ШӯЩҖЩ„ЩҖЩҠЩҖЩҒ Ш§Щ„ШіЩҮЩҖШұШҜЩ…Ш№ЩҠ ЩғЩҖЩҒЩҖЩҠЩҖШ¶ Ш§Щ„ЩҖШәЩҖЩ…ЩҖШ§Щ… Щ…ЩҗЩҶ ЩҒЩӮЩҖШҜ ШЁШ§ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШәЩҖЩҸШұШұЩ…ЩҺЩҖЩҶЩ’ ЩҒЩҖЩҺЩҖШұЩ’Ш№ЩҸЩҖЩҖЩҮ ЩғЩҖШ§Щ„ЩҖШёЩҖЩҖЩ„Ш§Щ… ЩҲЩҲШ¬ЩҖЩҮЩҖЩҖЩҮ ЩғЩҖШ§Щ„ЩҖЩӮЩҖЩҖЩ…ЩҖЩҖШұ4- Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ: ЩҮЩҲ ЩғЩ…Ш§ ЩҠЩҸШіШӘШҜЩ„ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Щ…ЩҶ Ш§ШіЩ…ЩҮ ЩҮЩҲ ШӘЩҲШӯЩҠШҜ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„Щү Ш§Щ„Ш°ЩҠ ШӘЩҒШұЩ‘ШҜ ШЁШ§Щ„ЩҲШӯШҜШ§ЩҶЩҠЩ‘Ш©ШҢ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШӘШұШҜЩҠШҜ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© Щ„ЩҮШ§ШӘЩҠЩҶ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ШӘЩҠЩҶ: (Щ„Ш§ ШҘЩ„ЩҮ ШҘЩ„Ш§Щ‘ Ш§Щ„Щ„ЩҮ) ШЈЩҲ (Ш§Щ„Щ„ЩҮ ЩҠШ§ Ш§Щ„Щ„ЩҮ)ШҢ ЩҲЩҠШЁШҜШЈ Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Щ…ЩҸЩҒШ§Ш¬ШҰШ©ШҢ ЩҲШ°Щ„Щғ ШЁШ№ШҜ ШЈЩҶ ЩҠЩҸЩҸШіШӘЩҲЩҒЩү ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШЈШЁЩҠШ§ШӘ ШҙШ№Шұ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠШ¬Щ„Ші ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ Ш¬Щ…ЩҠШ№ЩҮЩ… ЩҲЩҠШЁЩӮЩү ЩҲШ§ШӯШҜШ§ЩӢ Щ…ЩҶЩҮЩ… ЩҒЩӮШ· Щ„ЩҠЩӮЩҲШҜ Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜШҢ ЩӮШҜ ЩҠЩғЩҲЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҲШӯЩ‘ШҜ ЩҮЩҲ Ш§Щ„Ш®Щ„ЩҠЩҒШ© ШЈЩҲ ШЈШӯШҜ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ…Ш¬ЩҠШҜЩҠЩҶ Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ. ЩҲШ№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩҠШЁШҜШЈ ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ ЩҶШіШӘШ·ЩҠШ№ ШЈЩҶ ЩҶШӘШЁЩҠЩ‘ЩҶ ШӘШәЩҠЩ‘Шұ ЩҶШәЩ… Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ЩҒЩҠЩҮ ЩҲШ§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШ®ШӘЩ„ЩҒ ЩӮЩ„ЩҠЩ„Ш§ЩӢ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШәЩ… ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҮЩҲШ§Щ…Ш©: ЩҠШӘШәЩҠЩ‘Шұ Ш§Щ„ЩҶШәЩ… Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸШӨШҜЩ‘ЩҠЩҮ (Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҲШӯЩ‘ШҜ) Ш§Щ„ЩҒШұШҜ Щ…ЩҶ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩӮЩҲЩ… ШЁШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШҙШ№Шұ ШЁЩҲШІЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Ш№ЩҶЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ…Ш© ЩҲШ§Щ„ЩҒШөЩ„ШҢ ЩҲЩҠШӘЩ…Щ‘ ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҮ Щ…ЩҸЩҶШәЩ‘Щ…Ш§ЩӢ ЩҲ Щ…Ш¬ШІШҰШ§ЩӢ ЩҒЩҠ ЩғЩ„Щ…Ш§ШӘШҢ Щ„ШӘШұШҜ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШЁШ№ШҜ ЩғЩ„ ЩғЩ„Щ…Ш© ШЈЩҲ ЩғЩ„Щ…ШӘЩҠЩҶ ШЁШұШҜЩҲШҜЩҮЩ… Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҮЩҲШҜШ© (Щ„Ш§ ШҘЩ„ЩҮ ШҘЩ„Ш§ Ш§Щ„Щ„ЩҮ). ШЈЩ…Щ‘Ш§ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© ЩҒШӘШҙШӘШҜ ШӯШұЩғШӘЩҮЩ… ЩҒЩҠ ЩғЩ„ Ш§Щ„Ш§ШӘШ¬Ш§ЩҮШ§ШӘШҢ ЩҲЩҠШІШҜШ§ШҜ ЩҶШәЩ… Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ ШіЩҸШұШ№Ш©ЩӢ Щ„ЩҠШӘШҜШ§Ш®Щ„ Щ…Ш№ ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҲШӯЩ‘ШҜ ЩҲЩҠШӘЩӮШ§Ш·Ш№ Щ…Ш№ЩҮШҢ ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© ЩҠЩғЩҲЩ‘ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШәЩ…Ш§ЩҶ ЩҶШіЩҠШ¬Ш§ЩӢ Щ„ШӯЩҶЩҠШ§ЩӢ ЩҲШ§ШӯШҜШ§ЩӢ Ш«ШұЩҠШ§ ЩҲЩ…ЩҸЩ…ШӘШ№Ш§ЩӢ ШӘШ·ШұШЁ ШЁШіЩ…Ш§Ш№ЩҮ Ш§Щ„ШўШ°Ш§ЩҶ.ЩҠЩӮЩҲЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҸЩҲШӯЩ‘ШҜ Ш§Щ„ЩҒШұШҜ Щ…ЩҶ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ ШЁШ§Щ„ШӯШұЩғШ© ЩҲШӘЩҲШ¬ЩҠЩҮ ШөЩҒ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш©ШҢ ЩҒЩҶШ¬ШҜЩҮ ЩҠЩӮЩҒ Ш№Щ„Щү ШұЩғШЁШӘЩҠЩҮ ЩҲЩҠШӘЩ‘ЩғШҰ Ш№Щ„Щү Ш№ШөШ§ЩҮ ЩҲЩӮШҜ ЩҠШіШ¬ШҜ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШұШ¶ ШЈЩҲ ЩҠШ¶ШұШЁ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ШЁЩҠШҜЩҮ ШЈЩҲ ШЁШ№ШөШ§ЩҮ ШЈЩҲ Щ…Ш§ ШҘЩ„Щү Ш°Щ„Щғ Щ…ЩҶ ШӯШұЩғШ§ШӘ ШӘЩҮШҜЩҒ ШҘЩ„Щү ШӘШӯЩ…ЩҠШі ЩҲШӘШҙШ¬ЩҠШ№ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© Щ„ШҘШ№Ш·Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ…ШІЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ЩҲШ§Щ„ШҘШЁШҜШ§Ш№ ЩҒЩҠЩҮШҢ ЩҒЩҠШөЩ„ Щ…Ш№ЩҮ Щ„ШӘШӯЩӮЩҠЩӮ ШЈШ№Щ„Щү ШҜШұШ¬Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҠШ§Щ… ЩҲШ§Щ„Ш№ШҙЩӮ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¬ШұЩ‘ШҜ Щ„Щ„Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„Ш№Щ„ЩҠШ©ШҢ ЩҲ Щ„ШҘЩ…ШӘШ§Ш№ Ш§Щ„ШӯШ¶ЩҲШұ ШЁЩ…Ш§ ЩҠЩҸШӨШҜЩ‘Щү ЩҒЩҠ Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ.ЩҲЩ…ЩҶ ШҙШ№Шұ Ш§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜШҢ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…Ш«Ш§Щ„:ЩҖ Щ„Ш§ ШҘЩ„ЩҮ ШҘЩ„Ш§ Ш§Щ„Щ„ЩҮШ§Щ„Щ„ЩҮШҢ ЩҠШ§ Ш§Щ„Щ„ЩҮШ¬Щ„Щ‘ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ШЁШ№Ш« Ш§Щ„ШұШіЩҲЩ„ ШұШӯЩҠЩ…Ш§ЩҲЩҠЩҺЩҖШұЩҸШҜЩ‘ Ш№ЩҖЩҶЩ‘ЩҖШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҖШ§ШҜ Ш¬ШӯЩҖЩҠЩ…Ш§ЩҲ ШЁЩҖЩҮ ЩҠЩҸЩҖЩҖШұШ§ШҜ ЩҸ Ш¬ЩҖЩҖЩҶЩ‘ЩҖЩҖШ©ЩӢ ЩҲЩҶЩҖЩҖШ№ЩҖЩҠЩҖЩ…ЩҖШ§ШЈШ¶ШӯЩү Ш№Щ„Щү ЩӮШҜШұ Ш§Щ„ЩғШұШ§Щ… ЩғШұЩҠЩ…Ш§ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҖЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…ЩҲШ§ ШӘЩҖШіЩ„ЩҠЩҖЩ…Ш§ШЈЩӮЩҖЩҲЩ„ Щ„ЩҖЩ„ШӯЩҖШ¬Щ‘ЩҖШ§Ш¬ ЩҒЩҖШІШӘЩҖЩҲШ§ ШЁШ§Щ„ЩҖЩ…ЩҶЩүЩҮЩҖЩҶШ§Щғ ЩҒЩҖШІШӘЩҖЩҲШ§ ШЁШ§Щ„Щ…ШіШұЩ‘Ш© ЩҲ Ш§Щ„ЩҮЩҖЩҶЩҖШ§ЩҲШ§ШіШӘШЁШҙШұЩҲШ§ Щ…ЩҶ ШЁШ№ШҜ ЩҒЩӮШұЩҚ ШЁШ§Щ„ШәЩҶЩүЩҲШ§Щ„Щ„ЩҮ ШІШ§ШҜЩғЩҖЩ…ЩҖЩҲШ§ ШЁЩҖЩҮ ШӘЩҖЩғЩҖЩҖШұЩҠЩҖЩҖЩ…ЩҖШ§ШөЩ„ЩҲШ§ Ш№ЩҖЩ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…ЩҲШ§ ШӘШіЩҖЩ„ЩҠЩ…ЩҖШ§ЩҲШ§Щ„ШӘЩҲШӯЩҠШҜ ЩҠШЈШӘЩҠ ЩҒЩҠ ШЈШҙЩғШ§Щ„ Щ…ШӘШ№ЩҖШҜЩ‘ШҜШ©ШҢ ШЁШӯШіШЁ Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸЩӮШ§Щ… ЩҒЩҠЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҸЩҶШ§ШіШЁШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩҸШӨШҜЩү ЩҒЩҠЩҮШ§ШҢ ЩҒЩҮЩҲ ЩӮШҜ ЩҠЩҸШӨШҜЩү ШЁШ№ШҜ ШҜЩҲШұ(ЩҒШөЩ„) ШЈЩҲ ШҜЩҲШұЩҠЩҶ Щ…ЩҶ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎШҢ ЩғЩ…Ш§ ЩҠШӯШҜШ« ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩӮШ№ ЩҒЩҠ ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШӯЩҠШ§ЩҶШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠЩҶШӘЩҮЩҠ Ш§Щ„ШҜЩҲШұ ШЈЩҲ Ш§Щ„ШҜЩҲШұЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ЩҠЩҠЩҶ Ш№ЩҶШҜЩҮЩ… ШЁШ§Щ„ЩҮЩҲШ§Щ…Ш©ШҢ Ш°Щ„Щғ Щ„ШҘШ№Ш·Ш§ШЎ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩ‘ЩҠЩ…Ш© Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ Щ„Ш§ЩғШӘШіШ§ШЁ Ш§Щ„ЩҶШҙШ§Ш· ЩҲШ§Щ„ШӯЩ…Ш§Ші ЩҲШ№ШҜЩ… ШҘШ¬ЩҮШ§ШҜЩҮЩ… Щ…ЩҶШ° ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Щ„ЩғЩҲЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш¬ШІШЎ ЩҠШӘШ·Щ„ШЁ ШЈЩғШ«Шұ Щ…ЩҶ ШәЩҠШұЩҮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ¬ШІШ§ШЎ ШЁШ°Щ„ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш¬ЩҮШҜ ЩҲШ§Щ„ЩҶШҙШ§Ш· ШЁШӯШіШЁ Ш§Щ„ШӯШұЩғШ© ЩҒЩҠЩҮ ЩҲШіШұШ№ШӘЩҮШ§. ЩҲ ЩӮШҜ ЩҠЩғЩҲЩҶ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Щ…ШөШӯЩҲШЁШ§ЩӢ ШЁШ¶ШұШЁ Ш§Щ„ШҜЩҒЩҲЩҒ Щ…ЩҶШ° ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ ЩғЩ…Ш§ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§ЩӮШ№ ЩҲЩӮШҜ Щ„Ш§ ЩҠЩғЩҲЩҶ.ШЈЩҮЩ… Ш§Щ„ШҙШ№ШұШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…ШӘШөЩҲЩ‘ЩҒШ©:ЩҶШіШӘШ№ШұШ¶ ЩҮЩҶШ§ ЩӮШ§ШҰЩ…Ш© ШЁШЈЩҮЩ… ШҙШ№ШұШ§ШЎ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШ© ЩҲШӘШұШ¬Щ…Ш§ШӘЩҮЩ… ШӯЩҠШ« ЩҠШіШӘЩ…ШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҶШҙШҜЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ ШЁШ№Ш¶ ШЈШҙШ№Ш§ШұЩҮЩ… Щ„Ш§ЩҶШҙШ§ШҜЩҮШ§ ЩҒЩҠ ШЈШ¬ШІШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҲЩҒШөЩҲЩ„ЩҮШҢ ЩҲЩҮЩ…:Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶: "ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШҘЩ…Ш§Щ… ШЈШЁЩү ШӯЩҒШө ЩҲ ШЈШЁЩү ЩӮШ§ШіЩ… Ш№Щ…Шұ ШЁЩҶ ШЈШЁЩҠ Ш§Щ„ШӯШіЩҶ ШЁЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҸШұШҙШҜ ШЁЩҶ Ш№Щ„ЩҠЩ‘ Ш§Щ„ШӯЩ…ЩҲЩҠ Ш§Щ„ШЈШөЩ„ (Щ…ЩҶ ШӯЩ…Ш§Ш© ЩҒЩҠ ШіЩҲШұЩҠШ§)ШҢ Ш§Щ„Щ…ШөШұЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜ ЩҲ Ш§Щ„ШҜШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ЩҲЩҒШ§Ш©ШҢ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒ ШЁШ§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶ШҢ Щ„ЩҖЩҸЩӮЩ‘ШЁ (ШЁШіЩ„Ш·Ш§ЩҶ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҙЩӮЩҠЩҶ) ЩҲЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү ЩҠЩӮЩҲЩ„: "ШЈЩҶШ§ ШҘЩ…Ш§Щ… Ш§Щ„Ш№Ш§ШҙЩӮЩҠЩҶ ЩҲЩғЩ„ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҙЩӮЩҠЩҶ ШӘШӯШӘ Щ„ЩҲШ§ШҰЩҠ". ЩҶЩҖЩҸШ№ШӘ Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶ ШЁШ§Щ„ШҙШұЩҒШҢ ЩҲЩӮШҜ ШЈШЁШҜШ№ ЩҲШЈШ¬Ш§ШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ЩҶЩҠ Ш§Щ„ШҜЩӮЩҠЩӮШ© ЩҲШ§Щ„Ш№ШЁШ§ШұШ§ШӘ Ш§Щ„ШұШҙЩҠЩӮШ© Ш§Щ„ШұЩӮЩҠЩӮШ©Шӣ ЩғШ§ЩҶ Щ…ШӘШ¬ШұШҜШ§ЩӢ ШөШ§Щ„ШӯШ§ЩӢШҢ Щ…ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„Ш№ШҙЩҠШұШ© ШӯШіЩҶ Ш§Щ„ШөШӯШЁШ©ШҢ Ш¬Ш§ЩҲШұ Щ…ЩғШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШұЩ…Ш© ШІЩ…Ш§ЩҶШ§ЩӢ(4)".Ш§Щ„ШЁЩҸШұЩ’Ш№ЩҠ: ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШҘЩ…Ш§Щ… Ш§Щ„ШҙЩҠШ® Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ШұШӯЩҠЩ… ШЁЩҶ ШЈШӯЩ…ШҜ ШЁЩҶ Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ШұШӯЩҠЩ… ШЁЩҶ Ш§ШіЩ…Ш§Ш№ЩҖЩҠЩ„ Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠШҢ Ш№ЩҸШұЩҒ ШЁШЈШөЩ„ЩҮ Ш§Щ„ЩҠЩ…ЩҶЩҠ ЩҶШіШЁШ© ШҘЩ„Щү ЩӮЩҖШЁЩҠЩ„Ш© ШЁШұШ№ШҢ ЩҒЩӮЩҠЩҮ ШөЩҲЩҒЩҠШҢ Ш№Ш§Шҙ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶШөЩҒ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШұЩҶ Ш§Щ„Ш«Ш§Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҮШ¬ШұЩҠ ЩҲШЈЩҲШ§ШҰЩ„ Ш§Щ„ЩӮШұЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§ШіШ№ШҢ ЩӮШұШЈ Ш§Щ„ЩҒЩӮЩҮ ЩҲШ§Щ„ЩҶШӯЩҲ ЩҲШӘШЈЩҮЩ„ Щ„Щ„ШӘШҜШұЩҠШіШҢ Щ„ЩҮ ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ ШҙШ№Шұ Щ…Ш·ШЁЩҲШ№ ШЁШ§ШіЩ… "ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш§ШЁШӘЩҮШ§Щ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¶ШұЩ‘Ш№Ш§ШӘ Ш§Щ„ШҘЩ„ЩҮЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш§ШіШӘШ№Ш·Ш§ЩҒШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…ШҜШ§ШҰШӯ Ш§Щ„Щ…ШӯЩ…Щ‘ШҜЩҠЩ‘Ш© " ЩҲ Ш№ШҜШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩү.ЩҲ ЩҠЩҸШұЩҲЩү ШЈЩҶ ЩӮШөЩҠШҜШӘЩҮ (ЩҠШ§ ШұШ§ШӯЩ„ЩҠЩҶ ШҘЩ„Щү Щ…ЩҶЩү ШЁЩӮЩҠШ§ШҜ) ЩҶШёЩ…ЩҮШ§ ЩҒЩҠ ШӯШ¬ЩҮ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҠШұ Щ„Щ…Ш§ ШөШ§Шұ Ш№Щ„Щү ШЁШ№ШҜ 50 Щ…ЩҠЩ„Ш§ Щ…ЩҶ Щ…ЩғШ© ЩҲЩӮШҜ ШЈШӯШі ШЁШҜЩҶЩҲ ШЈШ¬Щ„ЩҮ ЩҒЩҶШёЩ…ЩҮШ§ ЩҲЩ„ЩҒШё ЩҶЩҒШіЩҮ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҠШұ Щ…Ш№ ШўШ®Шұ ШЁЩҠШӘ Щ…ЩҶЩҮШ§.Ш§Щ„ШӯШҜЩ‘Ш§ШҜ: ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШҘЩ…Ш§Щ… Ш§Щ„ШҙЩҠШ® Ш№ШЁШҜШ§Щ„Щ„ЩҮ ШЁЩҶ Ш№Щ„ЩҲЩҠ ШЁЩҶ Щ…ШӯЩ…ШҜШҢ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҲЩҒ ШЁЩҖ (Ш§Щ„ШӯШҜЩ‘Ш§ШҜ)ШҢ Щ…ЩҶ Щ…ШҜЩҠЩҶШ© ШӘШұЩҠЩ… ЩҒЩҠ ШӯШ¶ШұЩ…ЩҲШӘ Ш§Щ„ЩҠЩ…ЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҶЩҮШ¬ Ш·ШұЩҠЩӮ Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШ© ЩҲЩ„ЩӮШЁ (ШЁШҙЩҠШ® Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…) ЩҲ (ЩӮШ·ШЁ Ш§Щ„ШҜШ№ЩҲШ© ЩҲ Ш§Щ„ШҘШұШҙШ§ШҜ)ШҢ Щ…Ш¬ШҜШҜ Ш·ШұЩҠЩӮШ© Ш§Щ„ШіШ§ШҜШ© ШўЩ„ ШЁШ§ Ш№Щ„ЩҲЩҠШҢ ЩҠШ№ЩҲШҜ ЩҶШіШЁЩҮ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШӯШіЩҠЩҶ ШЁЩҶ Ш№Щ„ЩҠ ШЁЩҶ ШЈШЁЩҠ Ш·Ш§Щ„ШЁШҢ ШӘШұЩғ Ш№ШҜШҜШ§ЩӢ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒШ§ШӘ Ш·ШЁШ№ШӘ ЩҲ ШӘШұШ¬Щ… ШЁШ№Ш¶ЩҮШ§ ШҘЩ„Щү Щ„ШәШ§ШӘ Ш№ШҜЩҠШҜШ©ШҢ ЩҲЩ„ЩҮ ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ ШҙШ№Шұ Щ…Ш·ШЁЩҲШ№ ШЁШ№ЩҶЩҲШ§ЩҶ: (ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ Ш§Щ„ШҜШұШұ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩҲЩ… Щ„Ш°ЩҲЩҠ Ш§Щ„Ш№ЩӮЩҲЩ„ ЩҲ Ш§Щ„ЩҒЩҮЩҲЩ…)ШҢ ЩҲЩҮЩҲ ЩҠШӘШ¶Щ…Щ‘ЩҶ ЩӮШөШ§ШҰШҜЩҮ ЩҲШЈШҙШ№Ш§ШұЩҮ Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШӘШ¬Щ„Щү ЩҒЩҠЩҮШ§ ШӯШЁЩҮ Ш§Щ„ШҙШҜЩҠШҜ Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„Щү ЩҲЩ„ШұШіЩҲЩ„ЩҮ Ш§Щ„Ш№ШёЩҠЩ… ЩҲЩ…ШҜШӯЩҮ ЩҲШӯШЁЩҮ Ш§Щ„ЩғШЁЩҠШұ Щ„Щ„ШҜЩҠШ§Шұ Ш§Щ„Щ…ЩӮШҜЩ‘ШіШ© Ш§Щ„Ш·Ш§ЩҮШұШ©.Ш§Щ„Ш¬ЩҠЩ„Ш§ЩҶЩҠ: ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШҙЩҠШ® ШЈШЁЩҲ Щ…ШӯЩ…ШҜ Щ…ШӯЩҠ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶ Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШұ Ш§Щ„Ш¬ЩҠЩ„Ш§ЩҶЩҠШҢ ЩҮЩҲ ШөШ§ШӯШЁ Ш§Щ„Ш·ШұЩҠЩӮШ© Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШұЩҠШ© Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШ©ШҢ Щ„ЩҮ Ш§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒШ§ШӘ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш·ШЁЩҲШ№ ЩҲЩ…Ш®Ш·ЩҲШ·ШҢ Щ…ЩҶЩҮШ§ Щ…Ш«Щ„Ш§ ЩғШӘШ§ШЁ: (Ш¬ЩҲШ§ЩҮШұ Ш§Щ„ШЈШіШұШ§Шұ ЩҲЩ„Ш·Ш§ШҰЩҒ Ш§Щ„ШЈЩҶЩҲШ§Шұ) ЩҒЩҠ Ш№Щ„Щ… Ш§Щ„ШөЩҲЩҒЩҠШ© ЩҲ (ШҘШәШ§Ш«Ш© Ш§Щ„Ш№Ш§ШұЩҒЩҠЩҶ ЩҲШәШ§ЩҠШ© Щ…ЩҶЩү Ш§Щ„ЩҲШ§ШөЩ„ЩҠЩҶ) ЩҲ (ШЈЩҲШұШ§ШҜ Ш§Щ„Ш¬ЩҠЩ„Ш§ЩҶЩҠ) ЩҲШәЩҠШұЩҮШ§ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ. ШЈЩ…Ш§ ЩғШӘШ§ШЁ: (Ш§Щ„ЩҒЩҠЩҲШ¶Ш§ШӘ Ш§Щ„ШұШЁЩ‘Ш§ЩҶЩҠЩ‘Ш©) ЩҒЩ„ЩҠШі Щ„Щ„ШҙЩҠШ® Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШұ ШәЩҠШұ ШЈЩҶЩҮ ЩҠШӯШӘЩҲЩҠ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ ШЈЩҲШұШ§ШҜ ЩҲШЈШҜШ№ЩҠШ© ЩҲШЈШӯШІШ§ШЁ Ш§Щ„ШҙЩҠШ® Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШұ Ш§Щ„Ш¬ЩҠЩ„Ш§ЩҶЩҠ.Ш§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ: ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШіЩҠЩ‘ШҜ Ш¬Ш№ЩҒШұ ШЁЩҶ Ш§Щ„ШіЩҠЩ‘ШҜ ШҘШіЩ…Ш§Ш№ЩҠЩ„ Ш§Щ„Щ…ШҜЩҶЩҠ Ш§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠШҢ ЩҲЩҠШ№ШұЩҒЩҮ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ…Ш© ШЁШ§ШіЩ… (Ш§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ)ШҢ Щ„ЩҮ ЩғШӘШ§ШЁ ШЁШ№ЩҶЩҲШ§ЩҶ: "Щ…ЩҲЩ„ЩҲШҜЩҢ ШҙШұЩ‘ЩҒ Ш§Щ„ШЈЩҶШ§Щ…" Щ…ЩҲШ¬ЩҲШҜЩҢ ЩҒЩҠ Ш«Щ„Ш§Ш« Ш·ШЁШ№Ш§ШӘ: ШҙШ§Щ…ЩҠЩ‘Ш©ШҢ ЩҲ ШЁШ§ЩғШіШӘШ§ЩҶЩҠШ©ЩҢШҢ ЩҲ ЩҮЩҶШҜЩҠЩ‘Ш©ЩҢШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШ®ЩҠШұШ© ЩҮЩҠ ШЈЩғШ«ШұЩҮШ§ ШҙЩҠЩҲШ№Ш§ЩӢ ЩҲШ§ЩҶШӘШҙШ§ШұШ§ЩӢШҢ ЩҲЩҠЩҶЩӮШіЩ… ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁ ШҘЩ„Щү Ш«Щ„Ш§Ш«Ш© ШЈЩӮШіШ§Щ…ШҢ ЩҮЩҠ: Ш§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜ Ш§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ ЩҶШёЩ…Ш§ЩӢШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҲЩ„ШҜ Ш§Щ„ШЁШұШІЩҶШ¬ЩҠ ЩҶШ«ШұШ§ЩӢШҢ Ш«Щ…Щ‘ Ш§Щ„ЩӮШіЩ… Ш§Щ„Ш«Ш§Щ„Ш« Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШӯШӘЩҲЩҠ Ш№Щ„Щү: ШЈШҜШ№ЩҠШ© Ш®ШӘЩ… Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…ШҢ ЩҲЩӮШөЩҠШҜШ© Ш§Щ„ШЁШұШҜШ© Щ„Щ„ШҘЩ…Ш§Щ… Ш§Щ„ШЁЩҲШөЩҠШұЩҠШҢ ЩҲШ№ЩӮЩҠШҜШ© Ш§Щ„Ш№ЩҲШ§Щ….Ш®Ш§ШӘЩ…Ш©ЩҲШЁШ№ШҜШҢ ЩҒЩӮШҜ ЩӮШҜЩ‘Щ…ЩҶШ§ Ш®Щ„Ш§Щ„ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҲШұЩӮШ© Ш№ШұШ¶Ш§ЩӢ ЩҲШөЩҒЩҠШ§ЩӢ Щ„ШЁШ№Ш¶ ШёЩҲШ§ЩҮШұ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠ Ш№ЩҶШҜ Ш№ШҜШҜ Щ…ЩҶ ШЈЩҮЩ„ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶШҢ ШӘЩ…Ш«Щ„ Ш°Щ„Щғ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШөЩҠШәШ© Щ…ЩҶ ШөЩҠШә Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶЩҠ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҠ Щ„Ш§ШҙЩғ ШӘШӯЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Ш«ЩҶШ§ЩҠШ§ЩҮШ§ Ш§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮЩҠЩ… Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶЩҠШ© ЩҲ Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҠШ© ЩҲ Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШ®ШӘШө ШЁЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ ЩҒЩҠ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶШҢ ЩҲЩҮЩҠ Ш®Ш§ШөЩҠШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„Щ…Щ…ЩҠШІШ© Щ„Щ„Щ…ШЁШ§ШҜШҰ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Щ„ЩҠШ© Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШ©ШҢ ЩҲШӘШІШ®Шұ ШЁЩҶЩ…Ш§Ш°Ш¬ Ш№ШҜЩҠШҜШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш¶Ш§Щ…ЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠШ© ЩғШ§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШ«ШұЩҠШ© ЩҲ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ§ШёЩҠЩ… Ш§Щ„ШҙШ№ШұЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ШЈШҜШ№ЩҠШ© ЩҲШәЩҠШұЩҮШ§.ШҘЩҶ Ш§Щ„Щ…Щ…Ш§ШұШіЩҠЩҶ Щ„Щ„Щ…Ш§Щ„ШҜ ЩҠШ№ШӘШЁШұЩҲЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШЈШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҠ Ш§Щ„ШӯШұЩғЩҠ ЩҶШҙШ§Ш·Ш§ ШҜЩҠЩҶЩҠШ§ ШӘШ№ШЁШҜЩҠШ§ЩӢ Щ„ЩҮ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҒЩҲШ§ШҰШҜ Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҶЩҒШіЩҠШ© Ш№ЩҶШҜЩҮЩ… ЩҲЩҮЩҲ ШҘЩ„Щү Ш¬Ш§ЩҶШЁ Ш°Щ„Щғ ЩҠШ№ШӘШЁШұ Щ…ШҙШ§ШұЩғШ© Ш¬Щ…Ш№ЩҠШ© Щ„ШҘЩ„ЩӮШ§ШЎ Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ЩҲШ§Щ„ЩҶШ«Шұ ЩҲШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҮ ЩҲЩҮШ°Ш§ ЩҠЩҲЩ„ШҜ Ш№ЩҶШҜЩҮЩ… ШҙШ№ЩҲШұ ЩӮЩҲЩҠ ШЁШ§Щ„ШұШ¶Щү Ш§Щ„ЩҶЩҒШіЩҠ ЩҲШ§Щ„ШұЩҲШӯЩҠ ЩҲШ§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠ ШҘЩ„Щү Ш¬Ш§ЩҶШЁ Ш§Щ„Ш№ШҜЩҠШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШөЩҠШә Ш§Щ„ШҘЩҶШҙШ§ШҜЩҠШ© Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩү Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШІШ®Шұ ШЁЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ ЩҒЩҠ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ.Ш§Щ„Щ…ШөШ§ШҜШұ ЩҲШ§Щ„Щ…ШұШ§Ш¬Ш№:ЩҖЩҖ Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶ШҢ Ш№Щ…Шұ ШЁЩҶ ШЈШЁЩҠ Ш§Щ„ШӯШіЩҶШҢ "ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ Ш§ШЁЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШ¶"ШҢ ШҘШөШҜШ§Шұ Щ…ШӨШіШіШ© Ш§Щ„Щ…Ш·ШЁЩҲШ№Ш§ШӘ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШ©ШҢ Ш§Щ„ЩӮШ§ЩҮШұШ©ШҢ Щ…ШөШұ.ЩҖЩҖ Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠШҢ Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„ШұШӯЩҠЩ…ШҢ "ШҜЩҠЩҲШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЁШұШ№ЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш§ШЁШӘЩҮШ§Щ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¶ШұЩ‘Ш№Ш§ШӘ Ш§Щ„ШҘЩ„ЩҮЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш§ШіШӘШ№Ш·Ш§ЩҒШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…ШҜШ§ШҰШӯ Ш§Щ„Щ…ШӯЩ…Щ‘ШҜЩҠШ©"ШҢ Ш№Щ„ЩҠ Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш§Щ„ШӯШ§Ш¶ШұЩҠ ЩҲШЈЩҲЩ„Ш§ШҜЩҮШҢ ШҙШ§ШұШ№ Ш§Щ„ЩҒШӘШӯ Ш§Щ„ШөШ№ШҜЩҠ.ЩҖЩҖ Ш§Щ„ШҙЩҠШҜЩҠШҢ Ш¬Щ…Ш№Ш© ШЁЩҶ Ш®Щ…ЩҠШіШҢ ШЈЩҶЩ…Ш§Ш· Ш§Щ„Щ…ШЈШ«ЩҲШұ Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩҠ Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠ .. ШҜШұШ§ШіШ© ШӘЩҲШ«ЩҠЩӮЩҠШ© ЩҲШөЩҒЩҠШ©ШҢ ШҘШөШҜШ§Шұ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ…ШҢ Щ…ШіЩӮШ· вҖ“ 2008.ЩҖЩҖ Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§ШӯШҢ Ш№ШөШ§Щ… (ШӘШӯШұЩҠШұ)ШҢ " Ш§Щ„ЩҲШ«Ш§ШҰЩӮ Ш§Щ„ЩғШ§Щ…Щ„Ш© Щ„Щ„ЩҶШҜЩҲШ© Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„ЩҠШ© Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©"ШҢ Щ…Ш·ШЁЩҲШ№Ш§ШӘ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ (Ш¬ 1ШҢ 2ШҢ 3)ШҢ ШҘШөШҜШ§Шұ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ…ШҢ Щ…ШіЩӮШ·ШҢ 1994ШҢ Ш§Щ„ЩҶШ§ШҙШұ: ЩҒЩ„ЩҲШұЩҠШ§ЩҶ ЩҶЩҲШӘШІЩ„ШҢ ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ§.ЩҖЩҖ Щ…ШөШ·ЩҒЩүШҢ ЩҠЩҲШіЩҒ ШҙЩҲЩӮЩҠШҢ Щ…Ш№Ш¬Щ… Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ…ШҢ 1989.ЩҖЩҖ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШӘШұШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ…ЩҠ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒШ©ШҢ ШіЩ„ШіЩ„Ш© Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҲЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№ШЁЩҠШ© Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠШ© Ш¬ 1-4ШҢ Ш· Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ЩүШҢ 1991Щ….ЩҖЩҖ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұЩҠШҢ Щ…ШіЩ„Щ… ШЁЩҶ ШЈШӯЩ…ШҜШҢ Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠШ©.. Щ…ЩҸЩӮШ§ШұШЁШ© ШӘШ№ШұЩҠЩҒЩҠШ© ЩҲ ШӘШӯЩ„ЩҠЩ„ЩҠШ©ШҢ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ© Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ….ЩҖЩҖ Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§ШӯШҢ Ш№ШөШ§Щ…ШҢ " Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ© ЩҲ Ш№Щ„Щ… Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү"ШҢ Ш¬1ШҢ Ш¬2ШҢ ШҘШөШҜШ§Шұ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ…ШҢ Щ…ШіЩӮШ·ШҢ 1997ШҢ Ш§Щ„ЩҶШ§ШҙШұ: ЩҮШ§ЩҶШІ ШҙЩҶШ§ЩҠШҜШұШҢ ШЈЩ„Щ…Ш§ЩҶЩҠШ§.ЩҖЩҖ Щ…ЩҶ ЩҒЩҶЩҲЩҶ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ Щ…ШұЩғШІ Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶ Щ„Щ„Щ…ЩҲШіЩҠЩӮЩү Ш§Щ„ШӘЩӮЩ„ЩҠШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲШІШ§ШұШ© Ш§Щ„ШҘШ№Щ„Ш§Щ….ЩҖЩҖ Щ…ЩӮШ§ШЁЩ„Ш§ШӘ Ш№ШҜЩҠШҜШ© Щ…Ш№ Ш№ШҜШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШұЩҲШ§Ш© ЩҲШ§Щ„Щ…Щ…Ш§ШұШіЩҠЩҶ ЩҲШ§Щ„Ш№Ш§ШұЩҒЩҠЩҶ ШЁШ§Щ„Щ…ЩҲШұЩҲШ« Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш№ЩҸЩ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҒЩҠ Ш№ШҜШҜ Щ…ЩҶ ЩҲЩ„Ш§ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШіЩ„Ш·ЩҶШ© Щ…ЩҶ 84 вҖ“ 2005. Ш¬Щ…Ш№Ш© ШЁЩҶ Ш®Щ…ЩҠШі Ш§Щ„ШҙЩҠШҜЩҠШ¬Ш§Щ…Ш№ Щ…ЩҠШҜШ§ЩҶЩҠ ЩҲ ШЁШ§ШӯШ« ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘШұШ§Ш« Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠ