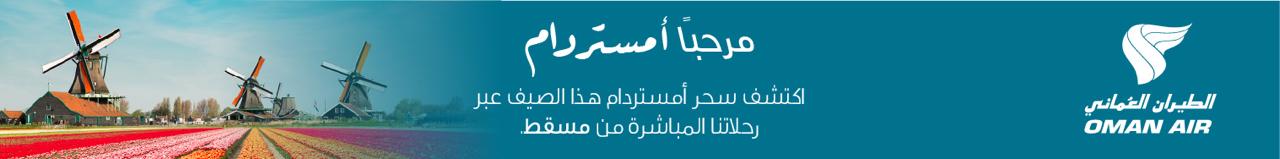[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/uploads/2015/03/must.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]أحمد مصطفى[/author]أما النسيء الفرعوني (والقبطي بالتالي) فيختلف تماما عن النسيء في الجاهلية بشبه الجزيرة العربية، إذ استقر الناس في وادي النيل على إضافة الأيام الأربعة في وقت محدد بنهاية السنة المصرية دون تغيير ليظل مطلع السنة القبطية/الفرعونية متوافقا مع 11 سبتمبر من التقويم الميلادي/الشمسي. وظل هذا التقويم حتى وقت قريب هو المعتمد لدى المزارعين في وادي النيل، وأذكر أننا كنا نعرف مواسم الزرع والحصاد والري وغيره من نشاطات الزراعة التقليدية في أيام طفولتي وصباي بتلك الشهور.يقول البعض إن تسمية البشر "إنسان" جاءت من أنه نساء، وإن تفاوت النسيان بين شخص وآخر، إلا أنه سمة عامة بين البشر. وقد يساعد النسيان المرء على المضي قدما في حياته رغم ما قد يواجه من صعاب لو ظلت تثقل عليه فكرا وتذكرا لعطلت مسيرته وأحبطت همته. تذكر المرء كل هذا مع حلول مطلع السنة القبطية/الفرعونية هذه الأيام، إذ كان يوم الحادي عشر من سبتمبر هو أول شهر توت في السنة القبطية 1734 والسنة الفرعونية 6259. ولأن التقويم القبطي امتداد للتقويم الفرعوني، فلنسمها السنة المصرية القديمة عموما. ويأتي شهر توت بعد شهر مسرى ـ آخر شهور السنة المصرية ـ بأربعة أيام (من 6 إلى 10 سبتمبر) تسمى شهر النسيء أو أيام النسيء.ورغم كل ما قيل عن النسيء، فاللافت أن أصل الكلمة أيضا مرتبط بالنسيان، وإن كان ذلك في اعتقادي المتواضع لا يتعارض مع كل ما ذكر عن النسيء حتى في القرآن الكريم. فقد حرم القرآن النسيء لسوء استغلاله في أيام الجاهلية، إذ كان الناس يغيرون موضعه من السنة لتحليل شهر حرام أو تحريم شهر حلال (فيما يتعلق بالقتال) وذلك لأغراض سياسية بجعل وقت الحرب مناسبا لطرف دون الآخر. لذا جاءت الآية الكريمة من سورة التوبة "إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين" صدق الله العظيم. وبالفهم البسيط، فقد حرم الله ما كان يفعله الكفار بتلك الأيام من السنة بتغيير مواضعها وكان ذلك زيادة في كفرهم بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله لعباده.ومع أن بعض المعاصرين المغالين في الشطط أثاروا حفيظة علماء الدين بحديثهم عن النسيء، إلا أن كل ذلك الجدل كان مدفوعا بأغراض أخرى غير ماهية النسيء وسوء استغلاله في مرحلة ما قبل الإسلام ونهي القرآن عن ذلك. وبشكل بسيط، هي أيام تضاف لشهور العام كي تكتمل المدة الزمنية للسنة (الحول) باكتمال دورة الأرض حول الشمس. وهي أقرب ما تكون للفارق بين العام الهجري (التقويم القمري) والميلادي (الغريغوري) الذي يعتمد على الشمس إذ تقل السنة القمرية بنحو 11 يوما عن السنة الشمسية. ولاختلاف طول الشهور في التقويم الفرعوني القديم (الذي اعتمد ظواهر طبيعية ترتبط بالنهر والزراعة) يتقلص الفارق عن التقويم القمري بنحو أسبوع. ولا عجب في أن التقويم الفرعوني بدأ منذ أكثر من أربعة آلاف عام قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فقد احتاج الإنسان منذ بداية إعماره الأرض أن يحسب الوقت لينظم استغلاله للطبيعة.لهذا، كان العرب في الجاهلية يستخدمون "شهر النسيء" بإضافة 11 يوما للسنة أو 33 يوما كل ثلاث سنوات لتظل السنة القمرية متسقة مع السنة الشمسية وبذلك تنظم مواعيد الزراعة والتجارة (كرحلة الشتاء والصيف). لكن سوء استغلال تلك الأيام والتلاعب بمواضعها من السنة لتأجيل الحروب أو تعجيلها هو ما جعل الإسلام يلغيها، فأصبحت السنة الهجرية أقصر دوما بنحو 11 يوما عن السنة الميلادية، وأصبح شهر رمضان والحج يأتي في فصول مختلفة كل عدة سنوات. ولم يعد الصوم في فصل الصيف فقط ولا الحج في الخريف فقط، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى في أن تتغير الفصول التي تؤدى فيها العبادات والشعائر. لكن ذلك لا يجعل بعض المغالين في الدين يكفرون من يتحدثون عن النسيء ولا يبرر أيضا لبعض المغالين في الشوفينية أن يعتبروا النسيء إنجازا علميا يتعارض مع الدين.معذرة للإطالة في كل هذا، وعودة إلى ما بدأنا به عن النسيء، وكيف كان البسطاء يعتبرون تلك الأيام من السنة المصرية بين شهري مسرى وتوت "أياما منسية" يتطلب استقامة التقويم الزمني إضافتها. وهذا ما قصدته من الحديث عن النسيان، وعلاقته بالإنسان، وكيف أنه يمثل تفسيرا بسيطا لكثير من الأمور المعقدة. ورغم ما قد يراه البعض من مثالب لخصلة النسيان، إلا أن فيها أيضا الكثير من الإيجابيات. وما وضع الله من صفة في خلقه إلا لحكمة، ومن فوائد النسيان أنه يجعل الناس تتسامح وتتعايش ولا يتراكم البغض في نفوسهم فتستحيل حياتهم بسلام. أما النسيء الفرعوني (والقبطي بالتالي) فيختلف تماما عن النسيء في الجاهلية بشبه الجزيرة العربية، إذ استقر الناس في وادي النيل على إضافة الأيام الأربعة في وقت محدد بنهاية السنة المصرية دون تغيير ليظل مطلع السنة القبطية/الفرعونية متوافقا مع 11 سبتمبر من التقويم الميلادي/الشمسي. وظل هذا التقويم حتى وقت قريب هو المعتمد لدى المزارعين في وادي النيل، وأذكر أننا كنا نعرف مواسم الزرع والحصاد والري وغيره من نشاطات الزراعة التقليدية في أيام طفولتي وصباي بتلك الشهور. وما زال ارتباطها بالأمثال الشعبية المصرية موجودا في تراث الريف المصري، وإن كنت لا تجد أيا من الأمثال أو التراث يذكر أيام النسيء ـ ربما لأنها ليست شهرا، وربما لأنهم نسوه.