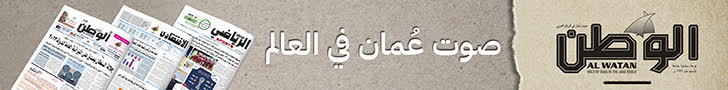ШЄЩ‚Щ€Щ„ ШЩѓЩ…Ш© Щ‡Щ†ШЇЩЉШ©: "ШЈШ®ШЁШ±Щ†ЩЉ ШЩ‚ЩЉЩ‚Ш© Ш«Ш§ШЁШЄШ© Щ„ЩѓЩЉ ШЈШЄШ№Щ„Щ‘Щ…ШЊ Щ€ШЈШ®ШЁШ±Щ†ЩЉ ШЩ‚ЩЉЩ‚Ш© ШµШ§ШЇЩ‚Ш© Щ„ЩѓЩЉ ШЈШ¤Щ…Щ†ШЊ Щ€Щ„ЩѓЩ† ШЈШ®ШЁШ±Щ†ЩЉ Щ‚ШµШ© Щ„ШЄШ№ЩЉШґ ЩЃЩЉ Щ‚Щ„ШЁЩЉ Щ…ШЇЩ‰ Ш§Щ„ШЩЉШ§Ш©". Щ€ЩЉШ№Ш±Щ‘ЩЃ Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® ШЁШЈЩ†Щ‡ ШЄШіШ¬ЩЉЩ„ Щ€Щ€ШµЩЃ Щ€ШЄШЩ„ЩЉЩ„ Ш§Щ„ШЈШШЇШ§Ш« Ш§Щ„ШЄЩЉ Ш¬Ш±ШЄ ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ…Ш§Ш¶ЩЉШЊ Ш№Щ„Щ‰ ШЈШіШі Ш№Щ„Щ…ЩЉШ© Щ…ШШ§ЩЉШЇШ©ШЊ Щ„Щ„Щ€ШµЩ€Щ„ ШҐЩ„Щ‰ ШЩ‚Ш§Ш¦Щ‚ Щ€Щ‚Щ€Ш§Ш№ШЇ ШЄШіШ§Ш№ШЇ Ш№Щ„Щ‰ ЩЃЩ‡Щ… Ш§Щ„ШШ§Ш¶Ш± Щ€Ш§Щ„ШЄЩ†ШЁШ¤ ШЁШ§Щ„Щ…ШіШЄЩ‚ШЁЩ„. Щ€Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ®: ЩЃЩ† ЩЉШЁШШ« Ш№Щ† Щ€Щ‚Ш§Ш¦Ш№ Ш§Щ„ШІЩ…Ш§Щ† Щ…Щ† ШЩЉШ« Ш§Щ„ШЄШ№ЩЉЩЉЩ† Щ€Ш§Щ„ШЄЩ€Щ‚ЩЉШЄШЊ Щ€Щ…Щ€Ш¶Щ€Ш№Щ‡ Ш§Щ„ШҐЩ†ШіШ§Щ† Щ€ Ш§Щ„ШІЩ…Ш§Щ†. (Ш§Щ„ШіШ®Ш§Щ€ЩЉ)Щ€ЩЉЩ‚Щ€Щ„ Щ…ШµШ·ЩЃЩЉ Щ„Ш·ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ…Щ†ЩЃЩ„Щ€Ш·ЩЉ: Щ…Щ† ЩЉШ№Ш±ЩЃ Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® Ш§Щ„Ш№Ш§Щ… Ш§Щ„Ш°ЩЉ ШіШЁЩ‚ ЩЉШ¶ЩЉЩЃ ШҐЩ„Щ‰ Ш№Щ…Ш±Щ‡ Ш№ШЇШЇ ШіЩ†Щ€Ш§ШЄ Ш°Щ„Щѓ Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ®. ШЈЩ…Ш§ Щ†Ш§ШЁЩ„ЩЉЩ€Щ† ЩЃЩ‚Ш§Щ„: Ш№Щ„Щ‰ Щ€Щ„ШЇЩЉ ШЈЩ† ЩЉЩ‚Ш±ШЈ ШЄШ§Ш±ЩЉШ®Ш§ Щ€ЩЉШ·Ш§Щ„Ш№ Щ€ЩЉШЄЩ†ШґЩ‚ Ш§Щ„Ш№Щ„Щ…ШЊ Щ€ШҐЩ† Щ‚Ш±ШЈ ЩЃЩ„ЩЉЩ‚Ш±ШЈ Щ€ЩЉШЩ„Щ‘Щ„ Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® ...ШЊ Щ€ЩЃЩЉ Ш§Щ„ШЈШ«Ш± Щ‚Ш§Щ„ Ш§ШЁЩ† Ш®Щ„ШЇЩ€Щ†: ШҐЩ†Щ‘ ЩЃЩЉ Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® Ш§Щ„Ш№ШёШ© Щ€Ш§Щ„Ш№ШЁШ±Ш©ШЊ ЩЃЩ†ШЩ† Щ†ШЇШ±Ші ШЄЩ€Ш§Ш±ЩЉШ® Ш§Щ„ШЇЩ€Щ„ Щ€Ш§Щ„Щ…Щ„Щ€Щѓ Щ„Щ†ШЄШ№Щ„Щ‘Щ…ШЊ Щ€Щ†ШЇШ±Ші ШіЩЉШ± Ш§Щ„ШЈЩ†ШЁЩЉШ§ШЎ Щ„Щ†ШЄШЈШіЩ‘Щ‰ ШЁЩ‡Щ…ШЊ Щ€Щ†ШЇШ±Ші ШЄШ¬Ш§Ш±ШЁ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ… Щ€Щ†Ш±Щ‰ Щ…Ш§ Щ€Щ‚Ш№ШЄ ЩЃЩЉЩ‡ Щ…Щ† Ш§Щ„ШЈШ®Ш·Ш§ШЎ Щ„Щ†Щ†Ш¬Щ€Ш§ ШЁШЈЩ†ЩЃШіЩ†Ш§ Ш№Щ† Щ…Щ€Ш§Ш·Щ† Ш§Щ„Ш¶Щ‘Ш±Ш±. (Ш§Щ„ШЩ€ЩЉШ±ЩЉШЊ 2001ШЊ Шµ 19-22).Щ€Щ„Щ†Ш±ШЁШ· Ш§Щ„ШЈЩ…Щ€Ш± ШЁШЁШ№Ш¶Щ‡Ш§ ЩЃШҐЩ†Щ‘Щ‡ Щ„Ш§ ШЁШЇ Щ„ЩЉ Щ€ШЈЩ† Ш§ШіШЄШ№Ш±Ш¶ Щ†ШёШ±ЩЉШ§ШЄ Ш§Щ„Щ†Щ…Щ€ Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉ Щ€Ш§Щ„ШЈШ®Щ„Ш§Щ‚ЩЉ Щ„ШЇЩ‰ Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ШЊ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШЄШЈЩѓЩЉШЇ Ш№Щ„Щ‰ Щ…Ш§ ЩЉШ®ШЇЩ… Ш§Щ„ШЁШШ« ЩЃЩЉЩ…Щ‘Ш§ ШҐШ°Ш§ ЩѓШ§Щ† ШЄЩ‚ШЇЩЉЩ… Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® ЩЃЩЉ Щ‚Ш§Щ„ШЁ ШЈШЇШЁЩЉ Щ€Щ‚ШµШµЩЉ Щ„Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ ШЈЩЃШ¶Щ„ Щ…Щ† ШЄЩ‚ШЇЩЉЩ…Щ‡ ЩЃЩЉ Щ‚Ш§Щ„ШЁ Щ…Ш№Щ„Щ€Щ…Ш§ШЄЩЉ Щ…ШЁШіЩ‘Ш·ШЊ ШЈЩ… Щ„Ш§.ШЄЩ‚Щ€Щ„ Ш§Щ„Щ†ШёШ±ЩЉШ© Ш§Щ„Щ†ЩЃШіЩЉШ© Ш§Щ„Щ†ШёШ±ЩЉШ© Ш§Щ„Щ…Ш№Ш±ЩЃЩЉШ© (ШЁЩЉШ§Ш¬ЩЉЩ‡): Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ ЩЉШШЄШ§Ш¬ ШҐЩ„Щ‰ ШЄЩ†Щ…ЩЉШ© Ш§Щ„ШґШ№Щ€Ш± ШЁШ§Щ„Щ…ШіШ¤Щ€Щ„ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„ШЄШ№Ш§Щ€Щ† Щ…Ш№ Ш§Щ„ШўШ®Ш±ЩЉЩ† Щ€Щ…ШґШ§Ш±ЩѓШ© Ш§Щ„ЩѓШЁШ§Ш± Щ„Щ‡ШЊ ЩѓЩ…Ш§ ЩЉШШЄШ§Ш¬ ШҐЩ„Щ‰ ШЄЩ†Щ…ЩЉШ© ШҐШШіШ§ШіЩ‡ ШЁШ§Щ„Ш§Щ†ШЄЩ…Ш§ШЎ Щ„Щ€Ш§Щ„ШЇЩЉЩ‡ ШЁШЇШ§ЩЉШ© Щ„ШЈЩ†Щ‘ Щ‡Ш°Ш§ ЩЉШіШ§Ш№ШЇЩ‡ ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ†Ш¬Ш§Ш ЩЃЩЉ Ш№ШЇЩЉШЇ Щ…Щ† Ш§Щ„ШЈЩ…Щ€Ш± ЩЃЩЉ Щ…ШіШЄЩ‚ШЁЩ„ ШЩЉШ§ШЄЩ‡. (Щ…ЩЉЩ„Щ„Ш±ШЊ2005ШЊ89:90)ШЈЩ…Ш§ Ш§Щ„Щ†ШёШ±ЩЉШ© Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉШ© (Ш§Ш±ЩЉЩѓ ШЈШ±ЩЉЩѓШіЩ€Щ†) ЩЃШЄШ¤ЩѓШЇ Ш№Щ„Щ‰ ШЈЩ‡Щ…ЩЉШ© Ш§Щ„ШЇЩ€Ш± Ш§Щ„Ш°ЩЉ ЩЉЩ…ЩѓЩ† ШЈЩ† ШЄЩ‚Щ€Щ… ШЁЩ‡ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ЩЉЩЉШ± Ш§Щ„Ш®Щ„Щ‚ЩЉШ© Щ„Щ„Ш·ЩЃЩ„ Щ€Ш§Щ„ШЄЩЉ ЩЉШіШЄШ®ШЇЩ…Щ‡Ш§ ЩЃЩЉ ШЩѓЩ…Ш© Ш№Щ„Щ‰ Ш§Щ„Щ…Щ€Ш§Щ‚ЩЃ Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉШ© Ш§Щ„Щ…Ш®ШЄЩ„ЩЃШ© ЩЃЩЉ ШЄЩѓЩ€ЩЉЩ† ШґШ®ШµЩЉШЄЩ‡ Щ€ЩЃЩЉ ШЩЉШ§ШЄЩ‡ Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉШ© Щ€Щ†Щ…Щ€Щ‡ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш±ЩЃЩЉ. (Ш§Щ„Ш№Щ†Ш§Щ†ЩЉШЊ 2011ШЊ:48)ШЁЩЉЩ†Щ…Ш§ ШЄШ±Щ‰ Щ†ШёШ±ЩЉШ© Ш§Щ„ШЄШ№Щ„Щ… Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉ (Ш§Щ„ШЁШ±ШЄ ШЁЩ†ШЇЩ€Ш±Ш§) Ш¶Ш±Щ€Ш±Ш© ШЈЩ† ЩЉЩ‚Щ€Щ… Ш§Щ„ШЈЩ‡Щ„ ШЁШЄЩ€ЩЃЩЉШ± Щ†Щ…Ш§Ш°Ш¬ ШҐЩЉШ¬Ш§ШЁЩЉШ© Щ„ШЈШЁЩ†Ш§Ш¦Щ‡Щ… Щ…Щ† ШЈШ¬Щ„ ШЄЩ‚Щ„ЩЉШЇЩ‡Ш§. Щ€ЩЉШ±ЩЉ Ш§Щ„ШЁШ±ШЄ ШЁЩ†ШЇЩ€Ш±Ш§ ШЈЩ† Ш§Щ„ШҐЩ†ШіШ§Щ† ЩѓШ§Ш¦Щ† Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉ ЩЉШ№ЩЉШґ Ш¶Щ…Щ† Щ…Ш¬Щ…Щ€Ш№Ш§ШЄ Щ…Щ† Ш§Щ„ШЈЩЃШ±Ш§ШЇ ЩЉШЄЩЃШ§Ш№Щ„ Щ…Ш№Щ‡Ш§ Щ€ЩЉШ¤Ш«Ш± Щ€ЩЉШЄШЈШ«Ш± ЩЃЩЉЩ‡Ш§ШЊ Щ€ШЁШ°Щ„Щѓ ЩЃЩ‡Щ€ ЩЉЩ„Ш§ШШё ШіЩ„Щ€ЩѓЩЉШ§ШЄ Щ€Ш№Ш§ШЇШ§ШЄ Щ€Ш§ШЄШ¬Ш§Щ‡Ш§ШЄ Ш§Щ„ШЈЩЃШ±Ш§ШЇ Ш§Щ„ШўШ®Ш±ЩЉЩ† Щ€ЩЉШ№Щ…Щ„ Ш№Щ„Щ‰ ШЄШ№Щ„Щ…Щ‡Ш§ Щ…Щ† Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§ШШёШ© Щ€Ш§Щ„ШЄЩ‚Щ„ЩЉШЇ. (Ш§Щ„ШЩ…Щ€Ш±ЩЉШЊ Щ€ШўШ®Ш±Щ€Щ† ШЊ2015ШЊ258:257). Щ€ШЈШ®ЩЉШ±Ш§ ЩЉШ±Щ‰ ЩѓЩ€Щ„ШЁШ±Ш¬ ЩЃЩЉ Щ†ШёШ±ЩЉШ© Ш§Щ„Щ†Щ…Щ€ Ш§Щ„Ш®Щ„Щ‚ЩЉ ШЈЩ† Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ Щ„Щ‡Щ… ШЈШ®Щ„Ш§Щ‚ЩЉШ§ШЄ Ш®Ш§ШµШ© ШЩЉШ« ШҐЩ†Щ‡Щ… Щ„Ш§ ЩЉШЄЩѓЩЉЩЃЩ€Щ† ЩЃЩ‚Ш· Щ„Щ‚Щ€Ш§Ш№ШЇ Ш«Щ‚Ш§ЩЃШ§ШЄЩ‡Щ… Щ€Щ„ЩѓЩ†Щ‡Щ… ЩЉШЄЩѓЩЉЩЃЩ€Щ† Щ€ЩЃЩ‚Ш§ Щ„ШўШ±Ш§Ш¦Щ‡Щ… Ш§Щ„Ш®Ш§ШµШ© Ш§Щ„ШЄЩЉ ШЄШЄЩѓЩ€Щ† Щ…Щ† Ш®Щ„Ш§Щ„ ШЄЩЃЩѓЩЉШ±Щ‡Щ… Ш§Щ„Ш®Щ„Щ‚ЩЉ. (Ш§ШЁЩ€Ш¬Ш§ШЇЩ€ШЊ2015ШЊ125:124)Щ€Ш№Щ„Щ‰ Ш§Щ„Щ…ШіШЄЩ€ЩЉЩЉЩ† Ш§Щ„Ш«Щ‚Ш§ЩЃЩЉ Щ€Ш§Щ„ШЇЩЉЩ†ЩЉ Щ„Щ…Ш¬ШЄЩ…Ш№Ш§ШЄЩ†Ш§ Ш§Щ„Ш№Ш±ШЁЩЉШ© Щ†Ш¬ШЇ Ш§ШіШЄШ№Щ…Ш§Щ„ Ш§Щ„Щ‚Ш±ШўЩ† Ш§Щ„Щ‚ШµШ© Ш§ШіШЄШ®ШЇШ§Щ…Ш§ Щ€Ш§ШіШ№Ш§ ЩЃЩЉ ШЄШ«ШЁЩЉШЄ Ш§Щ„Щ‚ЩЉЩ… Ш§Щ„ШҐЩЉЩ…Ш§Щ†ЩЉШ© Щ€ШЄШ±ШіЩЉШ®Щ‡Ш§ ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ†ЩЃЩ€Ші. Щ€Ш§ШіШЄЩЏШ№Щ…Щ„ЩЋ Ш§Щ„ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉ ЩЃЩЉ ШЈШШ§ШЇЩЉШ« Ш§Щ„Щ†ШЁЩЉ ШµЩ„Щ‰ Ш§Щ„Щ„Щ‡ Ш№Щ„ЩЉЩ‡ Щ€ШіЩ„Щ…ШЊ ЩѓЩ€Щ†Щ‡ ШЈШЁЩ„Шє Ш§Щ„Ш·Ш±Щ‚ Щ„ШЄЩ€Ш«ЩЉЩ‚ Ш§Щ„ЩЃЩѓШ±Ш©ШЊ Щ€ШҐШµШ§ШЁШ© Ш§Щ„Щ‡ШЇЩЃ Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩ€ЩЉШЊ Щ†ШёШ±Ш§Щ‹ Щ„Щ…Ш§ ЩЃЩЉЩ‡ Щ…Щ† ШЄШЇШ±Ш¬ ЩЃЩЉ ШіШ±ШЇ Ш§Щ„ШЈШ®ШЁШ§Ш±ШЊ Щ€ШЄШґЩ€ЩЉЩ‚ ЩЃЩЉ Ш§Щ„Ш№Ш±Ш¶ШЊ Щ€Ш·Ш±Ш Щ„Щ„ШЈЩЃЩѓШ§Ш±ШЊ ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ† Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ШЄШµШЇШ± Щ…Щ‚ШЄШ±Щ†Ш© ШЁШ§Щ„ШІЩ…Ш§Щ† Щ€Ш§Щ„Щ…ЩѓШ§Щ†ШЊ Ш§Щ„Щ„Ш°ЩЉЩ† ЩЉШєЩ„ЩЃШ§Щ† Ш§Щ„ШЈШШЇШ§Ш« ШЁШҐШ·Ш§Ш± ЩЉЩ…Щ†Ш№ Ш§Щ„Ш°Щ‡Щ† Щ…Щ† Ш§Щ„ШЄШґШЄШЄ Щ€Ш±Ш§ШЎ Ш§Щ„ШЈШШЇШ§Ш«. (ШЈШЩ…ШЇ ЩЃШ±ЩЉШЇ: Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩЉШ© Ш№Щ„Щ‰ Щ…Щ†Щ‡Ш¬ ШЈЩ‡Щ„ Ш§Щ„ШіЩ†Ш© Щ€Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш©ШЊ Шµ:266 ШЁШЄШµШ±ЩЃ).Щ€ЩЉШЄЩ…Ш«Щ‘Щ„ ШЈШ«Ш± Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ЩЃЩЉ Щ†ЩЃШі Ш§Щ„Щ…ШЄЩ„Щ‚Щ‘ЩЉ ЩЃЩЉ Щ…Ш¬Щ…Щ€Ш№Ш© Щ…Щ† Ш§Щ„Ш§ШЄШ¬Ш§Щ‡Ш§ШЄШЊ Щ…Щ†Щ‡Ш§ Ш§Щ„Щ…ШґШ§Ш±ЩѓШ© Ш§Щ„Щ€Ш¬ШЇШ§Щ†ЩЉШ©ШЊ ШЩЉШ« ЩЉШґШ§Ш±Щѓ Ш§Щ„ШЈШЁЩ†Ш§ШЎ ШЈШЁШ·Ш§Щ„ Ш§Щ„Щ‚ШµШ© Щ…ШґШ§Ш№Ш±Щ‡Щ… Щ€Ш§Щ†ЩЃШ№Ш§Щ„Ш§ШЄЩ‡Щ…ШЊ ЩЃЩЉЩЃШ±ШЩ€Щ† Щ„ЩЃШ±ШЩ‡Щ…ШЊ Щ€ЩЉШШІЩ†Щ€Щ† Щ„ШШІЩ†Щ‡Щ…ШЊ Щ€ЩѓШЈЩ†Щ‘ ШЈШШЇШ§Ш« Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ШЄШШЇШ« Ш§Щ„ШўЩ†. ШҐШ¶Ш§ЩЃШ© ШҐЩ„Щ‰ Ш§Щ„ШЄЩ‚Щ…Щ‘Шµ Щ€Ш§Щ„Щ…Щ‚Ш§Ш±Щ†Ш©ШЊ ШҐШ° ШЈЩ† ШіШ§Щ…Ш№ Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ЩЉШ¶Ш№ Щ†ЩЃШіЩ‡ Щ…Щ€Ш¶Ш№ ШЈШґШ®Ш§Шµ Ш§Щ„Щ‚ШµШ©ШЊ Щ€ЩЉШёЩ„ Ш·ЩЉЩ„Ш© Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ЩЉШ№Щ‚ШЇ Щ…Щ‚Ш§Ш±Щ†Ш© Ш®ЩЃЩЉШ© ШЁЩЉЩ†Щ‡ Щ€ШЁЩЉЩ†Щ‡Щ…. ЩЃШҐЩ† ЩѓШ§Щ†Щ€Ш§ ЩЃЩЉ Щ…Щ€Щ‚ЩЃ Ш§Щ„ШЁШ·Щ€Щ„Ш© Щ€Ш§Щ„Ш±ЩЃШ№Ш© Щ€Ш§Щ„ШЄЩ…ЩЉШІШЊ ШЄЩ…Щ†Щ‘Щ‰ Щ„Щ€ ЩѓШ§Щ† ЩЃЩЉ Щ…Щ€Щ‚ЩЃЩ‡Щ… Щ€ЩЉШµЩ†Ш№ Щ…Ш«Щ„ ШµЩ†ЩЉШ№Щ‡Щ… Ш§Щ„ШЁШ·Щ€Щ„ЩЉШЊ Щ€ШҐЩ† ЩѓШ§Щ†Щ€Ш§ ЩЃЩЉ Щ…Щ€Щ‚ЩЃ ЩЉШ«ЩЉШ± Ш§Щ„Ш§ШІШЇШ±Ш§ШЎ Щ€Ш§Щ„ЩѓШ±Ш§Щ‡ЩЉШ© ШЩ…ШЇ Щ„Щ†ЩЃШіЩ‡ ШЈЩ†Щ‡ Щ„ЩЉШі ЩѓШ°Щ„Щѓ. Щ€Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ШЄШЄЩЉШ Щ„Щ„ШЈШЁЩ†Ш§ШЎ ШҐЩ…ЩѓШ§Щ†Ш§ШЄ Ш§Щ„ЩЃЩ‡Щ… Ш§Щ„Щ…ШЄШ№ШЇШЇШ©ШЊ Щ€ШЄШЄШ±Щѓ ШЈЩ…Ш§Щ…Щ‡Щ… Ш§Щ„Щ…Ш¬Ш§Щ„ Щ€Ш§ШіШ№Ш§Щ‹ Щ„Щ„Ш§ШіШЄЩ†ШЄШ§Ш¬ Щ€Ш§Щ„Ш§ШіШЄШ®Щ„Ш§Шµ.Щ€ЩЃЩЉ Ш§ШіШЄШ№Ш±Ш§Ш¶ЩЉ Щ„ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШЩ‚Ш§Ш¦Щ‚ ШЈШ¤ЩѓШЇ Ш№Щ„Щ‰ Щ…Ш¬Щ…Щ€Ш№Ш© Щ…Щ†Щ‡Ш§ШЊ ШЩЉШ« Щ†Ш§ШґШЇ ШЈШ·ШЁШ§ШЎ Щ†ЩЃШі Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ Щ…Ш¤Ш®Ш±Ш§Щ‹ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ‡Ш§ШЄ ШЁШ¶Ш±Щ€Ш±Ш© Ш§Щ„Ш№Щ€ШЇШ© Щ„ШШЇЩ€ШЄШ© Щ‚ШЁЩ„ Ш§Щ„Щ†Щ€Щ… Ш§Щ„ШЄЩЉ ШЄШ±Щ€ЩЉЩ‡Ш§ Ш§Щ„ШЈЩ… ШЈЩ€ Ш§Щ„Ш¬ШЇШ© ШЁШµЩ€ШЄЩ‡Ш§ Ш§Щ„ШЩ†Щ€Щ†ШЊ ШЁШЇЩ„Ш§Щ‹ Щ…Щ† Ш§Щ„Ш§Ш№ШЄЩ…Ш§ШЇ Ш§Щ„ЩѓЩ„ЩЉ Ш№Щ„Щ‰ Щ…Ш§ ШЄШ№Ш±Ш¶Щ‡ ШЈШ¬Щ‡ШІШ© Ш§Щ„ШЄЩ„ЩЃШІЩЉЩ€Щ† Щ€ШЈШґШ±Ш·Ш© Ш§Щ„ЩЃЩЉШЇЩЉЩ€Ш› Щ„ШЈЩ†Щ‘ Щ€Ш¬Щ€ШЇ Ш§Щ„ШЈЩ… ШҐЩ„Щ‰ Ш¬Щ€Ш§Ш± Ш§ШЁЩ†Щ‡Ш§ Щ‚ШЁЩ„ Щ†Щ€Щ…Щ‡ ЩЉШІЩЉШЇ Щ…Щ† Ш§Ш±ШЄШЁШ§Ш·Щ‡ ШЁЩ‡Ш§ШЊ Щ€ЩЉШЁШ«Щ‘ ЩЃЩЉ Щ†ЩЃШіЩ‡ Щ‚ШЇШ±Ш§Щ‹ ЩѓШЁЩЉШ±Ш§Щ‹ Щ…Щ† Ш§Щ„Ш·Щ…ШЈЩ†ЩЉЩ†Ш©ШЊ Щ€ЩЉШ¬Щ†Щ‘ШЁЩ‡ ШЈЩЉЩ‘ Щ†Щ€Ш№ Щ…Щ† Ш§Щ„Щ…Ш®Ш§Щ€ЩЃ ШЈЩ€ Ш§Щ„Щ‚Щ„Щ‚ШЊ Щ€ЩЉЩ…Щ†Ш№ Ш№Щ†Щ‡ Ш§Щ„ШЈШЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Щ…ЩЃШІШ№Ш© ШЈЩ€ Ш§Щ„ЩѓЩ€Ш§ШЁЩЉШі ЩЃЩЉ ШЈШ«Щ†Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ†Щ€Щ…. ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ† Щ€Ш¬Щ€ШЇ Ш§Щ„ШЈЩ… ШҐЩ„Щ‰ Ш¬Щ€Ш§Ш± Ш§ШЁЩ†Щ‡Ш§ Щ‚ШЁЩ„ Щ†Щ€Щ…Щ‡ ЩЉШІЩЉШЇ Щ…Щ† Ш§Ш±ШЄШЁШ§Ш·Щ‡ ШЁЩ‡Ш§ШЊ Щ€ЩЉШЁШ«Щ‘ ЩЃЩЉ Щ†ЩЃШіЩ‡ Щ‚ШЇШ±Ш§Щ‹ ЩѓШЁЩЉШ±Ш§Щ‹ Щ…Щ† Ш§Щ„Ш·Щ…ШЈЩ†ЩЉЩ†Ш©ШЊ Щ€ЩЉШ¬Щ†Щ‘ШЁЩ‡ ШЈЩЉЩ‘ Щ†Щ€Ш№ Щ…Щ† Ш§Щ„Щ…Ш®Ш§Щ€ЩЃ ШЈЩ€ Ш§Щ„Щ‚Щ„Щ‚ШЊ Щ€ЩЉЩ…Щ†Ш№ Ш№Щ†Щ‡ Ш§Щ„ШЈШЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Щ…ЩЃШІШ№Ш© ШЈЩ€ Ш§Щ„ЩѓЩ€Ш§ШЁЩЉШі ЩЃЩЉ ШЈШ«Щ†Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ†Щ€Щ… .ЩѓЩ…Ш§ Ш·Ш§Щ„ШЁ Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩ€ЩЉЩ€Щ† ШЁШ°Щ„Щѓ Щ„ШЈЩ†Щ‘ ШіШ±ШЇ Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ШЈЩ€ Ш§Щ„ШШЇЩ€ШЄШ© Ш№Щ„Щ‰ Щ…ШіШ§Щ…Ш№ Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ Щ‚ШЁЩЉЩ„ Щ†Щ€Щ…Щ‡ Щ„Щ‡ ШЈЩ‡Щ…ЩЉШ© Ш®Ш§ШµШ©Ш› ЩѓЩ€Щ† ШЈШШЇШ§Ш«Щ‡Ш§ ШЄШ®ШЄЩ…Ш± ЩЃЩЉ Ш№Щ‚Щ„Щ‡ Щ€ ШЄШ«ШЁШЄ ЩЃЩЉ Щ…Ш±ЩѓШІ Ш§Щ„Ш°Ш§ЩѓШ±Ш© ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ…Ш® ЩЃЩЉ ШЈШ«Щ†Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ†Щ€Щ… ЩЃШЄШёЩ„ Ш±Ш§ШіШ®Ш© ЩЃЩЉ Ш°Ш§ЩѓШ±ШЄЩ‡ШЊ Щ€ЩЉШµШ№ШЁ Ш№Щ„ЩЉЩ‡ Щ†ШіЩЉШ§Щ†Щ‡Ш§ШЊ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш± Ш§Щ„Ш°ЩЉ ЩЉШ¬Ш№Щ„ Щ…Щ†Щ‡Ш§ Щ€ШіЩЉЩ„Ш© Ш±Ш§Ш¦Ш№Ш© Щ€Щ…Ш«Щ…Ш±Ш© Щ…Щ† Щ€ШіШ§Ш¦Щ„ Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩЉШ©ШЊ ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ† ШіШ±ШЇ ШЈШ®ШЁШ§Ш± Ш§Щ„Ш№Щ„Щ…Ш§ШЎ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ…Щ„ЩЉЩ† Щ€Ш§Щ„Щ†ШЁЩ‡Ш§ШЎ Ш§Щ„ШµШ§Щ„ШЩЉЩ† ЩЂ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШЄШ±ЩѓЩЉШІ Ш№Щ„Щ‰ ЩЃШЄШ±Ш§ШЄ Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ€Щ„Ш© ЩЃЩЉ ШЩЉШ§ШЄЩ‡Щ… ЩЂ Щ…Щ† Ш®ЩЉШ± Ш§Щ„Щ€ШіШ§Ш¦Щ„ Ш§Щ„ШЄЩЉ ШЄШєШ±Ші Ш§Щ„ЩЃШ¶Ш§Ш¦Щ„ ЩЃЩЉ Ш§Щ„Щ†ЩЃЩ€ШіШЊ Щ€ШЄШЇЩЃШ№Щ‡Ш§ ШҐЩ„Щ‰ ШЄШЩ…Щ„ Ш§Щ„ШґШЇШ§Ш¦ШЇ Щ€Ш§Щ„Щ…ЩѓШ§Ш±Щ‡ ЩЃЩЉ ШіШЁЩЉЩ„ Ш§Щ„ШєШ§ЩЉШ§ШЄ Ш§Щ„Щ†ШЁЩЉЩ„Ш© Щ€Ш§Щ„Щ…Щ‚Ш§ШµШЇ Ш§Щ„Ш¬Щ„ЩЉЩ„Ш©ШЊ Щ€ШЄШЁШ№Ш« ЩЃЩЉЩ‡Ш§ Ш§Щ„ШіЩ…Щ€ ШҐЩ„Щ‰ ШЈШ№Щ„Щ‰ Ш§Щ„ШЇШ±Ш¬Ш§ШЄ Щ€ШЈШґШ±ЩЃ Ш§Щ„Щ…Щ‚Ш§Щ…Ш§ШЄ.Щ€Щ‚ШЇ ШЈШЇШ±ЩѓШЄ Щ€ШІШ§Ш±Ш© Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩЉШ© Щ€Ш§Щ„ШЄШ№Щ„ЩЉЩ… ШЈЩ‡Щ…ЩЉШ© Ш§Щ„ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉШ› ЩЃШЈШЇШ®Щ„ШЄЩ‡ ЩЃЩЉ Ш№ШЇЩЉШЇ Щ…Щ† ЩѓШЄШЁ Ш§Щ„Щ…Ш±ШЩ„Ш© Ш§Щ„ШЈШіШ§ШіЩЉШ©ШЊ Щ€Ш®Ш§ШµШ© ЩѓШЄШЁ Ш§Щ„Щ„ШєШ© Ш§Щ„Ш№Ш±ШЁЩЉШ© Щ€Ш§Щ„ШЄШ±ШЁЩЉШ© Ш§Щ„ШҐШіЩ„Ш§Щ…ЩЉШ©Ш› Щ„ШЈЩ†Щ‘Щ‡ ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Щ€Щ€ШіЩЉЩ„Ш© Щ…Щ† Ш§Щ„Щ€ШіШ§Ш¦Щ„ Ш°Ш§ШЄ Ш§Щ„ШЈШ«Ш± Ш§Щ„Щ…Щ„Щ…Щ€ШіШЊ Щ€ЩЉШЄЩ…Ш§ШґЩ‰ Щ…Ш№ ЩЃЩ„ШіЩЃШ© Ш§Щ„ШЄШ№Щ„ЩЉЩ… Ш§Щ„ШЈШіШ§ШіЩЉ Ш§Щ„Ш°ЩЉ ЩЉШЈШ®Ш° Ш№Щ„Щ‰ Ш№Ш§ШЄЩ‚Щ‡ ШЈЩ† Ш§Щ„Ш·Ш§Щ„ШЁ Щ…ШЩ€Ш± Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ЩЉШ© Ш§Щ„ШЄШ№Щ„ЩЉЩ…ЩЉШ©ШЊ Щ€Ш±ЩѓЩЉШІШ© Щ„Щ„ШЄШ№Щ„ЩЉЩ… Щ€Щ„Щ„ШЄШ№Щ„Щ‘Щ… .Щ€ЩЉШ№ШЇЩ‘ Ш§Щ„Ш№Ш±Ш¶ Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉ ШЈШШЇ Ш§Щ„ШЈШіШ§Щ„ЩЉШЁ Ш°Ш§ШЄ Ш§Щ„ШЈЩ‡Щ…ЩЉШ© Ш§Щ„ЩѓШЁЩЉШ±Ш© ЩЃЩЉ Щ…Ш®Ш§Ш·ШЁШ© Щ€Ш¬ШЇШ§Щ† Ш§Щ„Ш·Ш§Щ„ШЁ Щ€Ш№Щ‚Щ„Щ‡ Щ…Ш№Ш§Щ‹. ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ† Ш§Щ„Ш±Щ€Ш§ЩЉШ© Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉШ© ШЄЩЏШШЇШ« ШЄЩ†Щ€Щ‘Ш№Ш§Щ‹ Щ…Ш№Ш±ЩЃЩЉШ§Щ‹ Щ„ШЇЩ‰ Ш§Щ„Ш·Щ„ШЁШ© Щ…Щ† Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ШЈЩЃЩѓШ§Ш± Щ€Ш§Щ„ШЩ€Ш§ШЇШ« Щ€Щ…Ш§ ЩЉШЄШ®Щ„Щ„Щ‡Ш§ Щ…Щ† Ш№Щ…Щ„ЩЉШ§ШЄ Ш№Щ‚Щ„ЩЉШ© Щ„ШЇЩ‰ Ш§Щ„Ш·Щ„ШЁШ© ЩЃЩЉ Ш§Щ„Ш±ШЁШ· Щ€Ш§Щ„ШЄШЩ„ЩЉЩ„ Щ€Ш§Щ„ШЄЩЃШіЩЉШ± Щ€Ш§Щ„ШЄЩ‚Щ€ЩЉЩ… ШЊ Щ€ШєЩЉШ±Щ‡Ш§ Щ…Щ† Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ЩЉШ§ШЄ Ш§Щ„Ш№Щ‚Щ„ЩЉШ© Ш§Щ„ШЄЩЉ Щ‚ШЇ ЩЉШШЇШ«Щ‡Ш§ Ш§Щ„ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉ. ( ШЈШЁЩ€ Ш№Щ€ШЇШ©ШЊ 2004: 6).ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ†Щ‘ Ш§Щ„ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Ш§Щ„Щ‚ШµШµЩЉ ШЈШіЩ„Щ€ШЁ Щ…Щ‡Щ… Щ„Щ„ШЄЩ€Ш¶ЩЉШ Щ€ШҐШ«Ш§Ш±Ш© ШЇШ§ЩЃШ№ЩЉШ© Ш§Щ„Щ…ШЄШ№Щ„Щ…ЩЉЩ†ШЊ Щ€Ш№Ш§Щ…Щ„ Щ…Щ‡Щ… ЩЃЩЉ Щ†ШґШ± Ш§Щ„Ш§ШЄШ¬Ш§Щ‡Ш§ШЄШЊ Щ€ШЄШ№ШЇЩЉЩ„ Ш§Щ„ШіЩ„Щ€ЩѓШЊ Щ€Ш§Щ„ШЇШ№Щ€Ш© ШҐЩ„Щ‰ Ш§Щ„ШЄШЩ„Щ‘ЩЉ ШЁЩ…ЩѓШ§Ш±Щ… Ш§Щ„ШЈШ®Щ„Ш§Щ‚ШЊ Щ€ШЁШ®Ш§ШµШ© Щ„ШЇЩ‰ ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ Ш§Щ„Щ…Ш±ШЩ„Ш© Ш§Щ„ШЈШіШ§ШіЩЉШ©ШЊ Ш°Щ„Щѓ ШЈЩ†Щ‘ Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ ЩЉШШЁЩ€Щ† Ш§Щ„Ш§ШіШЄЩ…Ш§Ш№ ШҐЩ„Щ‰ Ш§Щ„Щ‚ШµШµ ШЇЩ€Щ† Щ…Щ„Щ„ШЊ Щ„ШЈЩ†Щ‡Ш§ ШЄШЄЩЃЩ‚ Щ…Ш№ Щ…Ш§ Щ„ШЇЩЉЩ‡Щ… Щ…Щ† Ш®ЩЉШ§Щ„ Щ€Ш§ШіШ№ШЊ ЩѓЩ…Ш§ ШЈЩ†Щ‘Щ‡Ш§ ШЄШіШ§Ш№ШЇ Ш№Щ„Щ‰ ШЄШ«ШЁЩЉШЄ Ш§Щ„Ш№Щ‚ЩЉШЇШ© ЩЃЩЉ Щ†ЩЃЩ€ШіЩ‡Щ…ШЊ Щ€Щ…Ш№Ш§ЩЉШґШ© Ш§Щ„Щ‚ЩЉЩ… Щ€Ш§Щ„ШЈШ®Щ„Ш§Щ‚ШЊ Щ€ШЄЩѓШ§Щ…Щ„ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш±ЩЃШ©. (Щ…ШЩ…Щ€ШЇШЊ 2004 :144).Щ€Щ…Щ…Ш§ ШЄЩ‚ШЇЩ‘Щ… Щ†Ш¬ШЇ ШЈЩ† Ш§Щ„Щ‚ШµШ© Щ…Щ‡Щ…Ш© Щ„Щ„Ш·ЩЃЩ„ ЩѓЩ€Щ†Щ‡Ш§ ШЄШЁШЇШЈ Щ…Щ† Ш§Щ„Щ€Ш§Щ‚Ш№ Ш§Щ„Ш°ЩЉ ЩЉШ№ЩЉШґЩ‡ Щ€ШЄЩ‚ШЄШ±ШЁ ШЁЩ‡ ШЄШЇШ±ЩЉШ¬ЩЉШ§ Щ…Щ† Ш№Ш§Щ„Щ… Ш§Щ„ЩѓШЁШ§Ш±ШЊ Щ€ШЄШ№Ш·ЩЉ Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ ШґШ№Щ€Ш±Ш§ Щ€Ш§Ш¶ШШ§ ШЁШ§Щ„Ш№Щ„Ш§Щ‚Ш© ШЁЩЉЩ† Ш®ШЁШ±Ш§ШЄЩ‡Щ… Ш§Щ„ШґШ®ШµЩЉШ© Щ€Ш®ШЁШ±Ш§ШЄ Ш§Щ„ШҐЩ†ШіШ§Щ†ЩЉШ© ЩѓЩ„Щ‡Ш§ШЊ Щ€Щ„Щ‡Ш§ ШЇЩ€Ш± ЩѓШЁЩЉШ± ЩЃЩЉ ШЄЩ†Щ…ЩЉШ© Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ Щ†Щ…Щ€Ш§ Щ…ШЄЩѓШ§Щ…Щ„Ш§ ЩЃЩЉ Ш¬Щ€Ш§Щ†ШЁ ШґШ®ШµЩЉШЄЩ‡ Ш§Щ„Ш¬ШіЩ…ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„Щ„ШєЩ€ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„Ш№Щ‚Щ„ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„Ш§Щ†ЩЃШ№Ш§Щ„ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉШ©ШЊ Щ€ШЄШІЩ€Щ‘ШЇ Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ ШЁЩ…Ш®ШЄЩ„ЩЃ Ш§Щ„Щ…ЩЃШ§Щ‡ЩЉЩ… Ш§Щ„Ш№Щ„Щ…ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉШ© Щ€Ш§Щ„ШШ±ЩѓЩЉШ© Щ€ШєЩЉШ±Щ‡Ш§ ШЁШ·Ш±ЩЉЩ‚Ш© ШіЩ‡Щ„Ш© Щ€Щ…ШґЩ€Щ‚Ш©ШЊ Щ€ШЄШіШ§Ш№ШЇ Ш§Щ„Ш·ЩЃЩ„ Ш№Щ„Щ‰ ШЄШ№Щ…ЩЉЩ‚ Щ€Ш№ЩЉЩ‡ ШЁШЄШ§Ш±ЩЉШ®Щ‡ Щ€ШЄШ±Ш§Ш«Щ‡ Ш§Щ„ШЇЩЉЩ†ЩЉ Щ€Ш§Щ„Щ‚Щ€Щ…ЩЉ Щ€Ш§Щ„Ш®Щ„Щ‚ЩЉШЊ Щ€Ш§Щ„Щ‚ШµШ© ШЁЩ…Ш§ ШЄШШЄЩ€ЩЉ Щ…Щ† Щ…Ш¶Щ…Щ€Щ† Ш®Щ„Щ‚ЩЉ Щ€Ш§Ш¬ШЄЩ…Ш§Ш№ЩЉ ШЄЩ€Ш¬Щ‡ Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ ШЄЩ€Ш¬ЩЉЩ‡Ш§ ШєЩЉШ± Щ…ШЁШ§ШґШ±ШЊ Щ€ШЄШіШ§Ш№ШЇЩ‡ Ш№Щ„Щ‰ ШЄЩ‚Ш±ЩЉШЁ Ш§Щ„Щ…ЩЃШ§Щ‡ЩЉЩ… Ш§Щ„Щ…Ш¬Ш±ШЇШ© Щ„Ш№Щ‚Щ„Щ‡. (ШіЩ„ЩЉЩ…ШЊ2005ШЊ44:43)Щ€ШЁЩ†Ш§ШЎ Ш№Щ„Щ‰ Щ…Ш§ ШіЩ„ЩЃШЊ Щ€ШЁШ§Щ„Щ†ШёШ± ШҐЩ„Щ‰ Щ†ШЄЩЉШ¬Ш© Ш§Щ„Ш§ШіШЄШ·Щ„Ш§Ш№ Ш§Щ„Ш°ЩЉ ШЈШ¬Ш±ЩЉЩ†Ш§Щ‡ Ш№Щ„Щ‰ Ш№ЩЉЩ†Ш© Щ…Щ† Ш§Щ„ШЈШ·ЩЃШ§Щ„ ШЄШЄШ±Ш§Щ€Ш ШЈШ№Щ…Ш§Ш±Щ‡Щ… ШЁЩЉЩ† 9-13 Ш№Ш§Щ…Ш§ШЊ ШЈЩѓШЇЩ‘ 96% Щ…Щ†Щ‡Щ… Ш±ШєШЁШЄЩ‡ ЩЃЩЉ ШЄШ№Щ„Щ‘Щ… Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ® ШЁЩ€ШіШ§Ш·Ш© Ш§Щ„Щ‚ШµШµ Ш§Щ„ШЈШЇШЁЩЉШ© Ш§Щ„ШЄШ§Ш±ЩЉШ®ЩЉШ© ШіЩ€Ш§ШЎ Ш§Щ„ШЄЩЉ ШЄШ№ШЄЩ…ШЇ Ш№Щ„Щ‰ Ш§Щ„ШіШ±ШЇ Ш§Щ„ШЈШЇШЁЩЉ Ш§Щ„Щ…ШЁШіЩ‘Ш·ШЊ ШЈЩ€ Ш§Щ„ШіШ±ШЇ Ш§Щ„Щ…Щ‚ШЄШ±Щ† ШЁШ±ШіЩ€Щ… ШЄЩ€Ш¶ЩЉШЩЉШ©. Щ€ЩЃШ§ШЎ Ш§Щ„ШґШ§Щ…ШіЩЉШ©