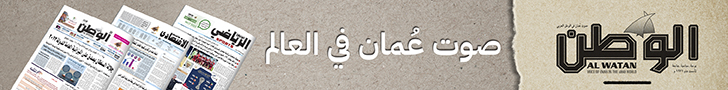ЩҠШ§ ШЈЩҮЩ„ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ Ш§Щ„Ш№ШұШЁ.. ШҘЩҶЩҮШ§ ШЈШұШ¶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁШҢ ЩҲШЁЩҠШҰШ© Ш«ЩӮШ§ЩҒШӘЩҮЩ… ЩҲШӘШұШЁШӘЩҮЩ… Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҶШЁШ° ШЁШ№Ш¶ЩҮЩ… ЩҒЩҠЩҮЩҠЩ…ЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү ЩҲШ¬ЩҲЩҮЩҮЩ…ШҢ ЩҲШӘШ°ШЁШӯ ШЁШ№Ш¶ЩҮЩ… ЩҒЩҠЩҶШёШұЩҲЩҶ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҜЩ… ШЁШ§ЩҶШӘШёШ§Шұ Ш§Щ„ШҜЩ….. ЩҲШӘЩӮЩҮШұ Щ…ЩҶ ШӘЩӮЩҮШұШҢ ЩҲШӘЩҮЩ…Шҙ Щ…ЩҶ ШӘЩҮЩ…ШҙШҢ ЩҒЩҠШәШҜЩҲ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш№ ШЁШ§ШӘШіШ§Ш№ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ… ЩҲЩ…ШҜЩү Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШөШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩғЩ„ ЩҠШЁШӯШ« Ш№ЩҶ ЩҶШөЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш№ШҜЩҲ Щ„ЩҮ ЩҲЩ„ШЈЩ…ШӘЩҮ ЩҲШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҮ ЩҲШҜЩҠЩҶЩҮ.. ЩҲЩҮЩҠ ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШЁЩҠШҰШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШЈШөШЁШӯШӘ ШӘШҜШ№Щ‘ЩҸ ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҮШ§ ЩҲЩ„ШіШ§ЩҶЩҮШ§.. ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШ№ЩҲШҜ ЩҒЩҠ Щ…ЩғЩҲЩҶШ§ШӘЩҮШ§ ЩҲШҘШұШ«ЩҮШ§ ШҘЩ„Щү ЩғЩ„ Щ…Ш§ ШӯЩҒШёШӘЩҮ Ш§Щ„ШЈШұШ¶ШҢ ЩҲШіШ¬Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩҲЩҲШ№ШӘЩҮ Ш§Щ„Ш°Ш§ЩғШұШ©.. Щ…ЩҶШ° Ш№ШҙШұШ© ШўЩ„Ш§ЩҒ ШіЩҶШ© ЩӮШЁЩ„ Ш§Щ„Щ…ЩҠЩ„Ш§ШҜ..[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/aliaklahersan.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]Ш№Щ„ЩҠ Ш№ЩӮЩ„Ш© Ш№ШұШіШ§ЩҶ[/author]"Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© Щ„ШіШ§ЩҶ"ШҢ ЩҮШ§ШӘШ§ЩҶ Ш§Щ„ЩғЩ„Щ…ШӘШ§ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩғШӘЩҶШІШӘШ§ЩҶ ШЁШ§Щ„ШҜЩ‘ЩҗЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘШҢ ШЈЩҲ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШӘЩ„Ш®ЩҠШө Ш§Щ„Щ…ЩҲШ¬ШІ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩӮШҜЩ… ЩҶШёШұШ© ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ© ШҙШ§Щ…Щ„Ш© Щ„Щ„Ш№Щ„Ш§ЩӮШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ…ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ© ЩҒЩҠ ШҘШ·Ш§Шұ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ….. ЩҠЩҺЩ„ЩӮЩү Ш§Ш№ШӘШұШ§Ш¶ЩӢШ§ Щ…ЩҶ ШЈШҙШ®Ш§Шө ЩҲШ¬ЩҮШ§ШӘШҢ ЩҲЩҠШӘШ¶Ш№Ш¶Ш№ Ш§ШұШӘЩғШ§ШІЩҮ Ш№Щ„Щү ШӯШҜЩҠШ«ШҢ ЩҠЩҸЩҶШіЩҺШЁ Щ„Щ„ШұШіЩҲЩ„ Щ…ШӯЩ…ШҜ ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ….. ШӯШҜЩҠШ« ЩҠЩҸШ¶ЩҺШ№Щ‘ЩҗЩҒЩҮ ШЈЩҮЩ„ЩҸ Ш§Щ„ШӯШҜЩҠШ«.. ШӯЩҠШ« ЩҠЩҸШ°ЩғЩҺШұ ШЈЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ЩҲШұШҜШҢ ШЁШҙШЈЩҶ Щ…Ш§ ШӘШ№ШұЩ‘ЩҺШ¶ Щ„ЩҮ ЩғЩ„ Щ…ЩҶ ШөЩҸЩҮЩҠШЁ Ш§Щ„ШұЩҲЩ…ЩҠШҢ ЩҲШіЩ„Щ…Ш§ЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШұШіЩҠШҢ ЩҲШЁЩ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ШӯШЁШҙЩҠШҢ ЩҲЩғЩ„ Щ…ЩҶЩҮЩ… Щ„ЩҠШі Щ…ЩҶ ШЈШөЩҲЩ„ Ш№ШұШЁЩҠШ©ШҢ Щ…ЩҶ ШҙШ®Шө ШӘЩҒШ§Ш®Шұ Ш№Щ„ЩҠЩҮЩ… ШЁШ№ШұЩҲШЁШӘЩҮ Ш§Щ„ШЈШөЩҠЩ„Ш©ШҢ ЩҒШ¬Ш§ШЎ ЩҶШө Ш§Щ„ШӯШҜЩҠШ« Ш§Щ„Щ…ЩҶШіЩҲШЁ Щ„Щ„ЩҶШЁЩҠЩ‘ "ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…": "ШЈЩҠЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші.. ШҘЩҶ Ш§Щ„ШұЩ‘ШЁ ЩҲШ§ШӯШҜШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШЁ ЩҲШ§ШӯШҜ. ЩҲЩ„ЩҠШіШӘ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© ШЁШЈШӯШҜЩғЩ… Щ…ЩҶ ШЈШЁ ЩҲЩ„Ш§ ШЈЩ…ШҢ ЩҲШҘЩҶЩ…Ш§ ЩҮЩҠ Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ЩҒЩ…ЩҶ ШӘЩғЩ„Щ… Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© ЩҒЩҮЩҲ Ш№ШұШЁЩҠ". ЩҲЩӮШҜ ЩҶЩҒЩү Ш§Щ„ШЈЩ„ШЁШ§ЩҶЩҠ ЩҶЩҒЩҠЩ‘ЩӢШ§ ШӘШ§Щ…Щ‘ЩӢШ§ ШЈЩҶ ЩҠЩғЩҲЩҶ ЩҮШ°Ш§ ШӯШҜЩҠШ«ЩӢШ§ Щ„Щ„ШұШіЩҲЩ„ "ШөЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩҲШіЩ„Щ…"ШҢ ЩҲЩ„Щ… ЩҠШұШҜ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШөШӯШ§Шӯ Щ„ШҜЩү Ш§Щ„ШЈШҰЩ…Ш© Ш§Щ„ШЈШұШЁШ№Ш©. Щ„ЩғЩҶ Щ…Ш¶Щ…ЩҲЩҶЩҮ ЩҲЩ…Ш§ Ш§ЩҶШ·ЩҲЩү Ш№Щ„ЩҠЩҮ Щ…ЩҶ Щ…ЩҒЩҮЩҲЩ…ШҢ ЩҠЩҶШіШ¬Щ… ЩҲШұЩҲШӯ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶ/Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ШҢ ЩҒЩҮЩҲ Щ…ЩӮШЁЩҲЩ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҘШ·Ш§Шұ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҲЩҸШ¶Ш№ ЩҒЩҠЩҮШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ШәШІЩү Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҸЩҒЩҮЩ… Щ…ЩҶЩҮ ЩҲЩҠЩӮШөШҜЩҮ Щ…ШіШӘШ®ШҜЩ…ЩҲЩҮ. ШҘШ° ЩҠШұЩҒШ№ Ш§Щ„Ш§ЩҶШӘЩ…Ш§ШЎ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ШҢ ШҘЩ„Щү ШҜШұШ¬Ш© Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠ ЩҲШ§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„ШіЩ…ЩҲЩ‘ Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШ®ЩҲШ© Ш§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ©.. ЩҲЩ„Ш§ ЩҠШӯШөШұЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШіЩ„Ш§Щ„Ш© Ш§Щ„Щ…ШЁЩҶЩҠШ© Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш№ШөШЁЩҠШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШҜЩ…ШҢ ЩҲШ§Щ„Ш№ШұЩӮШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҗЩ„Щ‘ЩҺШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„Ш¬ЩҶШі.ЩҲШ§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ЩҒЩҠ Ш§Ш¬ШӘЩҮШ§ШҜШҢ ШЈЩҲШіШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ„ШәШ©ШҢ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩғШ«ЩҒ Щ…ЩӮЩҲЩ…Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҮЩҸЩҲЩҠЩ‘Ш©ШҢ ЩҲШЈШЁШ№Ш§ШҜ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„ШҙШ®ШөЩҠШ© Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШ© - Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠШ© Щ„ШЈЩ…Ш©ШҢ ЩҲШӘШӯЩ…Щ„ ЩғЩ„ Ш°Щ„Щғ ЩҲШӘШӯЩҒШёЩҮШҢ ЩҲШӘЩҶЩ…ЩҠЩҮШҢ ЩҲШӘШӘЩҮШ§ШҜЩү ШЁЩҮ Щ…ЩҶ Ш¬ЩҠЩ„ ШҘЩ„Щү Ш¬ЩҠЩ„ШҢ ЩҒЩҠ ШЈЩ…Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ…ШҢ Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШЈШІЩ…ЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…ЩғЩҶШ©ШҢ Щ„ЩҠЩғЩҲЩҶ ЩҲШ№ЩҠЩӢШ§ Щ„Щ„Ш°Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ЩғЩҠЩҶЩҲЩҶШ©. ЩҲШ§ЩҶШ·Щ„Ш§ЩӮЩӢШ§ Щ…ЩҶ Ш°Щ„ЩғШҢ ЩҒШҘЩҶ Щ…ЩҶ ЩҠЩ…Щ„Щғ Ш§Щ„Щ„ШәШ© Ш§Щ…ШӘЩ„Ш§Щғ ШӘЩғЩҲЩҠЩҶШҢ ЩҲШіЩҠЩҲЩ„Ш© Ш№Ш¶ЩҲЩҠШ© Ш№Щ…ЩҠЩӮШ© Ш§Щ„ШӘЩҒШ§Ш№Щ„ ЩҲШ§Щ„ЩҒШ§Ш№Щ„ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҠШ№ЩҠШҙ ЩҒЩҠ ШЁЩҠШҰШӘЩҮШ§ШҢ ЩҲЩ„Ш§ ЩҠШұЩү ШәЩҠШұ Щ…ШЁЩҶШ§ЩҮШ§ ЩҲЩ…ШӯШӘЩҲШ§ЩҮШ§ ЩҲЩ…Ш¬Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШ§ Ш§Щ„ШӯЩҠЩҲЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш№Щ…Щ„ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҠШӘШ№Ш§Щ…Щ„ ШЁЩҮШ§ ШЈШіШ§ШіЩӢШ§ШҢ ЩҲШЁЩ…Ш§ ШӘШӯЩ…Щ„ЩҮ Щ…ЩҶ Щ…Ш№Ш§ШұЩҒ ЩҲЩ…Ш№Ш§ЩҶЩҚ ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘ ЩҲЩӮЩҠЩ…ШҢ ЩҒЩҮЩҲ Щ…ЩҶЩҮШ§ ЩҲШҘЩ„ЩҠЩҮШ§ШҢ ЩҠЩҶШӘЩ…ЩҠ Ш§ЩҶШӘЩ…Ш§ШЎ Ш№Ш¶ЩҲЩҠЩ‘ЩӢШ§ШҢ ШЁШөЩҒШ© ШЈЩғШ«Шұ ЩҲШЈЩҲШіШ№ ЩҲШЈШ№Щ…ЩӮ Щ…ЩҶ: Щ…ШіШӘШ№ШұЩҗШЁШҢ ШЈЩҲ Щ…ШіШӘШҙШұЩҗЩӮШҢ ШЈЩҲ.. ШЈЩҲ.. ЩҒЩҠЩғЩҲЩҶ Ш§ЩҶШӘЩ…Ш§ШӨЩҮ Ш°Ш§Щғ Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ШЈЩҲ Щ…Ш§ ЩҮЩҲ ЩҒЩҠ ШӯЩғЩ… Щ…ЩҶ ЩҠШӯЩ…Щ„ЩҲЩҶ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ЩҲЩ„ЩҠШі Щ…Ш¬ШұЩ‘ЩҺШҜ Ш§Щ„ШҙЩ‘ЩҺЩҒШ©ЩҺШҢ ЩғЩ…Ш§ ЩӮЩҠЩ„ "ШҙЩҺЩҒЩҺШ©ЩҺ ЩғЩҶШ№Ш§ЩҶШҢ Щ…Ш«Щ„ЩӢШ§". ЩҲШӯЩҠЩҶ ШӘЩғЩҲЩҶ Ш§Щ„Щ„ШәШ© Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ©ШҢ ЩҮЩҠ Щ„ШәШ© Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶШҢ ЩҲШ§Щ„ШӯШҜЩҠШ«ШҢ ЩҒШҘЩҶ Ш§Щ„Щ…ШіЩ„Щ… ЩҠШұЩү ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩҶЩҒШіЩҮШҢ ЩҲЩҠШұШ§ЩҮШ§ Щ„ЩҶЩҒШіЩҮШҢ ЩҒЩҠ ШӘЩғЩҲЩҠЩҶЩҮ Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШҢ ЩҲШӘШөШЁШӯ Щ…ЩҶ Щ…ЩӮЩҲЩ…Ш§ШӘ ЩҒЩӮЩҮЩҮ ЩҲЩҒЩҮЩ…ЩҮ Ш§Щ„Ш№Щ…ЩҠЩӮЩҠЩҶ Щ„Щ„ШҜЩҠЩҶШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Щ…ШҜШ§Ш®Щ„ЩҮ Щ„ШҘЩҠЩ…Ш§ЩҶ ЩҠШ№ШІШІЩҮ ЩҠЩӮЩҠЩҶ.. ЩҒЩҮЩҲ "Ш№Ш§ШұШЁЩҢ" ШЁЩ…Ш§ ЩҠШіЩ…ЩҲ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш¶ШұЩҲШұШ© ЩҲШ§Щ„ШӯШ§Ш¬Ш©ШҢ ШЈЩҠ ШЁШ§Щ„ШҘЩҠЩ…Ш§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШұШәШЁШ© ЩҒЩҠ ЩҒЩҮЩ… ШЈШөЩҲЩ„ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶ ШЁЩ„ШіШ§ЩҶ ЩҒЩҠЩҮ ШЈЩғШ«Шұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЁЩҠШ§ЩҶШҢ ЩҮЩҲ ШЈШӯШҜ ШЈЩҮЩ… Щ…ЩӮЩҲЩ…Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҮЩҲЩҠШ©. ЩҲЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„Ш© ЩҠЩҶШІШ§Шӯ Ш§Щ„Щ…ЩҒЩҮЩҲЩ… Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ…ЩҠ Ш§Щ„Ш¶ЩҠЩӮ Щ„Щ„Ш№ШұЩҲШЁШ©ШҢ Щ„ЩҠШөШЁШӯ "Ш§Щ„Ш№ШұЩҲШЁШ© Щ„ШіШ§ЩҶ"ШҢ ШЈЩҠ Щ…Ш§ ЩҮЩҲ ШЈЩҲШіШ№ ЩҲШЈШҙЩ…Щ„ ЩҲШЈШ№Щ„Щү Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШөЩ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҶШӘЩ…Ш§ШЎШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҰЩ…Ш© Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш№ШөШЁЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Ш§Щ„ЩҠШ© ЩҲШөЩ„Ш§ШӘ Ш§Щ„ШҜЩ…ШҢ ШҘЩҶЩҮ Щ„Ш§ ЩҠЩ„ШәЩҠ Ш°Щ„Щғ ЩҲЩ„Ш§ ЩҠШ¬ШӘШ«Щ‘ЩҸЩҮШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶЩҮ ЩҠШіЩ…ЩҲ ШЁЩҮ Щ„ЩҠШӯШӘЩ„ Щ…ЩғШ§ЩҶШ© ШұЩҲШӯЩҠШ© - Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШ© - ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ©ШҢ ШӘШӘЩ…Ш§ЩҮЩү Щ…Ш№ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҲШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҜЩҠЩҶШҢ ЩҲЩ…Ш№ Ш§Щ„ШҙШұШ· Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠ ЩҲШ§Щ„Щ…ШөЩҠШұ Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҒЩҠЩғЩҲЩҶ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШҙШ¬ШұШ© Ш§Щ„ШЁШҙШұЩҠШ© Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„Ш§ЩӮШ©ШҢ Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҒШұЩҲШ№ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ…ЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҶЩ…ЩҲ ЩҲШӘШіШӘЩ…ШҜ ЩҶЩҺШіЩҺШәЩҺ Ш§Щ„ШӯЩҠШ§Ш©ШҢ Щ…ЩҶ Ш¬Ш°ЩҲШұ Ш№Щ…ЩҠЩӮШ© ШұШ§ШіШ®Ш©ШҢ ШӘШӯШӘ Щ…ШёЩ„Ш© ШұЩҲШӯЩҠШ© ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ© ШЈШ№Щ„Щү.. пҙҝЩҠЩҺШ§ ШЈЩҺЩҠЩ‘ЩҸЩҮЩҺШ§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҺШ§ШіЩҸ ШҘЩҗЩҶЩ‘ЩҺШ§ Ш®ЩҺЩ„ЩҺЩӮЩ’ЩҶЩҺШ§ЩғЩҸЩ… Щ…ЩҗЩ‘ЩҶ Ш°ЩҺЩғЩҺШұЩҚ ЩҲЩҺШЈЩҸЩҶШ«ЩҺЩү ЩҲЩҺШ¬ЩҺШ№ЩҺЩ„Щ’ЩҶЩҺШ§ЩғЩҸЩ…Щ’ ШҙЩҸШ№ЩҸЩҲШЁЩӢШ§ ЩҲЩҺЩӮЩҺШЁЩҺШ§ШҰЩҗЩ„ЩҺ Щ„ЩҗШӘЩҺШ№ЩҺШ§ШұЩҺЩҒЩҸЩҲШ§ ШҘЩҗЩҶЩ‘ЩҺ ШЈЩҺЩғЩ’ШұЩҺЩ…ЩҺЩғЩҸЩ…Щ’ Ш№ЩҗЩҶШҜЩҺ Ш§Щ„Щ„Щ‘ЩҺЩҖЩҮЩҗ ШЈЩҺШӘЩ’ЩӮЩҺШ§ЩғЩҸЩ…Щ’ ШҘЩҗЩҶЩ‘ЩҺ Ш§Щ„Щ„Щ‘ЩҺЩҖЩҮЩҺ Ш№ЩҺЩ„ЩҗЩҠЩ…ЩҢ Ш®ЩҺШЁЩҗЩҠШұЩҢ пҙҝЩЎЩЈпҙҫ ШіЩҲШұШ© Ш§Щ„ШӯШ¬ЩҸШұШ§ШӘ."Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© Щ„ШіШ§ЩҶ"ШҢ ЩҲЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӯЩүШҢ ШұШЁЩ…Ш§ Ш¬Ш§ШІ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ "Ш§Щ„Ш№ШұЩҲШЁШ© Щ„ШіШ§ЩҶ". ЩҲШ§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© Ш§Щ„Щ„ШәШ©ШҢ ШЈЩҠ Ш§Щ„ЩғЩ„Щ…Ш©ШҢ ШіЩҲШ§ШЎ ШЈЩғШ§ЩҶШӘ Щ…ЩғШӘЩҲШЁШ© ШЈЩ… Щ…ЩҶШ·ЩҲЩӮШ©ШҢ ЩҒШҘЩҶЩҮШ§ ШӘШӯШӘЩҲЩҠ ШЈШ№ШёЩ… Щ…ЩӮЩҲЩ…Ш§ШӘ ШҙШ®ШөЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩ…Ш©ШҢ Щ…ЩҶ Ш№ЩӮЩҠШҜШ© ЩҲШӯЩғЩ…Ш© ЩҲЩҒЩғШұ ЩҲЩ…ЩҶШ·ЩӮ ШӘЩҒЩғЩҠШұ ЩҲШӘШ№ШЁЩҠШұШҢ ЩҲЩ…ЩҶ ШӘШұШ§Ш« ЩҲШЈШҜШЁ ЩҲЩӮЩҠЩ… ЩҲШ№Ш§ШҜШ§ШӘШҢ ЩҲЩ…ЩҲШұЩҲШ«ЩҚШҢ ШЁШҙЩ…ЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү.. ЩҲШӘШӘШ¬Щ„Щү ЩҒЩҠ Щ…Ш®ШІЩҲЩҶЩҮШ§ ШұШӨЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© Щ„Щ„ЩҲШ¬ЩҲШҜ ЩҲШәШ§ЩҠШ§ШӘЩҮ ЩҲШ№Щ„Ш§ЩӮШ§ШӘЩҮ ЩҲЩӮЩҲШ§ЩҶЩҠЩҶЩҮШҢ ЩҲШұШӨЩҠШӘЩҮШ§ Щ„Щ„Ш№ШЁШ§ШҜШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш№Ш§Щ…Щ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШіЩ„ЩҲЩғ. ЩҲЩҒЩҠ ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§Щ… ШӘШӘШ¬Щ„Щү ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ШҢ ШЈЩҲ Ш§Щ„Ш№Щ„Ш§ЩӮШ© Ш§Щ„Ш¬ШҜЩ„ЩҠШ© ШЁЩҠЩҶЩҮЩ…Ш§ШҢ ШӯЩҠШ« ШӘШӘЩ… Ш№Щ…Щ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҒЩғЩҠШұ ЩҲШ§Щ„ШӘШ№ШЁЩҠШұШҢ ЩҲШӘШӘШЁШҜЩ‘ЩҺЩү ШіЩ„Ш§Щ…Ш© Ш§Щ„Щ…ЩҶШ·ЩӮ ЩҲЩӮЩҲШӘЩҮ ЩҲЩ…ЩҶШ§ЩҮШ¬ЩҮШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Ш«Щ… ЩҠШӘШ¬Щ„Щ‘ЩҠ ШұЩҲШӯ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© ЩҲЩӮЩҲШ§Щ…ЩҮШ§ ЩҲЩӮЩҠЩ…ЩҮШ§ ЩҲШҘШЁШҜШ§Ш№ЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ЩҮ. ЩҲЩ„Ш§ ШәШұШ§ШЁШ© ШҘШ°ЩҶ ЩҒЩҠ ШЈЩҶ ЩҠЩғЩҲЩҶ Ш§Щ„Ш№ШҜШ§ШЎ Щ„Щ„ШәШ© Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© Ш§Щ„ЩҠЩҲЩ…ШҢ ЩҲЩ„Щ…Ш§ ШӘЩ…Ш«Щ„ЩҮ ЩҲШӘШӯЩ…Щ„ЩҮШҢ Щ„Ш§ ШіЩҠЩ…Ш§ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…ШҢ ЩҒЩҠ Щ…ЩӮШҜЩ…Ш© ШЈЩҮШҜШ§ЩҒ ШЈШ№ШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШЈЩ…ШӘЩҠЩҶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШ©ШҢ ЩҲШ№Щ„Щү ШұШЈШі ШЁШұШ§Щ…Ш¬ЩҮЩ… Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШӨШҜЩҠ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШәШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҲШҘЩҶ Ш§Ш®ШӘЩ„ЩҒШӘ Ш§Щ„ЩҲШіЩҠЩ„Ш©. ЩҲЩҮШ°Ш§ ЩғШ§ЩҶ ЩҲЩ…Ш§ ШІШ§Щ„ ШҙШЈЩҶ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ…ШҢ Щ…Ш№ Щ„ШіШ§ЩҶЩҶШ§ШҢ ШЁЩҶЩҠШ© ЩҲЩ…Ш¶Щ…ЩҲЩҶЩӢШ§ШҢ ШӯШ§Щ…Щ„ЩӢШ§ ЩҲЩ…ШӯЩ…ЩҲЩ„ЩӢШ§ШҢ ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Ш§Щ„Ш§ШӘ ШҙЩҮШҜШӘ Ш№ШҜШ§ШЎ Щ…ЩғШҙЩҲЩҒЩӢШ§ ЩҲЩ…ШіШӘШӘШұЩӢШ§ШҢ ЩҲЩҒЩҠ Ш¬ШЁЩҮШ§ШӘ Ш№ШұШ§Щғ Щ…ЩҶЩҮШ§ Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒШ©ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҲЩҲШ¬ЩҗЩҮШӘ ШЈЩ…ШӘЩҶШ§ ШЁШӘШӯШҜЩҠШ§ШӘ ЩғШЁЩҠШұШ©ШҢ ЩҲШ§ЩҶШӘШөШұШӘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЁШ№Ш¶ Щ…ЩҶЩҮШ§ ЩҲШ§ЩҶЩғШіШұШӘ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ ШўШ®ШұШҢ ЩҲЩ…Ш§ ШІШ§Щ„ШӘ ШӘЩӮШ§ЩҲЩ…ШҢ ЩҲШӘШ№Щ„ЩҶ Ш№ЩҶ Ш§ШіШӘЩ…ШұШ§Шұ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҲШҜ.ЩҒЩ…Ш§ ШЈЩ…Ш© ЩҠШ§ ШӘЩҸШұЩү ШәЩҠШұ Щ…Ш§ ШӯЩ…Щ„ Щ„ШіШ§ЩҶЩҮШ§ШҢ ЩҲЩ…Ш§ ШӘШ¬Щ„Щү ЩҲШ¬ЩҲШҜЩӢШ§ ЩҲШҘШЁШҜШ§Ш№ЩӢШ§ ЩҒЩҠ ШЁЩҠШ§ЩҶЩҮШ§ ЩҲШЈШҜШ§ШҰЩҮШ§ Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠ Ш°ЩҠ Ш§Щ„Ш®ШөЩҲШөЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ШӘЩ…Ш§ЩҠШІШҹ! ЩҲШЈЩҠ Щ„ШіШ§ЩҶ ШЈЩғШ«Шұ ШәЩҶЩү Щ…ЩҶ Щ„ШіШ§ЩҶ ШӯЩ…Щ„ Ш§Щ„ШЁЩҠШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ЩӮШұШўЩҶШҢ ЩҲШЈШ№Ш·ЩүШҢ ЩҒШЈШәЩҶЩү ЩҲШ§ШәШӘЩҶЩүШҢ ЩҲШЈЩҒШөШӯ ЩҲШЈЩ„ЩӮШӯ.. ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„Ш№Щ„ЩҲЩ…ШҢ Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШЈШІЩ…ЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…ЩғЩҶШ© ЩҲШ§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш§ШӘ Ш§Щ„ШЁШҙШұЩҠШ©.. ЩҮЩҲ Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш¶Ш§ШҜШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩ…ШӘШ§ШІ ШЁЩҒШұШ§ШҜШ© ЩҲШәЩҶЩү Щ„Ш§ Щ…Ш«ЩҠЩ„ Щ„ЩҮЩ…Ш§Шҹ!ЩҠШ§ Щ„ЩҮШ§ ЩҶШҙЩҲШӘЩҠ Щ…ЩҶ ЩҶШҙЩҲШ© Ш°Ш§ШӘЩҚ Щ…ШҙШҜЩҲШҜШ© ЩғШ§Щ„ЩҲШӘШұ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§Ш¶ЩҠ ЩҲШ§Щ„ШӯШ§Ш¶ШұШҢ Ш§Щ„ШӯЩ„Щ… ЩҲШ§Щ„ЩҲЩҮЩ…ШҢ Ш§Щ„ШұШ¬Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„ЩӮЩҶЩҲШ·ШҢ Ш§Щ„ШұШ§ЩҮЩҶ ЩҲШ§Щ„Щ…ШіШӘЩҺЩӮШЁЩҺЩ„.. ЩҲЩҠШ§ Щ„ЩҮШ§ Щ…ЩҶ ЩҶШҙЩҲШ© Ш°Ш§ШӘ Щ…ШіШӘШәШұЩҗЩӮШ© ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠШ·ЩҠШЁШҢ ЩҲЩ…ЩҸШәШұЩҺЩӮШ© ЩҒЩҠ Щ…Ш§ ЩҠШ«ЩҠШұ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§Ш¬Ш№ШҢ ЩҲЩҠЩӮЩҸШ¶ Ш§Щ„Щ…Ш¶Ш§Ш¬Ш№.. ЩҶШҙЩҲШ© ШЈШ№Ш§ШҜШӘЩҶЩҠ ШҘЩ„Щү Щ„ШіШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҲШЈШ№Ш§ШҜШӘ ШҘЩ„ЩҠЩ‘ЩҺ Ш§Щ„ШӯЩ„Щ… ШЁШ§ЩҶШӘШ№Ш§Шҙ Щ„ШіШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҒШ¬ЩҸЩ„ШӘ ШЁШЈЩ„Щ… ЩҲШ«ЩӮШ© ЩҲШ№ШІЩ… ШЁЩҠЩҶ "Ш§ЩӮШұШЈ"ШҢ ЩҲ"Ш№Щ„Щ‘ЩҺЩ…ЩҺ ШЁШ§Щ„ЩӮЩ„Щ…" ЩҲ"ШҘЩҶЩ‘ЩҺ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЁЩҠШ§ЩҶЩҗ Щ„ШіШӯШұШ§".. ЩҶШҙЩҲШ© ШЈШӯШі ШҜШЁЩҠШЁЩҺЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҶЩҸЩӮЩү Ш§Щ„Ш№ШёШ§Щ…ШҢ ШұШәЩ… Ш§Щ„ШөЩӮЩҠШ№ШҢ ЩҲЩҠЩғШ§ШҜ ЩҶШЁШ¶ЩҸЩҮШ§ ЩҠЩҒШӘЩ‘ЩҗЩӮ Ш§Щ„ШЈЩҲШұШҜШ© ЩҲШ§Щ„ШҙШұШ§ЩҠЩҠЩҶШҢ ШұЩҸШәЩ…ЩҺ Ш§Щ„Ш¬ЩҺЩ„ЩҺШҜ.. ШЈШіШӘШҙШ№ШұЩҮШ§ ШұЩҲШӯЩӢШ§ ЩҒЩҠ ШЈЩ…Ш© ЩҠЩҲЩҮЩҶЩҮШ§ ШЈЩҮЩ„ЩҸЩҮШ§ШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠШҙШҜЩҲЩҶЩҮШ§ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Ш¬ЩҮЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¬ЩҮЩҠЩ„ШҢ ЩҲЩҠШЁШӘЩ„ЩҲЩҶЩҮШ§ ШЁШ§Щ„ЩҒШӘЩҶШҢ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩӮШӘШӘШ§Щ„ Ш§Щ„ШЁЩҠЩҶЩҠЩ‘ШҢ ЩҲШ§Щ„Ш§ШұШӘЩ…Ш§ШЎ ЩҒЩҠ ШЈШӯШ¶Ш§ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ№ШҜШ§ШЎШҢ ЩҲШ§ШӘШЁШ§Ш№ ЩӮШөШ§Шұ Ш§Щ„ЩҶШёШұ Щ…ЩҶ ШЈЩҮЩ„ Ш§Щ„ШӘШіЩ„Щ‘Ш· Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШіЩ„Ш·Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ШӘШ·Щ„Ш№ЩҠЩҶ ШҘЩ„Щү ШіЩ„Ш·Ш© Щ„ЩҠЩ…Ш§ШұШіЩҲШ§ Ш§Щ„ШӘШіЩ„Щ‘Ш·.. ЩҒШӘШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Ш¶Ш№ЩҒ ЩҲШ§Щ„ЩҮЩҲШ§ЩҶШҢ ЩҲЩҠЩҶШ®Шұ Ш¬ШіЩ…ЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҒШіШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҒШіШ§ШҜ ЩҲШ№ШЁШ§ШҜШ© Ш§Щ„ШЈЩҒШұШ§ШҜШҢ ЩҲШӘШ¬ЩҲШі ШЈЩҠШҜЩҠ ШЈШ№ШҜШ§ШҰЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩғШЁШҜЩҮШ§ШҢ ЩҒШӘЩҒШұЩҠ ЩҲШӘШ№ШұЩ‘ЩҠ ЩҲШӘЩҸШ°ЩҺШұЩ‘ЩҗЩҠ Ш§Щ„ШҜЩ… ЩҲШ§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲШ§Щ„Ш№ШёЩ….. ЩҲЩҮШ§ ЩҮЩҲ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШӯШөШ§ШҜШҢ ЩҲШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ШәЩ„Ш§Щ„ ШЈЩ…Ш§Щ…ЩҶШ§ШҢ ЩҒЩҠ ШЁЩҠШ§ШҜШұЩҶШ§.. ШӯШөШ§ШҜ ШіЩҶЩҲШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ЩӮШӘ ЩҲШ§Щ„ЩҒШӘЩҶШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҲШӘШҢ Ш§Щ„ШӘЩҠ Ш®ЩҠЩ‘Щ…ШӘ ЩҒЩҠ ШіЩ…Ш§ШҰЩҶШ§ШҢ ЩҲШӯШ¬ШЁШӘ Ш№ЩҶШ§ Ш§Щ„ШұШӨЩҠШ© Ш§Щ„ШіЩ„ЩҠЩ…Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШӯЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Ш№ШёЩҠЩ…Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШўЩ…Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩғШЁШ§ШұШҢ ЩҲЩғШ§ШҜШӘ ШӘШӯШ¬ШЁ ЩғЩ„Щ‘ЩҺ Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ШҢ ЩҲШӯШіЩ‘ЩҺ Ш§Щ„Ш№ШҜЩ„ШҢ ЩҲШӯШӘЩү Ш§Щ„Щ…Ш§ШЎШҢ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§ЩҠЩҠЩҶ ЩҲШ§Щ„Щ…Щ„Ш§ЩҠЩҠЩҶ Щ…ЩҶ ШЈШЁЩҶШ§ШЎ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© Ш№Ш·Ш§ШҙЩҢШҢ ЩҒЩҠ ЩҶЩҺШөЩҺШЁЩҚ ЩҲШӘЩҠЩҮ ЩҲШіШәЩҺШЁЩҚШҢ ЩҠШҜШ®Щ„ЩҲЩҶ Ш¬ЩҲЩҒ Ш§Щ„ШұШ№ШЁ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш¬Ш§Ш№Ш©ШҢ Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш© ШЁШ№ШҜ Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш©.. ЩҒЩҠ ШӯЩҠЩҶ ЩҠШіШӘЩ…Шұ ЩҶШІЩҒ Ш§Щ„ШҜЩ…ШҢ ЩҲЩҮЩҲЩ„ Ш§Щ„ШұЩ‘ШҜЩ…ШҢ ЩҲШӘШӘШҜШӯШұШ¬ ЩғШұШ§ШӘ ЩҶШ§Шұ Ш§Щ„ЩғШұШ§ЩҮЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҒШӘЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШҜЩ….. Щ…ЩҶ ШҜШ§Шұ ШҘЩ„Щү ШҜШ§ШұШҢ ЩҒЩҠ ЩғЩ„ Ш§Щ„ШЈЩ…ШөШ§ШұШҢ ЩҒШӘШ«ЩҠШұ Щ…Ш§ ШӘШ«ЩҠШұШҢ Щ…ЩҶ ШұШҜШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҒШ№Щ„ Ш§Щ„ЩғШ§ШұШ«ЩҠШ© ЩҲШіЩҲШЎ Ш§Щ„ШӘШҜШЁЩҠШұШҹ! ЩҲЩғЩ„ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШіЩҲШЎШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ЩғЩҲШ§ШұШ« Ш§Щ„ШӘЩҠ Ш¬Ш№Щ„ШӘ Щ„Щ„ЩҠШЈШі ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈЩҶЩҒШі Ш¬Ш°ЩҲШұЩӢШ§ ЩҲЩҒШұЩҲШ№ЩӢШ§ШҢ ЩҲЩғШ§ШҜШӘ ШӘЩӮШ¶ЩҠ Ш№Щ„Щү ЩғЩ„ ШЈЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Щ„ЩӮШ§ШЎ Щ…ЩҶЩӮШ°ШҢ ЩҲШӯЩҲШ§Шұ Щ…ЩҶШ·ЩӮЩҠ Щ…ШіШӨЩҲЩ„ШҢ ШЁЩҠЩҶ Щ„ШіШ§ЩҶЩҶШ§ ЩҲЩғЩҠШ§ЩҶЩҶШ§ШҢ ЩҒЩҠ ЩҲШ·ЩҶ ЩҮЩҲ ШЁЩҠШӘ Ш§Щ„Щ…ШӯЩҠШ§ШҢ ЩҲЩӮШЁШұ Ш§Щ„Щ…Щ…Ш§ШӘ.. ЩҲШ·ЩҶ ЩҠШӯЩҠШ§ ШЁЩҶШ§ ЩҲЩҶШӯЩҠШ§ ЩҒЩҠЩҮШҢ ЩҲЩҶЩғЩҲЩҶ ШЁЩҮШҢ ЩҲШЁЩҶШ§ ЩҠЩғЩҲЩҶШҢ ЩҲЩҶШұШӘЩҒШ№ Щ…Ш№ЩӢШ§ ШҘЩ„Щү ШЈШҙШұЩҒ Ш°ШұЩҲШ© Щ…ЩҶ Ш°ШұЩү Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶШҢ Щ„ЩҲ ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„ ШәЩҠШұ Ш§Щ„ШӯШ§Щ„ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈЩҒШ№Ш§Щ„ ЩҲШ§Щ„ЩҶЩҲШ§ЩҠШ§ ШҘЩ„Щү ШЁЩҶШ§ШЎ ЩҲЩ„ЩҠШіШӘ ШҘЩ„Щү ЩҮШҜЩ…..Щ„ЩӮШҜ ШЈШөШЁШӯ Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩғЩҒШӨ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘЩ…ЩҠ Щ„Щ„ШЈЩ…Ш© ШЁЩҲШ№ЩҠ ЩҲШ®Щ„ЩӮ ЩҲШҘЩҠЩ…Ш§ЩҶШҢ ЩӮШ·Ш№ЩӢШ§ ЩҶШ§ШҜШұЩӢШ§ШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Ш«Щ… Ш§Щ„ЩҒШ№Щ„ Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШЎ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӯЩү.. ЩҲШЈШөШЁШӯ ЩғЩ„ Ш№ШұШЁЩҠ ЩҠЩҶШӘЩ…ЩҠ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШЈЩ…Ш©ШҢ Щ„Ш§ ШіЩҠЩ…Ш§ Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„ШЈЩғШЁШұ ШҘЩҶ ЩҲШ¬ЩҗШҜШҢ ШЁЩҲШ№ЩҠ Щ…Ш№ШұЩҒЩҠ Ш№Щ…ЩҠЩӮ ЩҲЩ…ШіШӨЩҲЩ„ ШЈШ®Щ„Ш§ЩӮЩҠШ© ЩҲШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩ…ШөШҜШ§ЩӮЩҠШ© ШӘЩҸШӘЩҺШұШ¬ЩҺЩ… ШҘЩ„Щү ШЈЩҒШ№Ш§Щ„ - ЩҲЩӮЩ„Ш© ЩӮЩ„ЩҠЩ„Ш© Щ…Ш§ ЩҮЩ… - Щ…ШӯШ§Ш·ЩҠЩҶ ШЁШ§Щ„Ш®Ш·Шұ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШӘЩҮШҜШҜ Ш§Щ„Щ„ШәШ© ЩҲЩ…Ш§ ШӯЩ…Щ„ШӘШҢ ЩҲШ§Щ„Ш°Ш§ЩғШұШ© ЩҲЩ…Ш§ ЩҲШ№ШӘШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Ш«Щ… Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ЩҲШ§Щ„ЩҮЩҲЩҠШ© ШЁЩ…Ш§ ШӘЩ…Ш«Щ„ЩҮШҹ! ЩҲШіЩҲШ§ШЎ Ш§ШіШӘШҙШ№Шұ Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„ШЈЩғШЁШұ Ш§Щ„Ш®Ш·Шұ Ш§Щ„ШҜШ§ЩҮЩ… ШЈЩ… Щ„Щ… ЩҠШіШӘШҙШ№ШұЩҮШҢ ЩҒШҘЩҶЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҗШӯЩҶШ©ШҢ Щ…ШәШІЩҲЩ‘ЩҢ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш®Ш§ШұШ¬ШҢ ЩҲЩ…ШҜШ®ЩҲЩ„ ШЁЩҠШӘЩҸЩҮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҜШ§Ш®Щ„ШҢ ШЁШЁШ№Ш¶ ШЈЩҮЩ„ ШЁЩҠШӘЩҮШҢ Щ…Щ…ЩҶ ЩҠШҙЩғЩ„ЩҲЩҶ ШіЩҲШіЩӢШ§ ЩҠШ®ШұШ¬ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш°Ш§ШӘШҢ ЩҲЩҠЩҶШ®Шұ ШЈШ№Щ…Ш§ЩӮ Ш§Щ„ШӘЩғЩҲЩҠЩҶ.. ЩҲЩҠШ§ Щ„Щ„ШӯШіШұШ© ЩҒШ§Щ„ШЁШӨШі ШЈЩ„ЩҲШ§ЩҶ.. ШЁЩҠЩҶЩ…Ш§ Ш§Щ„Ш®Ш·Шұ Щ„Ш§ ЩҠЩғЩҒ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШӘШ·ЩҲШұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ„ЩҲЩҶ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩӮШӘШұШ§ШЁ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӯШөЩҲЩҶ Ш§Щ„ШӯШөЩҠЩҶШ©ШҢ ШЈЩҲ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҸШұЩү ЩғШ°Щ„ЩғШҹ! ШҘЩҶ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘЩ…ЩҠ ШЁЩҲШ№ЩҠ Щ„Щ„ШЈЩ…Ш© ЩҲШ§Щ„Ш№ЩӮЩҠШҜШ©ШҢ ШЈЩҶ ЩҠЩҲШ§Ш¬ЩҮШҢ ЩҲШӯШҜЩҮ ШұШЁЩ…Ш§ШҢ Щ…Ш§ Щ„Ш§ ЩӮЩҗШЁЩҺЩ„ Щ„ЩҮ ШЁЩ…ЩҲШ§Ш¬ЩҮШӘЩҮ ЩҲШӯШҜЩҺЩҮШҢ ЩҲШ°Ш§Щғ Щ…ЩӮШӘЩҺЩ„ ЩғЩ„ Щ…ЩҶ ШӘШӘШ®Щ„Щү Ш№ЩҶЩҮ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш© ШЈЩҲ ЩҠШӘШ®Щ„Щү Ш№ЩҶЩҮШ§.. ШӘЩ„Щғ Ш№ЩӮШҜШ© ШЁШӨШіШҢ ЩҒЩҮЩ„ ШҘШ°Ш§ Ш¶Щ„Щ‘ЩҺШӘ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш© ЩҠШ¬ШЁ ШЈЩ„Ш§ ШӘШұШӘЩҒШ№ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈЩҒЩӮ ШҙШ№Щ„Ш© ЩҮШҜШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҲШҘШ°Ш§ Ш§ШұШӘЩҒШ№ШӘ ЩғШ§ЩҶ ШӯШёЩҮШ§ Ш§Щ„ШҘШ·ЩҒШ§ШЎШҢ ЩҲЩ…Ш§ ЩҮЩҲ ШЈШЁШ№ШҜШҹ! ШӘЩ„Щғ ШӯШ§Щ„ ШӘШҜШ®Щ„ ЩҒЩҠ Щ…ШӯЩҶ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ… ЩҲШ§Щ…ШӘШӯШ§ЩҶШ§ШӘЩҮШ§ШҢ ЩҲШұЩ…Ш§ ЩғШ§ЩҶШӘ Щ…ЩҶ ШЈШҙШҜ Щ…ШӯЩҶ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ. ШҘЩҶ ШҜШ§ШҰШұШ© Ш§Щ„ШӯШөШ§Шұ ШӯЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘЩ…ЩҠ ШЁШҘШ®Щ„Ш§Шө ЩҲЩҲШ№ЩҠШҢ ШӘШ¶ЩҠЩӮ ЩҲШӘШІШҜШ§ШҜ Ш¶ШәШ·ЩӢШ§ ЩҲШ®ЩҶЩ’ЩӮЩӢШ§ШҢ ЩҲШ§Щ„Ш¬ШЁЩҮШ§ШӘ Ш§Щ„ШӘЩҠ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШЈЩҶ ЩҠШӯШ§ШұШЁ ЩҒЩҠЩҮШ§ ШӘШӘШ№ШҜШҜШҢ ШӯЩҠШ« Щ„Ш§ ЩҠШіШҜ ЩҒШ¬ЩҲШ§ШӘЩҮШ§.. ЩҲЩҮЩҲШҢ ШҘЩҶ Щ„Щ… ЩҠЩӮЩ… ШЁЩ…Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶ ЩҠЩҶЩӮЩҗШ°ШҢ ЩҲШҘЩҶ Щ„Щ… ЩҠШӘШөШҜЩ‘ЩҺ Щ„Щ„Ш®Ш·Шұ Ш§Щ„ШҜШ§ЩҮЩ…ШҢ ШЁШөЩҲШұШ© Щ…Ш§.. ЩҒШҘЩҶЩҮ Щ„ЩҶ ЩҠШұШ¶ЩҺЩү ЩҲЩ„ЩҶ ЩҠЩҸШұШ¶ЩҠ.. ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШӯЩҲШ§Щ„ Ш¬Щ…ЩҠШ№ЩӢШ§ ШіЩҠЩ„ЩӮЩү Ш№ЩҺЩҶШӘЩӢШ§ШҢ ЩҲЩҠШҜЩҒШ№ Ш§Щ„Ш«Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҒШ§ШҜШӯ ШЁШөЩҲШұ ШҙШӘЩүШҢ Щ…ЩҶЩҮШ§ Щ…Ш§ ЩҮЩҲ ШЈЩ…Ш§Щ… Ш¬Щ…Ш§ЩҮЩҠШұЩҮ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈЩӮЩ„ШҢ ЩҲШіЩҠШӘШӯЩ…Щ„ Щ…ШіШӨЩҲЩ„ЩҠШ© ШЈЩ…Ш§Щ… Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® ЩҲШ§Щ„ЩҶШ§Ші.. ЩҶШ№Щ… Ш§Щ„ЩҶШ§Ші.. Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ Щ„Щ… ЩҠШҜЩҺШ№ЩҲШ§ ЩҒШұШөШ© ШҘЩ„Ш§ ЩҲЩҶШ§ШҜЩҲШ§ ЩҒЩҠЩҮШ§ ШЁШ§Щ„ШӘШ¶Ш§Щ…ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШӘШ№Ш§ЩҲЩҶ ЩҲШ§Щ„ЩҲЩҒШ§ЩӮШҢ ЩҲШЁШ¶ШұЩҲШұШ© Ш§Щ„ШӘШөШҜЩҠ Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш© Щ„Щ„Ш®Ш·Шұ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШіШӘЩҮШҜЩҒ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш©ШҢ ЩҲЩ…ЩҲШ§Ш¬ЩҮШ© ШЈШ№ШҜШ§ШЎ Ш§Щ„ШҜШ§Ш®Щ„ ЩҲШЈШ№ШҜШ§ШЎ Ш§Щ„Ш®Ш§ШұШ¬ШҢ ЩҲШ§Щ„ШӘШөШҜЩҠ Щ„Щ„ШӘШӯШҜЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШөЩҠШұЩҠШ©.. Щ„ЩғЩҶ ЩғШ«ШұШ© ЩғШ§Ш«ШұШ© Щ…ЩҶЩҮЩ… ШӯЩҠЩҶ ШӘШҜШ№Щү Щ„Щ„Ш№Щ…Щ„ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҲШ§Ш¬ЩҮШ© ШӘШ°ЩҲШЁ.. ШӯШ§Щ„ Ш§Щ„Щ…Щ„Шӯ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§ШЎШҹ! ШЈЩ…Ш§ Ш§Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ Ш§Щ„Ш°ЩҠ Щ„Ш§ ЩҠШ№ЩҶЩҠЩҮ ШЈЩҶ ЩҠЩҶШӘЩ…ЩҠ Щ„Щ„ШЈЩ…Ш©ШҢ ЩҲЩ„Ш§ ШЈЩҶ ЩҠШҜШ§ЩҒШ№ Ш№Щ…Ш§ ЩҠШҙЩғЩ„ ЩғЩҠШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© ЩҲЩҮЩҲЩҠШӘЩҮШ§ ЩҲЩғЩҠЩҶЩҲЩҶШӘЩҮШ§ ЩҲШ®ШөЩҲШөЩҠШӘЩҮШ§ШҢ ЩҒШҘЩҶЩҮ ШҘЩ…Ш§ ЩҠШұЩҲШә ЩҲЩҠШӘШІШЈШЁЩҺЩӮШҢ ЩҲШҘЩ…Ш§ ЩҠШҙЩҮШұ ШіЩҠЩҒЩӢШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© Щ…Ш№ ШЈШ№ШҜШ§ШҰЩҮШ§ШҢ ЩҲШ§Щ„Ш°ШұШ§ШҰШ№ Щ„Ш§ ШӘШ№ЩҲШІ Щ…ЩҶ Щ„Ш§ ШӘЩҮЩ…ЩҮЩ… ЩғЩ„Щ…Ш© Ш§Щ„ШӯЩӮШҢ ЩҲЩ„Ш§ Ш§Щ„ШҜЩҒШ§Ш№ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҙШұЩҒ ЩҲШ§Щ„ШӯЩ…Щү ЩҲШ§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШұШ¶ ЩҲШ§Щ„Ш№ШұШ¶ ЩҲШ§Щ„ШҜЩҠЩҶ.ЩҲЩ„ЩҲ ШЈЩҶЩҮШҢ ЩҒЩҠ Щ„ЩӮШ§ШЎ Щ…ЩҶ Щ„ЩӮШ§ШЎШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШ© Ш§Щ„Ш№ШұШЁШҢ ЩҠЩҲЩ„ШҜ ШЈЩ…Щ„ ШЁШҘШ№Ш§ШҜШ© Ш§Щ„Ш§Ш№ШӘШЁШ§Шұ Щ„Щ…ЩҒЩҮЩҲЩ… Ш§Щ„ШЈЩ…Ш© ШЈЩҲЩ„ЩӢШ§ШҢ Щ„Ш§ "ШЈЩҶШ§ ШЈЩҲЩ„ЩӢШ§"ШҢ ЩҲШҘЩ„Щү Щ…ЩҒЩҮЩҲЩ… Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ШЁШ§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„ШұЩҲШӯШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠ - Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠ Ш§Щ„ШҙШ§Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩҲШ§ШіШ№ШҢ ЩҲЩ„Ш§ШұШӘШЁШ§Ш·ЩҶШ§ ШЁЩҮШҢ ЩҲШ§Щ„ЩҲШ№ЩҠ ШЁЩ…ЩҒЩҮЩҲЩ…ЩҮ ЩҲЩ…ШіШӨЩҲЩ„ЩҠШ§ШӘЩҮШҢ ЩҲШӘШ№ШІЩҠШІ Щ…Ш№ЩҶШ§ЩҮ ЩҲЩ…ШЁЩҶШ§ЩҮ ЩҲЩҒШӯЩҲШ§ЩҮ ЩҲШ¬ШҜЩҲШ§ЩҮ.. Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӯЩ…ЩҠ ШЁЩӮЩҲШ© Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘЩ…ЩҠЩҶ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҙШ№ШЁ ЩҲШ§Щ„ШЈШұШ¶ ЩҲШ§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ® ЩҲШ§Щ„ШҜЩҠЩҶ.. Щ„ЩғШ§ЩҶ ШЈЩҶ ЩҲШ№Щү Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ЩҸ Щ…ЩҶШ·ЩӮ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ЩҲШӯШөШӯШө Ш§Щ„ШӯЩӮШҢ ЩҲШӘШ№Щ…Щ„ЩӮ Ш§Щ„ЩҲШ§Ш¬ШЁШҢ ЩҲШӯЩ…Щ„ШӘ Ш§Щ„ЩғЩ„Щ…Ш§ШӘ ШӯШұШ§ШұШ© Ш§Щ„ЩҲШ§ЩӮШ№ШҢ ЩҲЩ…Ш№Ш§ЩҶШ§Ш© Ш§Щ„Ш®Щ„ЩӮ ЩҲШӘЩҲЩӮЩҮЩ… Щ„Щ„ЩӮШ§ШЎ ЩҒЩҠ ШӯШ¶ЩҶ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШЁЩҠШ§ЩҶШҢ Ш§Щ„ЩғШұШ§Щ…Ш© ЩҲШ§Щ„ШЈШөШ§Щ„Ш©ШҢ Ш§Щ„Ш№ШұЩҲШЁШ© ЩҲШ§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ШҢ Щ…ЩҶ ШҜЩҲЩҶ Щ…ШөШ§ШҜШұШ§ШӘ ЩҲШ№ЩӮШЁШ§ШӘ ЩҲШЈЩҒШ№ЩҲШ§ЩҶЩҠШ§ШӘ ШіЩҠШ§ШіЩҠШ© ЩҲШ№ШұЩӮЩҠШ© ЩҲЩ…Ш°ЩҮШЁЩҠШ©ШҢ ЩҲШЈЩҠШҜЩҠЩҲЩ„ЩҲШ¬ЩҠШ© Щ…ЩҒЩ„ШіШ© ШӘШәЩ…Шұ ШІЩҮШұ Ш§Щ„ШӯШҜШ§ШҰЩӮ ШЁШ§Щ„ШҙЩҲЩғ.. ЩҲЩ„ШЈЩҮШҜЩү Ш°Щ„Щғ ЩғЩ„ЩҮ ЩҲЩҒШ§ЩӮЩӢШ§ ЩҲШ§ШӘЩҒШ§ЩӮЩӢШ§ШҢ ЩҲЩӮЩҲШ© ЩҲЩҶЩҮШ¬ЩӢШ§ШҢ ЩҲШҘЩӮШЁШ§Щ„ЩӢШ§ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші Ш№Щ„Щү Щ…Ш§ ЩҠЩҶЩӮШ° Ш§Щ„ЩҶШ§Ші.. ЩҲЩ„ЩӮШҜЩ… Ш№ШЁШұШ© ЩҲШҜШұШіЩӢШ§ ЩҲШЁЩҠШ§ЩҶЩӢШ§ Щ„Щ„Щ…ШіШӨЩҲЩ„ЩҠЩҶШҢ ШЈЩ„Ш¬Щ… ЩҒЩҠЩҮЩ… ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶШ§ШіШҢ ШЁШәШ¶Ш§ШЎ ЩҲЩғШұШ§ЩҮЩҠШ§ШӘ ЩҲШҜШіШ§ШҰШіШҢ Щ…Ш№ШёЩ…ЩҮШ§ ШіЩҠШ§ШіЩҠШ©ШҢ ШӘШ·Ш§ЩҲЩ„ШӘ ЩҲШӘШҙЩ…ШұШ®ШӘШҢ ШӯШӘЩү ШӯШ¬ЩҺШЁШӘ Ш§Щ„ЩӮЩ„ШЁ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ЩӮЩ„ШЁШҢ ЩҲШ§Щ„ШӯШ§ЩғЩ… Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ№ШЁШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШ® Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ®ШҢ ЩҲШЈЩҶШ°ШұШӘ ШЁШ®ШұШ§ШЁ Щ…Ш§ ШЁШ№ШҜЩҮ Ш®ШұШ§ШЁ. ЩҲЩ„Щ…Ш§ Ш¬Ш§ШЎ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ШӯЩҠЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШҜЩҮШұШҢ ШіШҰЩ…ЩҲШ§ ЩҒЩҠЩҮ ШҙШЈЩҶЩҮЩ… ЩғЩ„ЩҮШҢ ЩҲЩҶШЁШ°ЩҲШ§ ШЈШіЩ…ЩҮЩ…ШҢ ЩҲШӘШ¶Ш§ШЎЩ„ЩҲШ§ ШЈЩ…Ш§Щ… Ш§ЩҶШӘЩ…Ш§ШҰЩҮЩ…ШҢ ЩҲШ№Ш§ЩҒЩҲШ§ ШөЩҗЩ„Ш§ШӘЩҮЩ… ШЁШ§Щ„ШӯШ§Ш¶Шұ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш§Ш¶ЩҠШҢ ШЁШ§Щ„ШӘШұШ§Ш« ЩҲШ§Щ„ШӘШұШ§ШЁ ЩҲЩ…Ш§ ШӯЩ…Щ„Ш§ШҢ Щ…Щ…Ш§ ШЈШёЩҮШұШ§ЩҮ ЩҲШЈШ¶Щ…ШұШ§ЩҮ.. ЩҲШөШ§Шұ Ш§Щ„Щ…ШіШӘЩӮШЁЩ„ ШЈЩ…Ш§Щ…ЩҮЩ… Щ…Ш¬ШұШҜ ШЈЩ…ЩҶ Щ„ЩҠЩ„Ш©ШҢ ЩҲЩӮЩҲШӘЩҮШ§ШҢ ЩҲШ§ШӘЩӮШ§ШЎ ШІЩ…ЩҮШұЩҠШұЩҮШ§ШҢ ЩҲШ§Щ„ШұШ№ШЁ ЩҲШ§Щ„ШҘШұЩҮШ§ШЁ ЩҲШ§Щ„Ш№Ш°Ш§ШЁ ЩҒЩҠЩҮШ§.ЩҠШ§ ШЈЩҮЩ„ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ Ш§Щ„Ш№ШұШЁ.. ШҘЩҶЩҮШ§ ШЈШұШ¶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁШҢ ЩҲШЁЩҠШҰШ© Ш«ЩӮШ§ЩҒШӘЩҮЩ… ЩҲШӘШұШЁШӘЩҮЩ… Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҶШЁШ° ШЁШ№Ш¶ЩҮЩ… ЩҒЩҠЩҮЩҠЩ…ЩҲЩҶ Ш№Щ„Щү ЩҲШ¬ЩҲЩҮЩҮЩ…ШҢ ЩҲШӘШ°ШЁШӯ ШЁШ№Ш¶ЩҮЩ… ЩҒЩҠЩҶШёШұЩҲЩҶ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҜЩ… ШЁШ§ЩҶШӘШёШ§Шұ Ш§Щ„ШҜЩ….. ЩҲШӘЩӮЩҮШұ Щ…ЩҶ ШӘЩӮЩҮШұШҢ ЩҲШӘЩҮЩ…Шҙ Щ…ЩҶ ШӘЩҮЩ…ШҙШҢ ЩҒЩҠШәШҜЩҲ Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш№ ШЁШ§ШӘШіШ§Ш№ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ… ЩҲЩ…ШҜЩү Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШөШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩғЩ„ ЩҠШЁШӯШ« Ш№ЩҶ ЩҶШөЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш№ШҜЩҲ Щ„ЩҮ ЩҲЩ„ШЈЩ…ШӘЩҮ ЩҲШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҮ ЩҲШҜЩҠЩҶЩҮ.. ЩҲЩҮЩҠ ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШЁЩҠШҰШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШЈШөШЁШӯШӘ ШӘШҜШ№Щ‘ЩҸ ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҮШ§ ЩҲЩ„ШіШ§ЩҶЩҮШ§.. ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШ№ЩҲШҜ ЩҒЩҠ Щ…ЩғЩҲЩҶШ§ШӘЩҮШ§ ЩҲШҘШұШ«ЩҮШ§ ШҘЩ„Щү ЩғЩ„ Щ…Ш§ ШӯЩҒШёШӘЩҮ Ш§Щ„ШЈШұШ¶ШҢ ЩҲШіШ¬Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩҲЩҲШ№ШӘЩҮ Ш§Щ„Ш°Ш§ЩғШұШ©.. Щ…ЩҶШ° Ш№ШҙШұШ© ШўЩ„Ш§ЩҒ ШіЩҶШ© ЩӮШЁЩ„ Ш§Щ„Щ…ЩҠЩ„Ш§ШҜШҢ ШЁШҜШЎЩӢШ§ ШЁШ§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұШ© Ш§Щ„ЩҶЩ‘Ш·ЩҲЩҒЩҠЩ‘ЩҺШ© - ЩҶШіШЁШ© ШҘЩ„Щү ШіЩҮЩ„ ЩҶШ·ЩҲЩҒ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШәЩҲШұ ЩӮШұШЁ ШЈШұЩҠШӯШ§ШҢ ЩҒЩҠ ЩҒЩ„ШіШ·ЩҠЩҶШҢ ШӯЩҠШ« ШЁШҜШЈ Ш§Щ„Ш§ШіШӘЩӮШұШ§Шұ Ш§Щ„ШӯШ¶ШұЩҠ ЩҲШ§Щ„ШІШұШ§Ш№Ш©ШҢ ЩҲШ§Щ…ШӘШҜШ§ШҜЩӢШ§ Щ…Ш№ ШІЩ…ЩҶ Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұШ© ЩҲЩ…ШҜШ§ЩҮШ§ ЩҲШ¬ШәШұШ§ЩҒЩҠШӘЩҮШ§ШҢ ШҘЩ„Щү ШӘЩ„ ШӯЩҺЩ„ЩҺЩҒЩ’ШҢ ЩҲШ§ЩҠШЁЩ„Ш§ШҢ ЩҲЩ…Ш§ШұЩҠШҢ ЩҲШЈЩҲШәШ§ШұЩҠШӘШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш№Ш·Щү Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠ Ш§Щ„Ш№Щ…ЩҲШұЩҠ - Ш§Щ„ЩғЩҶШ№Ш§ЩҶЩҠ ЩғЩ„ЩҮШҢ ЩҲШ§Щ„ШўШҙЩҲШұЩҠ ЩҲШ§Щ„ШЁШ§ШЁЩ„ЩҠ ЩҲШ§Щ„ШЈЩғШ§ШҜЩҠШҢ ШЁЩ„ ЩҲШ§Щ„ШіЩҲЩ…ШұЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш№ШұШ§ЩӮШҢ ЩҲЩ…Ш§ ЩғШ§ЩҶ Щ…ЩҶ ШҘШұШ« Ш§Щ„ЩҒШұШ№ЩҲЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…Ш§ШІЩҠШәЩҠШ©ШҢ ЩҲЩӮШЁШ§ШҰЩ„ Ш§Щ„ШЁШұШЁШұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШұШӯЩ„Ш© Ш§Щ„ЩҲШ«ЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҲШӘЩҒШ§Ш№Щ„Ш§ШӘЩҮШ§ Ш¬Щ…ЩҠШ№ЩӢШ§ШҢ Щ…Ш№ ШӯШ¶Ш§ШұШ© ЩҲШ§ШҜЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩҠЩ„ ЩӮШЁЩ„ Ш§Щ„ЩҮЩғШіЩҲШі ЩҲШЁШ№ШҜЩҮЩ….. ЩҲЩ…ЩҶ Ш«Щ… ЩғЩ„ Щ…Ш§ ЩғЩ„Щ„ШӘЩҮ Ш№ЩӮШ§ШҰШҜ ЩҲШұШіШ§Щ„Ш§ШӘ ШҘЩ„ЩҮЩҠШ© "ЩҠЩҮЩҲШҜЩҠШ©ШҢ ЩҲЩ…ШіЩҠШӯЩҠШ©"ШҢ Ш§Ш№ШӘШұЩҒ ШЁЩҮШ§ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ШҢ Щ…ШіШӘШЁШ№ШҜЩӢШ§ Ш§Щ„ШӘШӯШұЩҠЩҒ ЩҲШ§Щ„ШҙШұЩғ.. Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ… ШЁЩ…Ш§ ЩҮЩҲ ШұШіШ§Щ„Ш© Щ„Щ„ЩҶШ§Ші ЩғШ§ЩҒШ©ШҢ ЩҲШұШӯЩ…Ш© Щ„Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠЩҶ. ШҘЩҶ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШЁЩҠШҰШ©ШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш№Ш·ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШӘШ№ШҜШҜШ© Ш§Щ„ШЈЩҲШ¬ЩҮ ЩҲШ§Щ„ШәШ§ЩҠШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩҲШ§ШЁШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҲШұЩ‘Ш«Ш§ШӘ.. Ш§Щ„ШЁЩҠШҰШ© Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ЩҮЩ…Щ„Ш©ШҢ ШЁЩ…Ш№Ш·ЩҠШ§ШӘЩҮШ§ Ш§Щ„Ш«ШұЩҠШ©ШҢ ЩҲШҜЩҲШ§ЩҒШ№ЩҮШ§ШҢ ЩҲШҘЩҠШӯШ§ШЎШ§ШӘЩҮШ§ШҢ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШұШ¶ ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩҒЩҲШі Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ©ШҢ ЩҲШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШіШӘШёЩ„ ШЁШ§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„Щ…ШЁЩҠЩҶ.. ЩҲЩҮЩҠ ШЁЩҠШҰШ© Щ„Ш§ ЩҠЩҲШ§Ш¬ЩҮ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ШЈШіШҰЩ„ШӘЩҮШ§ ШЁШ¬ШҜЩҠШ© ЩғШ§ЩҒЩҠШ© - Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШөШ№ЩҠШҜ Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„ШіЩҠШ§ШіЩҠ Ш®ШөЩҲШөЩӢШ§ - ЩҲЩ„Ш§ ЩҠЩҶШ§ЩӮШҙ ШөЩ„ШӘЩҮ ШЁЩҮШ§ ЩҲШөЩ„ШӘЩҮШ§ ШЁЩҮШҢ ЩҲЩ„Ш§ Ш§ЩҶШіЩғШ§ШЁ ЩҒШұЩҲШ№ЩҮШ§ ЩҒЩҠ ШЈШөЩҲЩ„ЩҮ ЩҲШЈШөЩҲЩ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҒШұЩҲШ№ЩҮ.. ЩҲЩ„Ш§ ЩҠШӘШ№Щ…ЩӮ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ ШЁЩҮШҜЩҒ ШҘЩҶШ¬Ш§ШІ Щ…Ш№Ш§Щ„Ш¬Ш© ШҙШ§Щ…Щ„Ш© ЩҮШ§ШҜЩҒШ© ЩҲЩҲШ§Ш№ЩҠШ© ЩҲЩ…ШіШӨЩҲЩ„Ш©ШҢ ШӘШӘШөЩ„ ШЁШЁШҙШұ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШұШ¶ШҢ ЩҠШіШӘШ«Щ…Шұ ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ЩҮЩ… ШЈШ№ШҜШ§ШЎ Щ„Щ„Ш№ШұЩҲШЁШ© ЩҲШ§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ШҢ ЩҲШ§Щ„ШіЩ„Щ… ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…ЩҶШҢ ЩҒШӘШЁШұШІ Ш®Щ„Ш§ЩҒШ§ШӘ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШіШ·ШӯШҢ Щ„Ш§ ШӘЩ„ШЁШ« ШЈЩҶ ШӘШӘШӯЩҲЩ„ ШҘЩ„Щү ШөШұШ§Ш№Ш§ШӘ Щ…Щ…ЩҲЩ‘ЩҺЩ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш®Ш§ШұШ¬ШҢ ЩҲЩ…ШҜЩҒЩҲШ№Ш© ШҘЩ„Щү ШәШ§ЩҠШ§ШӘ.. ЩҒШӘЩҶШӘЩҒШ® ШЈЩҲШҜШ§Ш¬ ШЁЩҠЩҶ ШӯЩҠЩҶ ЩҲШӯЩҠЩҶШҢ ЩҲШӘШіЩҠЩ„ ШҜЩ…Ш§ШЎШҢ ЩҲЩҠШ«Щ…Шұ Ш§Щ„ШҜЩ… ШҜЩ…ЩӢШ§ ЩҲШ§Щ„ШЁШӨШі ШЁШӨШіЩӢШ§.. ЩҲЩҠШӘЩ… Ш°Щ„Щғ ЩғЩ„ЩҮ Ш№Щ„Щү Щ…ШұШЈЩү Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠЩҶ. ШҘЩҶ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ШЈЩҶ ЩҠШұЩү Ш°Щ„Щғ ЩғЩ„ЩҮ Ш№ШЁШұ Ш§Щ…ШӘШҜШ§ШҜ ШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҮ Ш§Щ„Ш·ЩҲЩҠЩ„ШҢ ШЁЩғЩ„ Щ…Ш§ Щ„ЩҮ ЩҲЩ…Ш§ Ш№Щ„ЩҠЩҮШҢ ЩҲШЁЩғЩ„ Щ…Ш§ ШЈШ№Ш·Щү ЩҲЩ…Ш§ ШЈШ®Ш°ШҢ ЩҲШЈЩҶ ЩҠЩҒШ№Щ„ ШҙЩҠШҰЩӢШ§ ЩҠЩ…Щ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„ЩҲШ§Ш¬ШЁ ЩҲШӘЩҒШұШ¶ЩҮ Ш§Щ„Ш¶ШұЩҲШұШ©ШҢ ЩҒЩҠ ЩғЩҠШ§ЩҶ Щ…ШӘЩ…Ш§ШіЩғШҢ ЩҠШ№ШұЩҒ ШЈШЁШ№Ш§ШҜЩҮШҢ ЩҲЩ…ШұШ§ШӯЩ„ ШөЩҠШұЩҲШұШӘЩҮ Ш№ШЁШұ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ШҢ ЩҲШіЩ…Ш§ШӘ ЩҮЩҲЩҠШӘЩҮ Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠШ© - Ш§Щ„Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШ©.. Щ„ЩҠШұЩү Ш°Ш§ШӘЩҮ ЩҒЩҠ ШЁЩҠШҰШӘЩҮШҢ ЩҲЩ…Ш§ ЩҠШӘШөЩ„ ШЁШ°Ш§ШӘЩҮ ЩҲШЁЩҠШҰШӘЩҮ Щ…ЩҶ Ш®ЩҒШ§ЩҠШ§ШҢ ЩҲЩ…Ш§ ШӘШёЩҮШұЩҮ Щ…ШұШ§ЩҠШ§ШҢ ЩҲЩ…Ш§ Щ„Ш§ ШӘШұШ§ЩҮ Ш№ЩҠЩҲЩҶ ЩҲШӘШ№ЩғШіЩҮ Щ…ШұШ§ЩҠШ§ШҢ ШҘЩҶЩҮ Щ…Ш№ЩҶЩҠЩ‘ ШЁЩғЩ„ Щ…Ш§ ЩҠШ¬ШұЩҠ Ш№Щ„Щү ШЈШұШ¶ ЩҠШ№ЩҠШҙ ЩҒЩҠЩҮШ§ШҢ ЩҲШӘШЈШ®Ш° ШЁЩ„ШіШ§ЩҶЩҮШҢ ШӯЩҠШ« ЩҠШӘЩ…Ш§ЩҮЩү Щ…Ш№ ЩғЩ„ Щ…ЩҶ ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩҲЩ…Ш§ ЩҒЩҠЩҮШ§ШҢ ЩҒЩҠ ЩғЩҠШ§ЩҶ ШөШӯЩҠЩ‘ШҢ ЩӮЩҲЩҠШҢ ШұШ§ШіШ®ШҢ ШӯЩҠЩ‘ЩҚШҢ Щ…ШіШӨЩҲЩ„. ШҘЩҶЩҮ Щ…Ш№ЩҶЩҠ ШЁЩ…ШөЩҠШұЩҮШҢ ЩҲШЁЩ…ШөЩҠШұ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶШҢ ШЁШ§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠ Ш§Щ„ШӯШ¶Ш§ШұЩҠ Ш§Щ„ШұЩҲШӯЩҠ Ш§Щ„ШҙШ§Щ…Щ„ШҢ Щ„Ш§ ШЁЩ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„Ш¬ЩҶШі ЩҲШ§Щ„Ш№ШұЩӮ ЩҲШ§Щ„ШҜЩ… ЩҲШ§Щ„Щ…Щ„Щ‘ЩҺШ©.. ЩҲШЁЩ…ШөЩҠШұ ЩғЩ„ Щ…ЩҶ ШЈШөШЁШӯ Ш§Щ„Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШҢ ШЁШ§Щ„Щ…ЩҒЩҮЩҲЩ… ЩҲШ§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„ШҙШ§Щ…Щ„ЩҠЩҶ Ш§Щ„Щ„Ш°ЩҠЩҶ ШЈШҙШұЩҶШ§ ШҘЩ„ЩҠЩҮЩ…Ш§.. ШЁШ№Ш¶ ЩғЩҠЩҶЩҲЩҶШӘЩҮ ЩҲЩҮЩҲЩҠШӘЩҮ ЩҲЩғЩҠШ§ЩҶЩҮ.Шҹ!ШҢ ЩҲШҘЩҶ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ШЈЩҶ ЩҠШұЩҒШ¶ Ш§Щ„ЩҲЩҮЩ…ЩҺШҢ ЩҲЩ…ЩӮЩҲЩ„Ш§ШӘ Щ…ЩҶ ЩҠЩҲШӯЩҲЩҶ Щ„ЩҮ ШЁЩҲЩҮЩ…ШҢ ЩҲЩҠШ№ЩҠ ШӯШ§Щ„Ш© ШөШ№ШЁШ© ЩҠШ№ЩҠШҙЩҮШ§ШҢ Щ…Ш«Щ„ ШӯШ§Щ„ Щ…ЩҶ ЩҠШ№ЩҠШҙ ЩҒЩҠ ШіШ§ЩӮ ШҙШ¬ШұШ©ШҢ Щ„Ш§ ШӘШЁШҜЩҲ Щ„ЩҮ Ш¬Ш°ЩҲШұЩӢШ§ Щ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш№Щ…ЩӮ Ш§Щ„ШЈШұШ¶ШҢ ШҙШ¬ШұЩҮ ЩҠШ¶ЩҠЩ‘ЩҺЩӮ ШЈЩҲШ№ЩҠШӘЩҮШ§ Ш§Щ„Ш¬ЩҮЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘШ¬ЩҮЩҠЩ„ШҢ Щ„ШӘШ№Ш¬ШІ Ш№ЩҶ ЩҶЩӮЩ„ ШіЩҠЩҲЩ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҺШіШә Ш§Щ„ШӯЩҠЩҲЩҠ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘШұШЁШ© ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Ш¬Ш°ЩҲШұШҢ ЩҲШ№ШЁШұ Ш§Щ„ШіШ§ЩӮ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШЁШұШ§Ш№Щ… ЩҲШ§Щ„ШЈЩҲШұШ§ЩӮ.. ШЈЩҠ ШҘЩ„Щү ШӯЩҠШ« ЩҠШӘШ¬ШҜШҜ Щ…ЩҶШ§Ш® Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ Ш§Щ„Щ…ШҙШұЩӮШҢ ЩҲШ§Щ„ЩҲШ№ЩҠ Ш§Щ„Щ…ШӘЩҲШ«ШЁШҢ ЩҲШ§Щ„Ш№ШІЩ… Ш§Щ„ЩҲШ§Ш«ЩӮ.. ЩҲЩҠШӘЩ… Ш§Щ„ШӘЩҒШ§Ш№Щ„ Щ…Ш№ ШЈШіШҰЩ„Ш© Ш§Щ„ШӯЩҠШ§Ш©ШҢ ЩҲШЈШіШҰЩ„Ш© Ш§Щ„ШўШ®Шұ ШҙШұЩҠЩғЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯЩҠШ§Ш©ШҢ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШӘЩҲШ§Щ„Щү Ш№Щ„ЩҠЩҮШҢ ЩҲЩ„Ш§ ШЁШҜЩ‘ЩҺ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘШ№Ш§Щ…Щ„ Щ…Ш№ЩҮШ§ ШЁШ«ЩӮШ© ЩҲШ§ЩӮШӘШҜШ§Шұ.