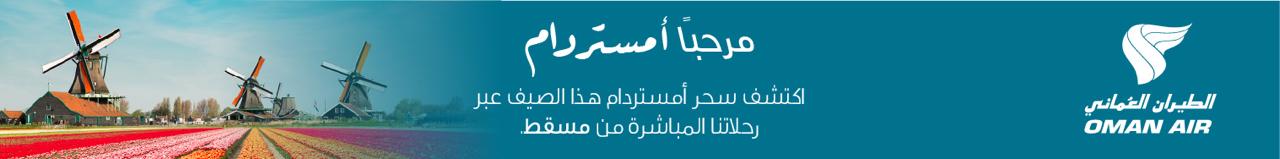نواصل في هذا العدد تقديم "اشكالية نظرية "موت المؤلف" في النصَّين القرآني والسردي" ونتطرق للمحور الثالث: كيف يمكن تبني نظرية موت المؤلف في الحقل الأدبي؟ ..1. المقاربة التاريخية لنظرية موت المؤلف:لقد رأت نظرية موت المؤلف النور لأول مرة العام 1968، وقد كانت مرتبطة بجذور فلسفية وفكرية مختلفة، وكما نادى الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه بـ (موت الإله) ودحر المنظور الغيبي لتفسير المبهم من الأمور، فقد نادى بارت بـ (موت المؤلف) عبر تغليب النص والقارىء عليه، وهنا تؤثر اللغة بدلاً من مؤلفها، فهي التي تتحدث مع القارىء، ولذلك نجد بارت يسخر ممن يضع المؤلف داخل النص ويحاول الوصول إلى أبعاده النفسية؛ فالنص عنده وسيلة اتصال لغوية ويجب البحث والانطلاق منه، أي من بنيته ودلالاته ومجازاته، ولا يجدر بنا أن نقوم بتحليله من الخارج أي عبر الكاتب ومكونات شخصيته.2. لماذا نقصي المنتِج الأول للنص؟لم ينادِ رولان بارت أبداً بإلغاء المؤلف وحذفه من الذاكرة ولكنه أراد تحرير النص المنتَج فقط من سلطته، وأراد للقارىء أن يتناساه ولا يُعطيه أهمية، ولا يكترث فقط إلا بلغة النص (text) ودلالاته لأن المؤلف لا يكتب نصه إلا من أجل القارىء، ولذلك فإننا نعمل على مزج النص بالقارىء والقارىء بالنص، ولا يتم استحضار المؤلف إلا بعد الانتهاء من قراءة النص، ويحق للقارىء هنا أن يؤول النص كيفما يريد تحت وطأة موروثه الثقافي لا بحسب ما يريد المؤلف؛ حتى قال بارت نفسه في هذا السياق: "إن نمط النقد الذي يوطد العلاقة بين النص والمؤلف قد انتهى إلى غير رجعة، وإن هناك نوعا جديدا من التحليل". ثم قال: “إن نسبة النص إلى مؤلفه معناها إيقاف النص وحصره وإعطاؤه مدلولاً نهائياً، إنها إغلاق الكتابة، فالمؤلف يتقلص وكأنه تمثال صغير على مسرح الأدب".وبناءً على ما سبق، فإن المؤلف لا يكتب من العدم المطلق ولكنه يضع اطروحاته النظرية وتصوراته الإجرائية من معارف وثقافات سابقة، وما كان دوره إلا جمع تلك المواد المعرفية بذكاء بالغ؛ فالنص يجد غناه في قدرة المؤلف على وضع النصوص السابقة في قالب جديد، لأننا إذا أسندنا النص لكاتب محدد فإننا نحصره ونعطيه مدلولاً نهائياً نغلق معه الكتابة برمتها.3. موضع اللغة (Language) في نظرية موت المؤلف:تحدث بارت عن أن اللغة هي المتحدث الرسمي داخل النص الأدبي وليس المؤلف، فهي التي تؤثر في القارىء وهو الذي يتفاعل معها. وعليه، فإن البنيويين وبارت لا يرون وجود فكرة ما قبل الكتابة لأن النص لا ينبعث إلا حين الشروع في الكتابة، ولا يُدرك ذلك إلا حين تفكيك وتحليل العمل الابداعي لغوياً وفك رموزه ومعرفة العلاقات المتكونة منه. ويؤكدون أن اللغة هي التي تتكلم وهي التي تبدع وليس مؤلفها. فالنص لديه نسيج لغوي؛ دالٌ ومدلول؛ دالٌ يتمثل في الحروف الدالة على ألفاظه ظاهرياً، ومدلولٌ وهو الجانب المتحصل عليه لغوياً وباطنياً.4. موضع التناص (Intertextuality) في نظرية موت المؤلف:يعتبر رولان بارت أن كل نص هو تناص لأنه يحتوى على مجموعة نصوص أخرى بين ثناياه، وبذلك لا يكون هناك نصٌ أصلي واحدٌ بل هناك عدد من النصوص المتداخلة، وعليه، وحسب ذلك المنظور، فإن النص نسيج من الأصوات والإشارات التي تكونه وتشكله عبر علاقات تناصية متجاورة ومتوترة، تلك العملية تدفع النص لفك ارتباطه بذات المؤلف، وفي الحقيقة فإننا نجد أن دعوة بارت لمقولة التناص قد هيأت الطريق لقيام نظرية "موت المؤلف" باعتبار المؤلف ناسخ فقط. وبهذا المعنى، يكون النص ليس مجموعة أفكار حوّلها الكاتب إلى كلمات وجمل شتّى، وليس المؤلف مبدعاً لأن النص قادم من اقتباسات من مراكز معرفية مختلفة .5. موضع القارئ في نظرية موت المؤلف:يقوم المثلث البارتي على ثلاثة مفاهيم رئيسية وهي: النص، اللغة، القارىء.. ثلاثة يموت من خلالها المؤلف بلا ريب، وهي تحتاج إلى قارىء مثقف يكشف معاني الإبداع والوصول لمرحلة لذة النص وشاعريته متجاوزاً القراءة الإسقاطية المتداولة. فما موت المؤلف إلا نتيجة لمولد هذا القارىء، فالنص ببنائه يضع المفردات والقارىء يكتشف المعاني ويكسبه الدلالات، فالقارىء منتج للنص، يصيغ النص بصورة غير مباشرة ولا يستهلكه ظاهرياً.لقد وضعت نظرية "موت المؤلف" تأثيراً كبيراً على دراسة اللسانيات والنظريات النقدية بدعوته الصريحة والجريئة إلى تكسير وتفنيد أسطورة الكاتب، وإلغاء الحواجز القدسية المفتعلة بين النص وقرائه؛ وهو ثورة في عالم الأدب؛ فالقارىء كان ولا يزال له الحرية المطلقة في فتح أو إغلاق المخيلة الدلالية وفي أحيان كثيرة بعيداً عن مدلول المؤلف.ووفقاً لبارت، فإن القارىء صار منتِجاً لا مستهلكاً للنص؛ لأنه يقوم بتفكيكه وإعادة بنائه كيف يشاء، ومن حقه تدشين حوارات صريحة أو صامتة لاستنطاق كل مفرداته، ولم يكتف بارت بذلك، بل اعتبر النقد كتابة على كتابة، ونصاً أضيف إلى نص ألبسه عدداً هائلاً من الدلالات اللامتناهية.المحور الرابع: نقد نظرية موت المؤلف:يرى المناهضون لنظرية موت المؤلف استحالة الفصل بين النص ومؤلفه، فتحليل النص ومفرداته ودلالاته جزء لا يتجزأ من كينونة الكاتب أو المبدع؛ وعليه يرون ضرورة أن يُعطى المؤلف حيزاً لأنه لا يوجد معنىً ثابتٌ للنص بينما يوجد مؤلف ثابت له، هذا المؤلف له العديد من القيم الفكرية والانسانية كوّنت مجمل ثقافته. كما أن نظرية موت المؤلف لا تؤمن بتأثير الانسان في واقعه بل اعتمدت على تأثير النص التغييري في القاريء، وهو يعطي دوراً سلبياً للمؤلف على حساب القاريء.ومن جانب آخر، يرى بارت أن المعنى لا يأتي من خارج النص (اللغة)، بل يأتي من داخل النص نفسه وهو ما يعني عدم إمكانية الوصول لمعنى نهائي للنص وجعله مفتوحا على اللانهائي، وهو أمر يجعل باب الاجتهاد مفتوحاً ويبقي النار ملتهبة دونما إخمادها.ويؤخذ على النظرية أيضاً، صعوبة تطبيقها على نص القرآن الكريم، فإنه ووفقاً للنقد البنيوي المبني على أن القرآن الكريم نصٌ لغوي؛ فإن تحليل النص القرآني يعني وجود تناص حتمي كما هي القصص الواردة فيه، وكذلك وجود دلالات ورمزيات بلاغية تتجلى فيها نظرية موت المؤلف، ولكن الاستمرار في العمل بهذه النظرية؛ يعني أن النص لا يقودنا لمعرفة الله تعالى، وأننا لا بد أن نسقطه تعالى من فكرنا حين التمعن والتدبر في ذات اللغة النصية للقرآن، وبهذا فإن القرآن الكريم يفقد قدسيته وإعجازه لأنه تحول من (المؤلف) إلى القارىء (الإنسان) .. جدير بالذكر أن هذا ما توصل إليه بعض الحداثيين ووقعوا في هذا المنزلق الخطير ومنهم محمد أركون ونصر حامد أبو زيد وقد سبقهم ابن عربي نفسه.ولا ننسى أن النظرية تبخس المؤلف حقه الفكري وجهده الكبير، فهي ترى أن كل نصه هو مجموعة اقتباسات من ذاكرة ومعارف سابقة، وهو أمر ينكره كثير ممن يعملون في مجال التأليف، باعتبار أن لكل نص مؤلفا أول قد يتم الاقتباس منه.الخاتمةاعتبر البعض نظرية موت المؤلف تعسفاً في رفع قيمة النص على حساب المؤلف وأنها نوع من الفوضى الخلاقة، وأنه لا يمكن القفز فوق المنطق العقلائي؛ فنقول كيف نسمح للغة أن تقتل الانسان، والإنسان هو من اخترع اللغة في أصلها؟ وقالوا إنها جاءت استجإبة للرؤى الفلسفية السائدة ومنها رؤية موت الإله (لنيتشه).وفي موازاة ذلك، يرى البنيويون أن هذه النظرية لها اليد الطولى على عامة المعارف والأدب خصوصاً لأنها عمدت إلى تفكيك الكثير من النصوص بحيث أظهرت دلالاتها ومجازاتها المختلفة.ومن جانبنا، فإننا نخلصُ إلى ما يلي:1. إن نظرية موت المؤلف لا يمكن تطبيقها على كل النصوص وفي كل المجالات، ففي النص العلمي مثلاً، لا يمكن أن يكون النص مجازياً دلالياً وإلا فقد معناه العلمي وتاهت الحقيقة من بين يديه.2. إن نظرية موت المؤلف ليست استعلائية فلسفية كما يراها المناهضون، ولكنها تعمد إلى الارتقاء بالقارىء، إنها تبحث عن القارىء المثقف، القارىء الموسوعي الذي يستطيع أن يدرك دلالات النص من خلال الإلمام بالمعارف والتمكن من اللغة ذاتها.3. إن نظرية موت المؤلف لاتعني أن ننسف المؤلف ونقتله، بل تعني أن نتناساه حين الشروع في القراءة، حتى تكون القراءة موضوعية علمية تعتمد على ما يرد في النص بعينه.4. إن نظرية موت المؤلف هي الحالة المثلى وربما النموذجية التي يمكننا بها معرفة علوم القرآن الكريم، فالقارىء العادي هو الذي يضع (قدسية القرآن) نصب عينيه حين القراءة، أما القاريء المبدع فهو يستنطق النص القرآني ويتدبره تبعاً لقوله تعالى ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ .. إن قراءة القرآن طبقاً لنظرية موت المؤلف ينتج عنها أولئك المفسرون المبدعون (الدلاليون) على حساب التفسير التقليدي.5. إن هذه النظرية سبب مباشر للارتقاء بمحتوى النص الأدبي، النص المجازي والدلالي، ذلك النص الذي يتحدى الموت والفناء، النص الذي يحمل المعاني المفتوحة التي يمكن لها أن تتغير بتغير المكان والزمان.6. وفقاً لنظرية موت المؤلف، فإن تقييم المؤلف يأتي بعد الانتهاء من قراءة النص، وأنه يستدل على المؤلف من نصه، ولذلك فإن إحدى الطرق الفعالة لمعرفة الله تعالى تأتي بعد التفكر في النص القرآني، وعلى الجانب الأدبي، فإن تقييم المؤلف، ومنه الروائي، يأتي من خلال دراسة النص الذي يكون سابقاً للمعرفة الكلاسيكية للمؤلف.7. لم تنصف النظرية المؤلف أبداً حين أكد بارت دوره السلبي لأنه قام بجمع المعارف قبل أن يصفها في قالب جديد، وهنا لا تفرّق النظرية بين الكاتب الناجح الذي يكتب من معارفه والكاتب المبدع الذي يكتب الجسد الخيال.8. ولكي يكون موضوع موت المؤلف قائماً، نضع السؤال التالي بين يدي القارىء الكريم: هل يمكن أن تكون النظرية البارتية فاعلة حين الشروع في أدب البوح ومنه كتابة السيرة باعتبارها قائمة على مبدأ الاعتراف الذاتي؟ وأيهما أجدر بكتابة السيرة، صاحبها ذاته أم مؤلف آخر؟ رسول درويشباحث بحريني