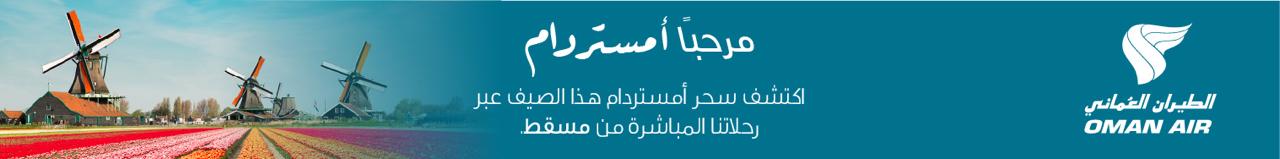Ш§ШҙШӘЩҮШұШӘ ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩҶЩӮШҜ Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠ Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§ШіЩҠЩғЩҠШ© ШЁЩ…ЩӮЩҲЩ„ШӘЩҮШ§ "ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠШҢ ЩҲЩ…ЩҶЩҮ Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ©ШҢ ЩҮЩҲ Ш§ШЁЩҶ ШҙШұШ№ЩҠЩҢ Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒЩҮШҢ ШӯЩҠШ« ШЈЩҶЩҮШ§ Щ…ШұШўШ© Щ„ЩҮШӣ ШӘШ№ЩғШі Ш«ЩӮШ§ЩҒШӘЩҮ ЩҲШЁШ№Ш¶Ш§ЩӢ Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ§ШӘЩҮШҢ ЩҲШЈЩҶЩҮ ЩҠЩ…ЩғЩҶ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҲЩӮЩҲЩҒ Ш№Щ„Щү Щ…ЩӮШұШЁШ© Щ…ЩҶ ШӘШ¬ШұШЁШ© Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ ЩҲШӘЩ…ШӯЩҠШө ШҙШ®ШөЩҠШӘЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩҒШіЩҠШ© ЩҲШЈШЁШ№Ш§ШҜЩҮШ§ Ш§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩ…Ш§Ш№ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ШЈЩҠШҜЩҠЩҲЩ„ЩҲШ¬ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҠШӘЩ…ШӯЩҲШұ ШҜЩҲШұ Ш§Щ„ЩҶШ§ЩӮШҜ ШЁШ¬Щ…Ш№ Щ…Ш№Щ„ЩҲЩ…Ш§ШӘ Щ…ШӘШ№Щ„ЩӮШ© ШЁШіЩҠШұШ© Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Щ„ЩҠШіШӘШҙЩҮШҜ ШЁЩҮШ§ ШӯЩҠЩҶ ШҜШұШ§ШіШ© Ш§Щ„ЩҶШө. ЩҲШ§ШіШӘЩ…Шұ Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ ШЁШ°Щ„Щғ ШӯШӘЩү Ш¬Ш§ШЎШӘ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ) (Death of the Author Щ„Щ„ЩҶШ§ЩӮШҜ Ш§Щ„ЩҒШұЩҶШіЩҠ Ш§Щ„ШҙЩҮЩҠШұ ШұЩҲЩ„Ш§ЩҶ ШЁШ§ШұШӘ(Ronald Barthes) ШҢ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҠ ШӘШҜШ№ЩҲ Щ„Щ„ШӘШұЩғЩҠШІ Ш№Щ„Щү Щ„ШәШ© Ш§Щ„ЩҶШө ЩҲШ№Щ„Щү Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ ЩҶЩҒШіЩҮ ШЁЩ…Ш№ШІЩ„ Ш№ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Ш§Щ„Ш°ЩҠ Щ„Щ… ШӘШ№ШҜ Щ„ЩҮ ШіЩ„Ш·Ш© ШӘЩҮЩҠЩ…ЩҶ Ш№Щ„Щү Щ…ЩҒШұШҜШ§ШӘ ЩҲЩ…Ш№Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШөЩҮ ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШҢ ШӯШӘЩү ЩӮШ§Щ„ ШЁШ§ШұШӘ ЩҒЩҠ Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„ШіЩҠШ§ЩӮ: ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Щ…Щ…Ш§ШұШіШ© ШҜЩ„Ш§Щ„ЩҠШ© ЩҠЩҲШёЩҒ ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩғЩ„ Ш·Ш§ЩӮШ§ШӘЩҮ ШЁЩ„Ш§ ШӘЩҲЩӮЩҒ ЩҲЩ„Ш§ ШЈЩҶШ§Ш©ШҢ ЩҒЩҠШөШЁШӯ Ш§Щ„ЩҶШө ШӘЩҶШ§ШөШ§ЩӢШҢ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҶШ§Шө ЩҮЩҲ ШӯШ¶ЩҲШұ ЩҒШ№Щ„ЩҠ Щ„ЩҶШө ЩҒЩҠ ЩҶШө ШўШ®Шұ ЩҠЩӮШҜЩ… ШіЩҠШұЩҲШұШ© Ш§Щ„ШҘЩҶШӘШ§Ш¬ Ш№ШЁШұ Щ„ШәШ© Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШЎ.ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ЩҮШ°ЩҠЩҶ Ш§Щ„Ш§ШӘШ¬Ш§ЩҮЩҠЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӘШЁШ§Ш№ШҜЩҠЩҶ ШӯШҜЩ‘ Ш§Щ„ШӘЩҶШ§ЩӮШ¶ШҢ ЩҶШӯШ§ЩҲЩ„ Ш§Щ„Ш®ЩҲШ¶ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ…ШӯЩҠШө ЩҒЩҠ ЩҶШёШұЩҠШ© "Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ"ШҢ ЩҲЩҶШӯШ§ЩҲЩ„ ШЈЩҠШ¶Ш§ЩӢ ШҘШіЩӮШ§Ш·ЩҮШ§ Ш№Щ„Щү ЩҶШөЩ‘ЩҠЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒЩҺЩҠЩҶ ЩҲШұШЁЩ…Ш§ Щ…ШӘШЁШ§Ш№ШҜЩҺЩҠЩҶ Ш¬ШҜШ§ЩӢШҢ ЩҲЩ„Ш°Щ„ЩғШҢ ЩҒШҘЩҶЩҶШ§ ШіЩҶЩӮШіЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ ШҘЩ„Щү ШЈШұШЁШ№Ш© Щ…ШӯШ§ЩҲШұШҢ ЩҲШіЩҠЩғЩҲЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӯЩҲШұ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ Ш§ШіШӘШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ЩӢ Щ…ЩҶ ШўЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…ШҢ ЩҲШ§Щ„Щ…ШӯЩҲШұ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШұЩҲШ§ЩҠШ© "ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„" Щ„Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„ШіШ№ЩҲШҜЩҠ ШҜ. Щ…ЩҶШ°Шұ Ш§Щ„ЩӮШЁШ§ЩҶЩҠШҢ ЩҲШ§Щ„Ш«Ш§Щ„Ш« ЩҠШЁШӯШ« Ш№ЩҶ ШҘЩ…ЩғШ§ЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ШҘЩҠЩ…Ш§ЩҶ ЩҲШ§Щ„Ш№Щ…Щ„ ШЁЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„Ш¬ШҜЩ„ЩҠШ©. ШЈЩ…Ш§ Ш§Щ„ШұШ§ШЁШ№ ЩҒЩҠШ®ШөШө Щ„ШўШұШ§ШЎ Ш§Щ„ЩҶЩӮШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш®Ш§Щ„ЩҒЩҠЩҶ Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ.ШҘЩҶЩҶШ§ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ Ш§Щ„ШӯШіЩ‘Ш§ШіШҢ ЩҶШӯШ§ЩҲЩ„ ШЈЩҶ ЩҶШ¶Ш№ Щ…ЩӮШ§ШұШЁШ© ЩҒЩғШұЩҠШ© Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШӘШ·ШЁЩҠЩӮ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© ЩҲЩҶЩӮЩҠШ¶ЩҮШ§ Ш№Щ„Щү ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„Щ…ЩҶШӘЩӮШ§Ш©ШҢ ЩҲЩҶШ·ШұШӯ ШӘШӯЩ„ЩҠЩ„Ш§ЩӢ Щ…ШЁШіШ·Ш§ЩӢ ШӯЩҲЩ„ ШӘШЈШөЩҠЩ„ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ .. ЩҲЩҮЩ„ ЩҠЩҸШ№ШҜ Щ…ШөШ·Щ„ШӯЩҸ Щ…ЩҲШӘЩҗ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Щ…ЩҶЩҮШ¬Ш§ЩӢ ШҘШ¬ШұШ§ШҰЩҠШ§ЩӢ ШөШұЩҒШ§ЩӢ ШЈЩ… ШЈЩҶЩҮШ§ ШҘШҙЩғШ§Щ„ЩҠШ© ЩҒЩғШұЩҠШ© ЩҒЩ„ШіЩҒЩҠШ© ЩҒЩӮШ· ШӘЩ…Ші Ш¬Щ…ЩҠШ№ Ш§Щ„Щ…ШіШӘЩҲЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠШ©ШҹШ§Щ„Щ…ШӯЩҲШұ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„: Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…- Ш§Щ„Щ…Ш«Ш§Щ„ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„: ЩӮШ§Щ„ ШӘШ№Ш§Щ„Щү ЩҒЩҠ Щ…Ш·Щ„Ш№ ШіЩҲШұШ© Ш§Щ„ШЁЩӮШұШ© пҙҝШ§Щ„Щ…ШҢ Ш°ЩҺЩ„ЩҗЩғЩҺ Ш§Щ„Щ’ЩғЩҗШӘЩҺШ§ШЁЩҸ Щ„ЩҺШ§ ШұЩҺЩҠЩ’ШЁЩҺ ЩҒЩҗЩҠЩҮЩҗ ЩҮЩҸШҜЩӢЩү Щ„ЩҗЩ„Щ’Щ…ЩҸШӘЩҺЩ‘ЩӮЩҗЩҠЩҶЩҺШҢ Ш§Щ„ЩҺЩ‘Ш°ЩҗЩҠЩҶЩҺ ЩҠЩҸШӨЩ’Щ…ЩҗЩҶЩҸЩҲЩҶЩҺ ШЁЩҗШ§Щ„Щ’ШәЩҺЩҠЩ’ШЁЩҗ ЩҲЩҺЩҠЩҸЩӮЩҗЩҠЩ…ЩҸЩҲЩҶЩҺ Ш§Щ„ШөЩҺЩ‘Щ„ЩҺШ§Ш©ЩҺ ЩҲЩҺЩ…ЩҗЩ…ЩҺЩ‘Ш§ ШұЩҺШІЩҺЩӮЩ’ЩҶЩҺШ§ЩҮЩҸЩ…Щ’ ЩҠЩҸЩҶЩ’ЩҒЩҗЩӮЩҸЩҲЩҶЩҺпҙҫ .. ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ШӘЩ…Ш№ЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШўЩҠШ© Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…Ш©ШҢ ЩҶШ¬ШҜ ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӯШұЩҲЩҒ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ЩӮШ·Ш№Ш© ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШ§ ЩҮЩҠ Щ…ЩҲШ¶Ш№ Ш§Ш®ШӘЩ„Ш§ЩҒ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҒШіШұЩҠЩҶШҢ ЩҒЩӮЩҠЩ„ ШҘЩҶЩҮШ§ Щ…ЩҶ Ш№Щ„Щ… Ш§Щ„ШәЩҠШЁ ШӯЩҠШ« Щ„Ш§ ЩҠШ·Щ„Ш№ Ш№Щ„Щү ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШ§ ШәЩҠШұ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҲЩӮЩҠЩ„ ШҘЩҶЩҮШ§ ШЈШіЩ…Ш§ШЎ Щ…ЩҶ ШЈШіЩ…Ш§ШЎ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩүШҢ ЩҲЩӮЩҠЩ„ ШҘЩҶЩҮШ§ Щ…ЩҶ ШЈШіЩ…Ш§ШЎ Ш§Щ„ЩҶШЁЩҠ Щ…ШӯЩ…ШҜ (Шө) ШҢ ЩҲЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҖ (ЩӮЩҠЩ„) ШӘЩҒШӘШӯ Ш§Щ„ЩҶШө Щ„ШЁШ§ШЁ Ш§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩҮШ§ШҜШҢ ШЈЩҠ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶЩҠ ЩҲШЁШӯШіШЁ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ ШөШ§Шұ Щ…ЩҒШӘЩҲШӯШ§ЩӢ Щ„Ш¬Щ…ЩҠШ№ Ш§Щ„Ш§ШӯШӘЩ…Ш§Щ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘШҢ ЩҲШӘШ№Ш·ЩҠ Ш§Щ„ШӯЩӮ Щ„Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҜЩҠ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҒЩғШұ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҒШіШұ Ш§Щ„Щ…ШӘШЁШӯШұ ЩҲШ§Щ„Щ…ШЁШҜШ№ ШЈЩҶ ЩҠШіШӘЩҶШ·ЩӮ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҲЩҠШ№ШұЩҒ Щ…Ш¬Ш§ШІШ§ШӘЩҮШҢ ЩҲЩҠШ№ЩҠ ШЁШ№ШҜ Ш§ЩҶШӘЩҮШ§ШҰЩҮ Щ…ЩҶ ЩӮШұШ§ШЎШ© Ш§Щ„ЩҶШө (Ш§Щ„ШўЩҠШ©) ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ„ШәШ© ЩғШ§ЩҶШӘ ШҘЩ„ЩҮЩҠШ© ШәЩҠШұЩҺ ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ©ШҢ ЩҲШЈЩҶ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„Щү Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Щ„Ш§ ЩҠШ®Ш§Ш·ШЁ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ШЁШЈШҙЩҠШ§ШЎ Щ„Ш§ ЩҠШұЩҠШҜ ШЈЩҶ ЩҠШ№ШұЩҒЩҲЩҮШ§ ЩҲЩҠШ·Щ„Ш№ЩҲШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ШЁЩ„ ЩҠШӯШ«ЩҮЩ… Ш№Щ„Щү ШӘШҜШЁШұ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶШӣ ЩҒЩӮШ§Щ„ ЩҒЩҠ ШіЩҲШұШ© Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш§Щ„ШўЩҠШ© 24 пҙҝШЈЩҺЩҒЩҺЩ„ЩҺШ§ ЩҠЩҺШӘЩҺШҜЩҺШЁЩҺЩ‘ШұЩҸЩҲЩҶЩҺ Ш§Щ„Щ’ЩӮЩҸШұЩ’ШўЩҶЩҺ ШЈЩҺЩ…Щ’ Ш№ЩҺЩ„ЩҺЩү ЩӮЩҸЩ„ЩҸЩҲШЁЩҚ ШЈЩҺЩӮЩ’ЩҒЩҺШ§Щ„ЩҸЩҮЩҺШ§ пҙҫ ЩҲШ№Щ„ЩҠЩҮ ЩҠЩ…ЩғЩҶЩҶШ§ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩҶШіШЁ Щ„ЩҒЩҮЩ… ШўЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… ЩҮЩҠ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ ЩҲЩ„ЩҠШі Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§ШіЩҠЩғЩҠШ©. ЩҲШЁШ§Щ„Ш№ЩҲШҜШ© Щ„Щ„ШўЩҠШ© Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ…Ш©ШҢ ЩҶШ¬ШҜ ЩӮЩҲЩ„ЩҮ "ЩҮШҜЩү Щ„Щ„Щ…ШӘЩӮЩҠЩҶШҢ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ ..." ЩҒЩҠЩҮ ШҜЩ„Ш§Щ„Ш© ЩҲШ§Ш¶ШӯШ© ШЈЩҶЩҮ Щ„Щ… ЩҠЩғЩҶ Ш§Щ„ШәШұШ¶ Щ…ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШўЩҠШ§ШӘ ШЈЩҶ ЩҠШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Щ„ЩҶШ§ Щ…Ш§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш·ШЁЩҠШ№Ш© Щ…ЩҶ ШӯЩӮШ§ШҰЩӮ Ш№Щ„Щ…ЩҠШ©Шӣ Щ„ШЈЩҶ Ш°Щ„Щғ Щ…ЩҲЩғЩҲЩ„ Щ„Ш№ЩӮЩ„ Ш§Щ„Ш§ЩҶШіШ§ЩҶ ЩҲШӘШ¬Ш§ШұШЁЩҮШҢ ЩҲШҘЩҶЩ…Ш§ Ш§Щ„ЩҮШҜЩҒ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ Щ…ЩҶ Ш°ЩғШұЩҮШ§ ЩҮЩҲ ШЈЩҶ ЩҶШіШӘШұШҙШҜ ШЁШ§Щ„ЩғЩҲЩҶ ЩҲЩҶШёШ§Щ…ЩҮ ШҘЩ„Щү ЩҲШ¬ЩҲШҜ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮШҢ ЩҲШҘЩҶЩ…Ш§ ЩҠШҜШұЩғ Щ…ЩҶЩҮШ§ ЩғЩ„ЩҸ Ш№Ш§Щ„Щ… (ЩӮШ§ШұЩүШЎ) Щ…Ш§ ШӘШӘШіШ№ Щ„ЩҮ Щ…ШӨЩҮЩ„Ш§ШӘЩҮ ЩҲЩ…ЩҲШ§ЩҮШЁЩҮШҢ ЩҒШҘЩҶ Ш§ЩғШӘШҙЩҒ Ш№Ш§Щ„ЩҗЩ…ЩҢ Щ…Ш№ЩҶЩү Щ…ЩҶЩҮШ§ ЩҒШҘЩҶЩҮ ЩҠЩғШӘШҙЩҒ Ш·ШұЩҒШ§ЩӢ Щ…ЩҶ ШЈШ·ШұШ§ЩҒЩҮ ЩҒЩӮШ·.ЩҲЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҒШіЩҠШұ Ш§Щ„ЩғШ§ШҙЩҒШҢ ЩҠШ¶ЩҠЩҒ Щ…ШәЩҶЩҠШ© ЩӮЩҲЩ„ЩҮ: " ШҘЩҶЩҠ Щ…Ш§ Щ…Ш¶ЩҠШӘ ЩҒЩҠ ШӘЩҒШіЩҠШұ Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ ШҘЩ„Ш§ ЩӮЩ„ЩҠЩ„Ш§ЩӢШҢ ШӯШӘЩү ШЈЩҠЩӮЩҶШӘ ШЈЩҶ ШЈЩҠ Щ…ЩҸЩҒШіЩҗШұ Щ„Ш§ ЩҠШЈШӘЩҠ ШЁШ¬ШҜЩҠШҜ Щ„Щ… ЩҠЩҸШіШЁЩҺЩӮ ШҘЩ„ЩҠЩҮШҢ ЩҲЩ„ЩҲ ШЁЩҒЩғШұШ© ЩҲШ§ШӯШҜШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҒШіЩҠШұ ЩғЩ„ЩҮ ЩҠШ®Ш§Щ„ЩҒ ЩҒЩҠЩҮШ§ Щ…ЩҺЩҶ ШӘЩӮШҜЩ…ЩҮ Щ…ЩҶ ШЈЩҮЩ„ Ш§Щ„ШӘЩҒШіЩҠШұШҢ ШҘЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩҒШіШұ Щ„Ш§ ЩҠЩ…Щ„Щғ Ш№ЩӮЩ„Ш§ЩӢ ЩҲШ§Ш№ЩҠШ§ЩӢ ЩҲШҘЩҶЩ…Ш§ Ш№ЩӮЩ„Ш§ЩӢ ЩӮШ§ШұШҰШ§ЩӢ"Щ…ЩҶ ЩҮЩҶШ§ ЩҶШҜШұЩғШҢ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶЩҠ Щ…ЩҒШӘЩҲШӯ Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘШҢ ЩҲШЈЩҶЩҮ ЩҠЩ…ЩғЩҶ Щ…Ш№ШұЩҒШ© ЩӮШҜШіЩҠШӘЩҮ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩҶШө Ш°Ш§ШӘЩҮШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Щ…Ш«ЩӮЩҒ Ш§Щ„ЩҶЩҮЩ… ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҒШіЩҗШұ Ш§Щ„Щ…ШЁШҜШ№ШҢ ЩҲШҘЩҶЩҮ ЩҠЩ…ЩғЩҶЩҶШ§ Щ…Ш№ШұЩҒШ© Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„Щү Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЁЩ„ЩҠШәШҢ ЩҲЩҮЩҲ ЩӮЩҲЩ„ЩҢ ЩҠШӘЩҶШ§ШіШЁ ЩҒЩҠ ШҘШ·Щ„Ш§ЩӮЩҮ Щ…Ш№ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ.- Ш§Щ„Щ…Ш«Ш§Щ„ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ: ШіЩҲШұШ© Ш§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ ЩҲЩҶЩӮЩҠШ¶ЩҮШ§:ЩҲЩҒЩҠ Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„ШіЩҠШ§ЩӮШҢ ЩҠЩ…ЩғЩҶЩҶШ§ ШЈЩҠШ¶Ш§ЩӢ ШЈЩҶ ЩҶШіШӘШҙЩҮШҜ ШЁЩ…Ш«Щ„ ШўШ®ШұШҢ ЩҲШЈЩҶ ЩҶЩӮЩҒ ШЈЩ…Ш§Щ… ЩҶШөЩ‘ЩҠЩҶ ШўШ®ШұЩҠЩҶ Щ„Щ…Ш№ШұЩҒШ© Ш§Щ„ШәШ« ЩҲШ§Щ„ШіЩ…ЩҠЩҶ.. ЩҲЩҶШіШӘШ°ЩғШұ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩӮШөШ© Ш§Щ„Щ…ШҙЩҮЩҲШұШ©ШҢ ЩҒЩ„Щ…Ш§ ШЁЩ„Шә Щ…ШіЩҠЩ„Щ…Ш©ЩҺ Ш§Щ„ЩғШ°Ш§ШЁ ШіЩҲШұШ©ЩҸ Ш§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ пҙҝ ШҘЩҗЩҶЩҺЩ‘Ш§ ШЈЩҺШ№Щ’Ш·ЩҺЩҠЩ’ЩҶЩҺШ§ЩғЩҺ Ш§Щ„Щ’ЩғЩҺЩҲЩ’Ш«ЩҺШұЩҺШҢ ЩҒЩҺШөЩҺЩ„ЩҗЩ‘ Щ„ЩҗШұЩҺШЁЩҗЩ‘ЩғЩҺ ЩҲЩҺШ§ЩҶЩ’ШӯЩҺШұЩ’ШҢ ШҘЩҗЩҶЩҺЩ‘ ШҙЩҺШ§ЩҶЩҗШҰЩҺЩғЩҺ ЩҮЩҸЩҲЩҺ Ш§Щ„Щ’ШЈЩҺШЁЩ’ШӘЩҺШұ пҙҫ Ш§ШҜЩ‘Ш№Щү ШЈЩҶЩҮ ШЈЩҸЩҶШІЩ„ЩҺ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ЩӮШұШўЩҶЩҢ ШўШ®Шұ .. ЩҒЩӮЩҠЩ„ Щ„ЩҮ : ЩҲЩ…Ш§ ШЈЩҸЩҶШІЩ„ЩҺ Ш№Щ„ЩҠЩғШҹ ЩҒЩӮШ§Щ„: ШЈЩҸЩҶШІЩ„ЩҺ Ш№Щ„ЩҠЩ‘ ШіЩҲШұШ©ЩҸ Ш§Щ„ЩҲШӯЩҲШ§Шӯ .. Ш«Щ… ШӘЩ„Ш§ ШҘЩҒЩғЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮЩ… ЩҒЩӮШ§Щ„:(ШҘЩҶШ§ ШЈШ№Ш·ЩҠЩҶШ§Щғ Ш§Щ„ЩҲШӯЩҲШ§ШӯШҢ ЩҒШөЩ„ Щ„ШұШЁЩғ ЩҲШ§ШұШӘШ§ШӯШҢ ШҘЩҶ ШұШЁЩғ ЩҮЩҲ Ш§Щ„Ш®ШұЩҲЩҒ Ш§Щ„ЩҶШ·Ш§Шӯ).ШҘЩҶ Ш§Щ„ШӘШЈЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШўЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Ш«Щ„Ш§Ш« Щ„ШіЩҲШұШ© Ш§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ ЩҠШұШіЩ… ШөЩҲШұШ© Щ„Ш§ Щ…ШӘЩҶШ§ЩҮЩҠШ© Щ„ШҜЩү Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎШҢ ЩҒЩ„ЩҒШё Ш§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„ШҘШ№ШұШ§ШЁ Щ…ЩҒШ№ЩҲЩ„ Ш«Ш§ЩҶ Щ„Щ„ЩҒШ№Щ„ ШЈШ№Ш·ЩҠЩҶШ§ЩғШҢ ЩҲЩ…ЩҒШ№ЩҲЩ„ Ш§ЩҶШӯШұ Щ…ШӯШ°ЩҲЩҒШҢ ШЈЩҠ Ш§ЩҶШӯШұ Ш¶ШӯЩҠШӘЩғ.. ЩҒШ§Щ„ШӘШұЩғЩҠШЁ Ш§Щ„ШЁЩҶЩҠЩҲЩҠ (structure) ЩҒЩҠ Ш°Ш§ШӘЩҮ ЩҠШҜЩҒШ№ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШӘЩҒЩғШұ ЩҲЩ…ШӯШ§ЩҲЩ„Ш© ЩҲШ¶Ш№ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ§ШӘ Щ„Щ„ЩҶШө Ш§Щ„Щ…ЩҒШӘЩҲШӯ. ЩҲШЈЩ…Ш§ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШ§ШӯЩҠШ© Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„ЩҠШ©ШҢ ЩҒШ§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ ЩҮЩҲ Щ…ШЁШ§Щ„ШәШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШ«ШұШ©ШҢ ЩҲШ§Ш®ШӘЩ„ЩҒЩҲШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШұШ§ШҜ Щ…ЩҶЩҮШҢ ЩҒЩӮШ§Щ„ЩҲШ§ (ШЈЩҠ ШЈЩҶЩҮЩ… ЩҒШӘШӯЩҲШ§ Ш§Щ„ЩҶШө Щ„Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„denotation ) ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩғЩҲШ«Шұ ЩҮЩҲ Ш¬Щ…ЩҠШ№ ЩҶШ№Щ… Ш§Щ„Щ„ЩҮШҢ ЩҲЩӮШ§Щ„ЩҲШ§ ШҘЩҶЩҮ ЩҶЩҮШұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬ЩҶШ©ШҢ ЩҲЩӮШ§Щ„ЩҲШ§ ШҘЩҶЩҮ Ш§Щ„Ш®ЩҠШұ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ШЈШ№Ш·Ш§ЩҮ Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„Щү Щ„ЩҶШЁЩҠЩҮ Щ…ШӯЩ…ШҜ (Шө) ЩҲЩҠШұШ§ЩҮ Ш§Щ„Ш·ШәШ§Ш© Щ„Ш§ ШҙЩҠШЎ ШЈШЁШҜШ§ЩӢ.. ЩҲЩҶЩ„Ш§ШӯШё ЩҮЩҶШ§ Ш§ЩҶЩҒШӘШ§Шӯ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„ЩҠ Ш№ШЁШұ Ш§ШіШӘШ®ШҜШ§Щ… Ш§Щ„Щ…Ш¬Ш§ШІ ЩҲЩӮШЁЩҲЩ„ЩҮ Щ„Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„Щ…ЩҒШұШҜШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШӯЩҲЩҠШ© ЩҲЩ…ЩҶ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү. Ш«Щ… Ш¬Ш§ШЎШӘ ШўЩҠШ© (ЩҒШөЩ„ Щ„ШұШЁЩғ ЩҲШ§ЩҶШӯШұ)ШҢ ЩҒШ§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ЩҮЩҠ Ш§Щ„ЩҒШ№Щ„ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩӮЩҲЩ… ШЁЩҮ Ш§Щ„Щ…ШіЩ„Щ…ШҢ ЩҲЩҮЩҠ Ш№Щ„Ш§ЩӮШ© Ш§Щ„ШөЩ„Ш© ШЁШ®Ш§Щ„ЩӮЩҮШҢ ЩҲЩҮЩҠ ЩҲШіЩҠЩ„Ш© Ш§Щ„ШҙЩғШұ ... ЩҲШ§Щ„ЩҶШӯШұ Ш¬Ш§ШЎШӘ ШЁЩ…Ш№Ш§ЩҶЩҠ Ш§Щ„Ш°ШЁШӯ ЩҲШұЩҒШ№ Ш§Щ„ЩҠШҜЩҠЩҶ ШӯШ°Ш§ШЎ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҮ Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„ШөЩ„Ш§Ш© ... ЩҲШ§Щ„ШЈШЁШӘШұ ЩҮЩҲ Ш§Щ„Щ…ЩӮШ·ЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШіЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘШ§ШұЩғ Щ„ЩғШӘШ§ШЁ Ш§Щ„Щ„ЩҮ.. ЩҶЩ„Ш§ШӯШё ШЈЩҶ ЩғЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„Щү ЩғШ«ЩҠШұ Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш¬Ш§ШІ ЩҲЩ„Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШӘШ¬Ш§ЩҲШІ Ш§Щ„ШЁЩ„Ш§ШәШ© ЩҒЩҠ ШӘШұШіЩҠШ® Ш§Щ„ШөЩҲШұШ© ЩҒЩҠ Ш№ЩӮЩ„ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎШҢ ЩҒШ§Щ„ЩҶШӯШұ ЩҠШҙШЁЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩҮШұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘШҜЩҒЩӮ Ш§Щ„ЩҶШ§ШӘШ¬ Ш№ЩҶЩҮШҢ ЩҲШ§Щ„ШЈШЁШӘШұ ШҘЩҶЩ…Ш§ Ш¬Ш§ШЎ Щ„ЩҒШёШ§ЩӢ ЩҒЩҠ ШўШ®Шұ Ш§Щ„ШіЩҲШұШ© Щ„ЩҠШ№Ш·Щү Щ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„Ш§ЩҶЩӮШ·Ш§Ш№ Щ„Щ„ШӘШҜЩҒЩӮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Ш§ШІЩҠ ЩҲЩ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШіЩҲШұШ© Щ„ЩҒШёШ§ЩӢ .. ШҘЩҶЩғ ШӘШ¬ШҜ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶЩҠ ШҜШ§ШҰЩ… Ш§Щ„Ш§ЩҶЩҒШӘШ§Шӯ Щ„Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ ЩҲШ§Щ„Ш§Ш¬ШӘЩҮШ§ШҜ ЩҲЩҮШ°Ш§ Щ…Ш§ ШЈШ№Ш·Ш§ЩҮ Ш№ШёЩ…Ш© ЩҲЩӮШҜШіЩҠШ© ШӘШҜЩҒШ№ ШәЩҠШұ Ш§Щ„Щ…ШіЩ„Щ… ЩӮШЁЩ„ Ш§Щ„Щ…ШіЩ„Щ… Щ„Щ„ШӘЩҒЩғШұ ЩҒЩҠЩҮ ЩҲШ§Щ„ШӘШөШҜЩҠЩӮ ШЁЩҮШҢ ЩҒЩҮЩҲ ЩҶШөЩҢ Щ…ШӘШұШ§ШЁШ· Ш§Щ„Щ…ЩҒШұШҜШ§ШӘ Щ…ЩҒШӘЩҲШӯ Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘШҢ ЩҠШӯЩҠЩ„Щғ ШҘЩ„Щү Щ…Ш№ШұЩҒШ© ЩӮШҜШіЩҠШ© Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҲШЈЩҶЩҮ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШҘШ·Щ„Ш§ЩӮ Щ„ЩҠШі ШЁЩғЩ„Ш§Щ… ШЁШҙШұ.ЩҲШ№ЩҶШҜ Щ…ЩӮШ§ШұЩҶШ© Ш§Щ„ШўЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШіШ§ШЁЩӮШ© Щ…Ш№ (ШўЩҠШ§ШӘ) Щ…ШіЩҠЩ„Щ…Ш© Ш§Щ„ЩғШ°Ш§ШЁШҢ ЩҒШҘЩҶЩҶШ§ ЩҶШ¬ШҜ ШЈЩҶЩҮ ШӘЩҶШ§Шө ШӘШұШ§ШҜЩҒЩҠ ЩҠШөЩ„ Щ„ШӯШҜ Ш§Щ„ШіШұЩӮШ© Ш§Щ„Щ„ЩҒШёЩҠШ© Ш§Щ„ЩҒШ§Ш¶ШӯШ© ШӯЩҠШ« Ш§ШіШӘШ®ШҜШ§Щ… Ш°Ш§ШӘ Ш§Щ„Щ…ЩҒШұШҜШ§ШӘ (ШҘЩҶШ§ ШЈШ№Ш·ЩҠЩҶШ§ЩғШҢ ЩҒШөЩ„ Щ„ШұШЁЩғ)Шӣ ЩҲЩҮЩҲ Щ…Ш§ ЩҠШ¶Ш№ЩҒ Ш§Щ„ЩҶШө ШӯШіШЁ ЩҶШёШұЩҠШ© Щ…ЩҲШӘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒШҢ Щ„ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӘЩҶШ§Шө Ш№ЩҶШҜ ШЁШ§ШұШӘ ЩӮШ§ШҰЩ… Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш© ЩҲШ§Щ„Щ…Ш¬Ш§ШІ Щ„Ш§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШіШұЩӮШ© Ш§Щ„ШӯШұЩҒЩҠШ©ШҢ ЩҲШЁШ§Щ„ШӘЩ…ШӯЩҠШө ЩҒЩҠ ЩҶШө Щ…ШіЩҠЩ„Щ…Ш© ЩҒШҘЩҶЩҶШ§ ЩҶШ¬ШҜЩҮ ЩҮЩғШ°Ш§: Ш§Щ„ЩҲШӯЩҲШ§Шӯ Щ…ЩҒШ№ЩҲЩ„ ШЁЩҮ ШёШ§ЩҮШұЩҠ ШЁЩ…Ш№ЩҶЩү Ш§Щ„ШҙШҜШ© ЩҲШ§Щ„ШЁШЈШі ЩҲШ§Щ„ЩӮЩҲШ©ШҢ ЩҲШ§ШұШӘШ§Шӯ ЩҒШ№Щ„ ШЈЩ…ШұШҢ Ш§Щ„Ш®ШұЩҲЩҒ Ш®ШЁШұ ШҘЩҶЩ‘ ЩҲШ§Щ„Щ…ШұШӘШ§Шӯ ШөЩҒШ© Щ„ЩҮШ§Шӣ ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„Щ…ЩғЩҲЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШўЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШІШ№ЩҲЩ…Ш© ЩҮЩҠ ШЈЩ„ЩҒШ§ШёЩҢ Щ…ШәЩ„ЩӮШ© Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„ШӘШұЩғЩҠШЁ Ш§Щ„ЩҶШӯЩҲЩҠ ЩҲШ§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„ЩҠШҢ ЩҒЩ„Ш§ ШӘШӘШұЩғ Щ„Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Щ…ШЁШҜШ№ ШЈЩҶ ЩҠЩ„ЩҮШ« Ш®Щ„ЩҒ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ЩҶЩҠ ЩҲШ§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘШҢ ЩҒЩ„ЩҠШі ЩҮЩҶШ§Щғ Щ…Ш¬Ш§ШІ ЩҲЩ„ЩҠШі ЩҮЩҶШ§Щғ ЩҶШөЩҢ Щ…ЩҒШӘЩҲШӯ. ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Щ…ШЁШҜШ№ (ШӯШіШЁ ШЁШ§ШұШӘ) ЩҮЩҲ Ш§Щ„ЩӮШ§ШҜШұ Ш№Щ„Щү ШЈЩҶ ЩҠШөЩ„ Щ„Щ…Ш№ШұЩҒШ© Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„ШӘШ№Ш§Ш·ЩҠ Щ…Ш№ Ш§Щ„ЩҶШөШҢ ШЈЩ…Ш§ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Ш№Ш§ШҜЩҠ ЩҒЩҮЩҲ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШ№ШұЩҒ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Ш«Щ… ЩҠШҜШұЩғ Ш§Щ„ЩҶШө.ЩҲШЁЩ…Ш§ ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӯШҜЩҠШ« Щ…Ш§ЩҠШІШ§Щ„ ЩҒЩҠ ЩҶШ·Ш§ЩӮ ШЈЩ„ЩҒШ§Шё Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶ Ш§Щ„ЩғШұЩҠЩ… ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШҢ ЩҠШ¬ШҜШұ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ШЈЩҶ ЩҮЩҶШ§Щғ Щ…ЩҶШ·ЩӮШ© Щ…ШҙШӘШұЩғШ© ШЁЩҠЩҶ ШҜЩ„Ш§Щ„Ш© Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩӮШұШўЩҶЩҠ ЩҠШӘШҙШ§ШұЩғШ§ЩҶ ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩғЩ…Ш§ ЩҠШіШӘЩӮЩ„ ЩғЩ„ Щ…ЩҶЩҮЩ…Ш§ ЩҒЩҠЩҮШ§ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШўШ®ШұШҢ ШӘЩ„Щғ Щ…ЩҶШ·ЩӮШ© Ш§Щ„ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„Щ…ШӘШ№Щ„ЩӮШ© ШЁШұШӨЩҠШ© Ш§Щ„Щ„ЩҮ ШіШЁШӯШ§ЩҶЩҮ ЩҲШӘШ№Ш§Щ„ЩүШҢ ЩҠШҜЩ„ Ш§Щ„ШҜЩ„ЩҠЩ„ Ш§Щ„Ш№ЩӮЩ„ЩҠ Ш№Щ„Щү Ш§ШіШӘШӯШ§Щ„ШӘЩҮШ§ШҢ ЩҲЩғШ°Щ„Щғ ЩҠШҜЩ„ Ш§Щ„ШҜЩ„ЩҠЩ„ Ш§Щ„ЩҶЩӮЩ„ЩҠ Ш§Щ„ШіЩ…Ш№ЩҠШҢ ЩҲЩ„ЩҠШі ШЈШӯШҜЩҮЩ…Ш§ ШЁШЈШіШЁЩӮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШўШ®Шұ ЩҲЩ„Ш§ ШЈЩҲЩ„Щү Щ…ЩҶЩҮ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„Ш©ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶЩҮЩ…Ш§ Щ…ШӘШіШ§ЩҲЩҠШ§ЩҶ.Ш§Щ„Щ…ШӯЩҲШұ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ: ШұЩҲШ§ЩҠШ© "ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„"ШЈЩҲЩ„Ш§ЩӢ: Щ„Ш§ШЁШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӯШҜЩҠШ« ШЁШ§Ш®ШӘШөШ§Шұ ШӯЩҲЩ„ ШұЩҲШ§ЩҠШ© "ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„" Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШҜЩҲШұ ШЈШӯШҜШ§Ш«ЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш№ШөШұЩҺЩҠЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒЩҠЩҶ ЩҲЩ…ШӘШЁШ§Ш№ШҜЩҠЩҶШҢ ЩӮШөШ© Щ…Ш№Ш§ШөШұШ© ШӘШіЩҠШұ ЩҒЩҠ Щ…ЩҲШ§ШІШ§Ш© ЩӮШөШ© ЩӮШҜЩҠЩ…Ш© Ш¬ШҜШ§ЩӢШҢ ШЁШ·Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөШ© Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШөШұШ© ЩҮЩҲ ЩҶШ№ЩҠЩ… Ш§Щ„ЩҲШІШ§ЩҶ Ш§Щ„ШӘШ§Ш¬Шұ Ш§Щ„ШҙШ§ШЁ Ш§Щ„ШіШ№ЩҲШҜЩҠ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШіШ§ЩҒШұ Щ„Щ„Щ…ШәШұШЁ Щ„Щ„ЩӮШ§ШЎ ШЈШіШӘШ§Ш°ЩҮ Ш§Щ„Ш¬Ш§Щ…Ш№ЩҠ Ш§Щ„ШіШ§ШЁЩӮ ШҜ. Ш№ШЁШҜШ§Щ„ЩӮШ§ШҜШұШҢ ЩҲШ®Щ„Ш§Щ„ ШЈЩҠШ§Щ… Ш§Щ„ШІЩҠШ§ШұШ© ЩҠЩҸЩӮШӘЩ„ Ш№ШЁШҜШ§Щ„ЩӮШ§ШҜШұ ЩҲЩҠЩҸШ№Щ„ЩӮЩҸ ЩҒЩҠ Щ…ЩҶШІЩ„ЩҮ ШЁШ№ШҜ ШЈЩҶ ЩҠЩҺШӘШұЩғЩҺ Щ„Ш¶ЩҠЩҒЩҮ Ш®ЩҠЩҲШ· Ш§Щ„ЩӮШ¶ЩҠШ© Ш§Щ„ШәШ§Щ…Ш¶Ш©ШҢ ЩҲЩҠШӘШӘШЁШ№ЩҮШ§ ШЁШ№ШҜ Ш°Щ„Щғ ЩҶШ№ЩҠЩ… ШЁЩғЩ„ ШӯШ°Шұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШәШұШЁ ЩҲЩ…ШөШұ..ЩҲЩҒЩҠ Щ…ЩҲШ§ШІШ§Ш© Ш°Щ„ЩғШҢ ШӘШіЩҠШұ ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШ© Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩү Ш§Щ„Ш№Ш§Щ… 1908 Щ…Ш№ Ш®Щ„ЩҠЩ„ Ш§Щ„ЩҲШІШ§ЩҶ(Ш¬ШҜ ЩҶШ№ЩҠЩ…) Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШіШ§ЩҒШұ Щ„ШЈШіШ·ЩҶШЁЩҲЩ„ Щ„ЩҠШ№ЩҠЩ‘ЩҺЩҶ ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Щ„Ші Ш§Щ„Щ…ШЁШ№ЩҲШ«Ш§ЩҶ Щ…Щ…Ш«Щ„Ш§ЩӢ Щ„Щ„Щ…ШҜЩҠЩҶШ© Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҲШұШ©ШҢ ЩҲШ°Щ„Щғ Ш®Щ„Ш§Щ„ ШӯЩғЩ… Ш§Щ„ШіЩ„Ш·Ш§ЩҶ Ш№ШЁШҜШ§Щ„ШӯЩ…ЩҠШҜ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠШҢ ШЈЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШіЩҶЩҲШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҠШұШ© Щ„Ш§ЩҶЩҮЩҠШ§Шұ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„Ш© Ш§Щ„Ш№Ш«Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© .. ЩҲШЁШӘШӘШЁШ№ ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШӘЩҠЩҶШҢ ЩҶШ¬ШҜ ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§ШіЩҲЩҶЩҠШ© ЩҮЩҠ ШЈШӯШҜ ШЈШіШЁШ§ШЁ ШіЩӮЩҲШ· Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„Ш© Ш§Щ„Ш№Ш«Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© ШЁШ№ШҜ ШіЩҠШ·ШұШӘЩҮШ§ Ш№Щ„Щү Ш¬Щ…Ш§Ш№Ш© Ш§Щ„Ш§ШӘШӯШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„ШӘШұЩӮЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШұШ¶Ш©ШҢ ЩҲЩҮЩҠ Ш°Ш§ШӘЩҮШ§ вҖ“ ШЈЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш§ШіЩҲЩҶЩҠШ© - ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩӮЩҒ Ш®Щ„ЩҒ Ш§Щ„Ш¬ШұШ§ШҰЩ… Ш§Щ„ШӘЩҠ Щ„Ш§ ЩҠЩҸШ№ШұЩҒ ЩҒШ§Ш№Щ„ЩҲЩҮШ§ ... ШЈЩҠ ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§ШіЩҲЩҶЩҠШ© ЩҮЩҠ ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҠШ© ЩҲЩҮЩҠ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШіЩҠШұ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ЩғЩҠЩҒЩ…Ш§ ШӘШҙШ§ШЎ.Ш«Ш§ЩҶЩҠШ§ЩӢ: ЩғЩҠЩҒ ЩҠЩ…ЩғЩҶ Щ„Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ ШЈЩҶ ЩҠШӘШЁЩҶЩү Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§ШіЩҠЩғЩҠШ© ШЈЩҲ Ш§Щ„ШЁШ§ШұШӘЩҠШ© Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ ЩӮШұШ§ШЎШӘЩҮ "Щ„ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„"Шҹ ЩҶШіШӘШ№ШұШ¶ ЩҮЩҶШ§ Ш№ШҙШұ ЩҶЩӮШ§Ш· ЩҠЩҶШ§ШҜЩҠ ШЁЩҮШ§ ШұЩҲЩ„Ш§ЩҶ ШЁШ§ШұШӘ ШҢ ЩҲЩҮЩҠ Щ…ЩҶ Щ…ЩӮЩҲЩ…Ш§ШӘ ЩҶШёШұЩҠШӘЩҮШҢ ЩҲЩ„ЩҶШұЩү ШҘЩҶ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠ ЩҒШ§Ш№Щ„Ш§ЩӢ ЩҒЩҠ ШЈЩҠ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШӘЩҠЩҶ..1. ЩҠШұЩү ШЁШ§ШұШӘШҢ ЩҲШ№Щ„Щү Ш§Щ„ЩҶЩӮЩҠШ¶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§ШіЩҠЩғЩҠШ©ШҢ ШЈЩҶЩҮ Щ„Ш§ ЩҠЩҲШ¬ШҜ ШҘШ·Ш§Шұ Щ„Щ„ЩҶШө ЩҠШӯШҜШҜЩҮ ЩҲЩ„ЩҠШі Щ„ЩҮ Щ…ШӨЩ„ЩҒ ЩҲЩ„Ш§ Ш№ЩҶЩҲШ§ЩҶ ЩҲЩ„Ш§ ЩҲШӯШҜШ© ЩғЩ„ЩҠШ©.. ЩҲШЁШ§Щ„Ш№ЩҲШҜШ© ШҘЩ„Щү "ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„" ЩҶШ¬ШҜ ШЈЩҶ ЩҒЩҠ ШөЩҒШӯШӘЩҠЩҮШ§ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҠШұШӘЩҠЩҶ Ш№Щ„Щү ШіШЁЩҠЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш«Ш§Щ„ШҢ ЩҶШ¬ШҜ (Ш®Ш§ШӘЩ…Ш© Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ©) ЩҲЩҮЩҠ ШӘШ®ШЁШұ Ш№ЩҶ ШЁШҜШ§ЩҠШ© ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш¬ШҜЩҠШҜШ© ШӘЩҶШ§Ш· ШЁШ§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Щ„ШӘЩҲЩӮШ№ЩҮШ§ ЩҲШ§Щ„ШЁШӯШ« Ш№ЩҶЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш®ШӘШ§Щ… Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШөЩ„ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҠШ®ШӘЩ… Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ ШұЩҲШ§ЩҠШӘЩҮ ШЁЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© "Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ЩҠШӘШәЩҠШұ. Щ„Щ… ЩҠШ№ШҜ ЩғЩ…Ш§ ЩғШ§ЩҶ. ЩҲЩ„ЩғЩҶ ШЈЩғШ«Шұ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші Щ„Ш§ ЩҠШҜШұЩғЩҲЩҶ." ЩҲЩҮЩҠ ШҜШ№ЩҲШ© ШөШұЩҠШӯШ© Щ„Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Ш§Щ„Щ…ШЁШҜШ№ ЩғЩҠ ЩҠШ¬ШұЩҠ Ш®Щ„ЩҒ ШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҲЩ„Ш§ ЩҠШӘЩҲЩӮЩҒ Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ.2. ЩҠШ№ШӘШЁШұ ШЁШ§ШұШӘ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩҲШ§ШӯШҜ ЩҮЩҲ (Щ…ШіШӘЩӮШұ) Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш№ШұЩҠШ¶Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШөЩҲШө ШӘШӯШҜШ« ЩҶШӘЩҠШ¬Ш© Ш№Щ…Щ„ЩҠШ© Ш§ШіШӘЩҠШ№Ш§ШЁ ШЁШ§Щ„ШәШ© Ш§Щ„Ш°ЩғШ§ШЎШҢ ЩҒЩ…Ш№Ш§ЩҶЩҠЩҮ ЩғШ«ЩҠШұШ© ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮ ЩҲШ§ШіШ№Ш© ЩҲЩ…Ш¬Ш§ШІШ§ШӘЩҮ ШәЩҠШұ Щ…ЩҶШӘЩҮЩҠШ©ШҢ ЩҲЩҠЩ…ЩғЩҶ Щ…Щ„Ш§ШӯШёШ© Ш°Щ„Щғ Ш№ШЁШұ ШӘШӘШЁШ№ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҒШ© Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҠШ© Ш§Щ„ЩҲШ§ШіШ№Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ Ш§Щ…ШӘЩ„ЩғЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҲШӘЩҶЩҲШ№ШӘ ЩҒЩҠЩҮ Щ…ШөШ§ШҜШұЩҮШҢ ШӯШӘЩү ЩҠЩҸШ®ЩҠЩ„ Щ„Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ ШЈЩҶЩҮ ЩҠЩӮЩҒ ШЈЩ…Ш§Щ… Щ…ЩғШӘШЁШ© Щ…ШӘЩҶЩӮЩ„Ш©.3. ЩҠШ®ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶШөЩҸ ШЈШөЩ„ЩҺ Ш§Щ„ШЈШҙЩҠШ§ШЎ ЩҲЩҠШ¬Ш№Щ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩӮШ§Щ„ШЁ Ш¬ШҜЩҠШҜШҢ ЩҲЩ…Ш№ШұЩҲЩҒ Щ„ШҜЩү Ш§Щ„Ш№Ш§Щ…Ш© ШЈЩҶ Ш§Щ„ШЈШіШЁШ§ШЁ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШЈШҜШӘ Щ„ШіЩӮЩҲШ· Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„Ш© Ш§Щ„Ш№Ш«Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© ЩҮЩҠ Ш§Щ„ШӯШұЩҲШЁ Щ…Ш№ Ш§Щ„Ш¬ЩҠШұШ§ЩҶШҢ ЩҲЩғШ«ШұШ© Ш§Щ„ЩҲЩ„Ш§Ш© ЩҲШ§Щ„ЩҒШіШ§ШҜ Ш§Щ„ШҘШҜШ§ШұЩҠ .. ШҘЩ„Ш®ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶ Ш§Щ„ЩӮШЁШ§ЩҶЩҠ ЩҠШ°ЩҮШЁ ШҘЩ„Щү ШЈЩғШ«Шұ Щ…ЩҶ Ш°Щ„ЩғШҢ ЩҠШ°ЩҮШЁ- ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Щ…Ш№ШұЩҒШӘЩҮ - ШҘЩ„Щү ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§ШіЩҲЩҶЩҠШ© ЩҮЩҠ Щ…ЩҶ ШӘЩӮЩҒ ЩҲШұШ§ШЎ ШіЩӮЩҲШ·ЩҮШ§ШҢ ЩҲЩҠШұЩү ШЈЩҶЩҮШ§ ШӘЩӮЩҒ Ш®Щ„ЩҒ Ш§Щ„Ш¬ШұШ§ШҰЩ… Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩӮШ№ ЩҒЩҠ ШЈЩҶШӯШ§ШЎ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ШӯШ§Щ„ЩҠШ§ЩӢ.4. ЩҲЩҠШӨЩғШҜ ШЁШ§ШұШӘ Ш№Щ„Щү ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮЩҠ ЩҠШ®ШӘШІЩ„ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ… ШЁЩҠЩҶ Ш¬ЩҲШ§ЩҶШӯЩҮ ЩҲЩҠШ№ШӘШЁШұ Ш°Ш§ШӘЩҮ Щ…ЩғШӘШЁШ© Щ…Ш№ШұЩҒЩҠШ© ЩҲШ§ШіШ№Ш© Ш§Щ„ЩҶШ·Ш§ЩӮ ЩҲЩҮЩҲ Ш¬Щ„ЩҠ ЩҒЩҠ Ш№ШҜШ© ШЈШЁШ№Ш§ШҜ ЩҒЩҠ ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„ШҢ ЩҲЩ…ЩҶЩҮШ§ Ш§Щ„ШӘЩҶЩҲШ№ Ш§Щ„Ш¬ШәШұШ§ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҲШ§ШіШ№ШҢ ЩҒШӘШҜЩҲШұ ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ШҜЩҠЩҶШ© Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҲШұШ©ШҢ Ш§Щ„Щ…ШәШұШЁШҢ Щ…ШөШұШҢ ЩғЩҶШҜШ§ШҢ Ш§ШіШ·ЩҶШЁЩҲЩ„... ЩҲЩҠЩҒШөЩ„ ШЁЩҠЩҶ ШЈШӯШҜШ§Ш«ЩҮШ§ Щ…Ш§ ЩҠШөЩ„ ШҘЩ„Щү ЩӮШұЩҶ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶ.5. ЩҲШӘЩӮЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© ШЈЩҠШ¶Ш§ЩӢШҢ ШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ЩҶШ§Ш¬Шӯ Щ…ЩҒШӘЩҲШӯ Ш№Щ„Щү Ш¬Щ…ЩҠШ№ Ш§Щ„Ш§ШӯШӘЩ…Ш§Щ„Ш§ШӘ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Щ…ШұШ§ЩҲШәШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ„Ш§Щ„ЩҠШ©ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ЩҮЩҶШ§ Щ…Ш№ШұЩҒШ© ШЈЩҮШҜШ§ЩҒ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШұЩҠШҜ ШЈЩҶ ЩҠЩҲШөЩ„ ШұШіШ§Щ„Ш© ЩҲШ§Ш¶ШӯШ© Щ…ЩҒШ§ШҜЩҮШ§ ШЈЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш§ШіЩҲЩҶЩҠШ© ШӘШ№Щ…Щ„ ШЁШ¬ШҜ ЩҲШ§Ш¬ШӘЩҮШ§ШҜ Ш¶ШҜ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„ Ш§Щ„ШҘШіЩ„Ш§Щ…ЩҠШ©ШҢ ЩҲШҘЩҶЩҮШ§ ШӘШ№Щ…Щ„ Ш№Щ„Щү ШҜШӯШұЩҮШ§ ЩғЩ…Ш§ ЩҒШ№Щ„ШӘ ШіШ§ШЁЩӮШ§ЩӢ Щ…Ш№ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„Ш© Ш§Щ„Ш№Ш«Щ…Ш§ЩҶЩҠШ©.6. ЩҲЩҠШҙЩҠШұ ШЁШ§ШұШӘ ШҘЩ„Щү ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө ШҜШ§Щ„Щ‘ЩҢ ЩҠЩҒШӘШӯ ЩҒШ¬ЩҲШ© ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШҜШ§Щ„ ЩҲШ§Щ„Щ…ШҜЩ„ЩҲЩ„ШҢ ШЁЩҠЩҶ ШёШ§ЩҮШұ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҲШЁШ§Ш·ЩҶЩҮШҢ ЩҲЩҒЩҠ "ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„" ЩҶШ¬ШҜ Ш§Щ„ЩӮШЁШ§ЩҶЩҠ ЩҠШҜШ№ЩҲ ЩғШ«ЩҠШұШ§ЩӢ Щ„Щ„ШӘШЈЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« ШіЩҲШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШөШұШ© ШЈЩҲ Ш§Щ„ШӘШ§ШұЩҠШ®ЩҠШ© Щ„Щ…Ш№ШұЩҒШ© Щ…ЩҶ ЩҠЩҸШіЩҠЩҸШұ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„Щ…ШҢ ЩҲЩ…ЩҶ ЩҠЩӮЩҒ Ш®Щ„ЩҒ Ш§Щ„ШЈШІЩ…Ш§ШӘ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШ№ШөЩҒ ШЁЩҮ.7. ЩҲЩҠЩӮЩҲЩ„ Ш§Щ„ШЁЩҶЩҠЩҲЩҠЩҲЩҶ ШЈШӘШЁШ§Ш№ ШЁШ§ШұШӘШҢ ШҘЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө ШҜШ§ШҰЩ… Ш§Щ„ШӯЩҠШ§Ш© ШЁШ№ЩғШі Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠЩҶШӘЩҮЩҠ ШҜЩҲШұЩҮ ШЁЩ…Ш¬ШұШҜ ШҘШөШҜШ§Шұ Ш№Щ…Щ„ЩҮШҢ ЩҒЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ Щ…Ш«Щ„Ш§ЩӢ ЩҠШҜЩҒШ№ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩүШЎ Щ„Щ„ШЁШӯШ« ЩҲШ§Щ„ШӘЩӮШөЩҠ ШӯЩҲЩ„ Ш§Щ„ШӯЩӮШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„Ш¶Ш§ШҰШ№Ш© ЩҲШ§Щ„Щ…Ш№Щ„ЩҲЩ…Ш§ШӘ Ш§Щ„Щ…ЩҒЩӮЩҲШҜШ©.8. ЩҲЩҠЩғШұШұ ШЁШ§ШұШӘ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө ШӘЩҶШ§ШөЩҢ ЩҒЩҠ Ш¬Щ…ЩҠШ№ Щ…ЩғЩҲЩҶШ§ШӘЩҮШҢ ЩҲЩ„Ш№Щ„ЩҶШ§ ЩҶШ¬ШҜ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ШіШ§ШЁЩӮШ© Щ…ЩҶ ЩӮШұШ§ШЎШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШЁШ§ЩҶЩҠ ЩҒЩҠ ШӯЩғЩҲЩ…Ш© Ш§Щ„ШёЩ„ШҢ ЩҲЩ…ЩҶЩҮШ§: ЩӮШөШұ Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„Щ…Ш© ШЁЩҮШ¬Ш©ШҢ Щ…Ш¬Щ„Ші Ш§Щ„Щ…ШЁШ№ЩҲШ«Ш§ЩҶШҢ ШӯШұЩғШ© Ш§Щ„Ш§ШӘШӯШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„ШӘШұЩӮЩҠ...9. ЩҲШӘШӨЩғШҜ Ш§Щ„ЩҶШёШұЩҠШ© Ш№Щ„Щү ШЈЩҶ Ш§Щ„ШӘЩҶШ§Шө ЩҠШӯШҜШ« ШҜШ§Ш®Щ„ ЩҲШ№ЩҠ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұШҰШҢ ЩҲШҜЩҲЩҶ ШҘШҜШұШ§Щғ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШӘЩ„ЩӮЩҠШҢ ЩҲЩҮЩҲ ЩҠЩҒШұШ¶ Ш§ШіШӘШӯШ§Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҲШөЩҲЩ„ Щ„Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮШ© Ш§Щ„Щ…Ш·Щ„ЩӮШ© ШЁЩ„ ЩҲЩҠШ¬Ш№Щ„ Ш§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Щ…ЩҒШӘЩҲШӯШ© ЩҒШ№Щ„Ш§ЩӢШҢ ЩҲЩҮЩҲ ШЈЩ…Шұ ЩӮШҜ ШЈШҙШұЩҶШ§ ШҘЩ„ЩҠЩҮ ШіЩ„ЩҒШ§ЩӢ.10. ЩҲЩҠЩғШұШұЩҲЩҶ ШЈЩҶ Ш§Щ„ЩҶШө ЩҠШӯЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Ш·ЩҠШ§ШӘЩҮ ШЁЩӮШ§ЩҠШ§ ШіЩ„ШіЩ„Ш© Щ…Ш№Ш§ШұЩҒ Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғШӘШЁ ЩҲШ§Щ„ЩӮШұШ§ШЎШ§ШӘ. ЩҲШЈЩҶЩҮ ЩҠШӯЩ…Щ„ ШЁЩҠЩҶ Ш·ЩҠШ§ШӘЩҮ ШұЩ…Ш§ШҜШ§ЩӢ Ш«ЩӮШ§ЩҒЩҠШ§ЩӢ ЩҠШҜЩҒШ№ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұЩҠШЎ Щ„ЩҠЩғЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ·ЩӮШ© Ш§Щ„Щ…ШӯШ§ЩҠШҜШ© ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШӯЩӮЩҠЩӮШ© ЩҲЩҶЩӮЩҠШ¶ЩҮШ§. ШұШіЩҲЩ„ ШҜШұЩҲЩҠШҙШЁШ§ШӯШ« ШЁШӯШұЩҠЩҶЩҠ