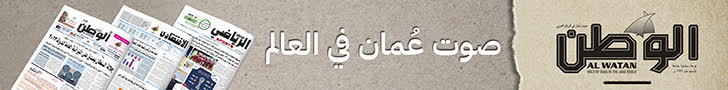В« ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©ШҢ ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶВ» Щ„ЩҶШ§ШөШұ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ШЈЩҶЩ…ЩҲШ°Ш¬Ш§ (1)ШЁЩ„ЩӮШ§ШіЩ… Щ…Ш§ШұШіiЩ…ШҜШ®Щ„:Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ¬ШІ ШЈЩҲ Ш§Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ШЁ ШҙЩғЩ„ ЩҒЩҶЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш©ШҢ ЩҲЩҮЩҲ Ш¬ЩҶШі ШЈШҜШЁЩҠЩ‘ ЩҠЩҸШ·Щ„ЩӮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩӮЩ‘Ш§ШҜii ЩҒЩҶЩ‘В« Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© В». ЩҲЩҶШІШ№Щ… ШЈЩҶЩ‘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҮЩҠШҰШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© Ш№Щ„ЩүВ« ЩӮШөШұЩҮШ§ ЩҲШ§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІЩҮШ§ ШЁШҘЩ…ЩғШ§ЩҶЩҮШ§ ШЈЩҶЩ’ ШӘЩ…Ш«Щ‘Щ„ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Ш§Щ„ШӘЩ‘Ш¬Ш§ШұШЁ Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠЩ‘Ш© Ш№Щ„Щү ШӘЩ…Ш§ЩҠШІЩҮШ§ ЩҲШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ЩҮШ§ ЩҲШӘШ№ЩӮЩҠШҜЩҮШ§В»iiiШҢ Ш°Щ„Щғ ШЈЩҶЩ‘ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩӮШӘШ¶Ш§ШЁ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ШЁШҘЩ…ЩғШ§ЩҶЩҮ Щ…Щ„Ш§Щ…ШіШ© Ш§Щ„ШӘЩ‘Ш¬ШұШЁШ© Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ© ШЁЩғЩ„Щ‘ ШӘШ№ЩӮЩҠШҜШ§ШӘЩҮШ§ ЩҲШ§ЩҗШӘЩ‘ШіШ§Ш№ Ш№ЩҲШ§Щ„Щ…ЩҮШ§ ЩҲШӘЩҶШ§ЩӮШ¶Ш§ШӘЩҮШ§ ЩҲШҘЩҶЩ’ ШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІШӘ ШӘШ¬ШұШЁШ© Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҙЩ‘ЩғЩ„ Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҠЩ‘ ШЁШ§Щ„Ш§Щ…ШӘЩ„Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҗШ®ШӘШІШ§Щ„ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҗШ®ШӘШөШ§Шұ ЩҒЩҠ ШӘШөШұЩҠЩҒ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҲШ·ШұЩӮ ШӘШҙЩғЩҠЩ„ЩҮШ§ШҢ Ш®Щ„Ш§ЩҒЩӢШ§ Щ„Щ…Ш§ Ш°ЩҮШЁ ШҘЩ„ЩҠЩҮ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩӮШ§ШҜ Ш§Щ„Ш°ЩҠЩҶ ЩҠЩӮШұЩ‘ЩҲЩҶ ЩҒЩҠ ШЈЩғШ«Шұ Щ…ЩҶ Щ…ЩҶШ§ШіШЁШ© ШЈЩҶЩ‘В« Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ШҙЩғЩ„ ШәЩҠШұ Щ…ЩғШӘЩ…Щ„ ШЈЩҲ Ш¬ШІШҰЩҠЩ‘ Щ…ЩӮШ§ШұЩҶШ© ШЁШ§ЩҗЩғШӘЩ…Ш§Щ„ Ш§Щ„ШұЩ‘ЩҲШ§ЩҠШ©. ЩҲЩҶШёШұЩҲШ§ ШҘЩ„ЩҠЩҮШ§ ШЁЩҲШөЩҒЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҲШ№ Ш§Щ„ШЈШөШәШұ ЩҲШ§Щ„ШЈЩӮЩ„ ШЁШ§Щ„ЩҶЩ‘ШіШЁШ© ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШұЩ‘ЩҲШ§ЩҠШ© В»ivЩҲЩ„ШӘШҜШЁЩ‘Шұ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…Ш· Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш©ШҢ ЩҶЩҶШёШұЩҸ ЩҒЩҠ Щ…ШӨЩ„Щ‘ЩҒ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠv Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҲЩ… ШЁЩҖВ« ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©ШҢ ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶvi В» Ш§Щ„ШөЩ‘Ш§ШҜШұ ШӯШҜЩҠШ«ЩӢШ§ШҢ ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ЩҮ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ЩҶЩӮЩҒ Ш№Щ„Щү Щ…ШіШЈЩ„ШӘЩҠЩҶ ШЈШіШ§ШіЩҠШӘЩҠЩҶШҢ ЩҶЩҲШ¶Щ‘Шӯ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү ШӘЩҲШ¶ЩҠШӯЩӢШ§ ШіШұЩҠШ№ЩӢШ§ШҢ ЩҲЩҶЩӮЩҒ Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш§ЩӢ Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„Ш«Щ‘Ш§ЩҶЩҠШ© ШЁШ§Щ„ШӘЩ‘ШӯЩ„ЩҠЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘШЈЩ…Щ‘Щ„ ШЁШ§ЩҗШ№ШӘШЁШ§ШұЩҮШ§ Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ‘ШұШ§ШіШ©.ШЈЩ…Щ‘Ш§ Ш§Щ„Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү ЩҒШӘШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ ШЁШ¬ЩҶШі ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҶЩҒ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ§ШӘ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ( Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ Ш§Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҲШ¬ЩҠШІ)ШҢ ЩҒЩҒЩҠ ШЈЩҠЩ‘ Ш®Ш§ЩҶШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ¬ЩҶШ§Ші Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠЩ‘Ш© ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШӘШөЩҶЩҠЩҒЩҮШҹЩҮЩ„ ЩҠЩҶШӘЩ…ЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„Щ‘ЩҒ ШҘЩ„Щү Ш¬ЩҶШі Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ШҹШЈЩҲЩ’ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩҲЩ…Ш¶Ш©Шҹ ШЈЩҲЩ’ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Ш¬ШҜЩӢШ§ Шҹ ШЈЩҲ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ШҙЩ‘Ш№ШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ©Шҹ ШҘЩҶЩ‘ЩҮ Ш¬ЩҶШі ШЈШҜШЁЩҠЩ‘ ШәЩҠШұ ЩҲШ§Ш¶Шӯ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§Щ„Щ… ЩҒЩҠ ШҙЩғЩ„ЩҮ ЩҲЩҒЩҠ Щ…Ш¶Щ…ЩҲЩҶЩҮ.ЩҲЩ„Щ„ШҘШҙШ§ШұШ© ЩҒЩӮШҜ ЩғШ§ЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҠШІ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ШЁ Щ…Ш¬Ш§Щ„ ШЁШӯШ« Щ…ЩҸШ·ЩҲЩ‘Щ„ ЩҒЩҠ ЩғШӘШ§ШЁ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Ш§ЩӮШҜ Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠВ« Ш§Щ„ЩҶЩ‘Шө Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠЩ‘ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„В»viiШӯЩҠШ« ШЈЩғЩ‘ШҜ Ш§Щ„ШЁШ§ШӯШ« Ш¶ШұЩҲШұШ© ШӘШҜШЁЩ‘Шұ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ ЩҲШӘШЈЩҲЩҠЩ„ЩҮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШёШұ ШҘЩ„ЩҠЩҮ Щ…ЩҶ ШІШ§ЩҲЩҠШӘЩҠЩҶ ЩғШЁЩҠШұШӘЩҠЩҶ ШӘШӘШұШ§ЩҲШӯШ§ЩҶ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШёШұЩҠШ©ЩҲ Ш§Щ„ШҘШ¬ШұШ§ШЎ Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҮШ¬ЩҠЩ‘ Ш§Щ„ШӘЩ‘ШӯЩ„ЩҠЩ„ЩҠЩ‘.ШҘЩҶЩ‘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ШіЩ…Щ‘ЩҠШ§ШӘ ЩғЩ„Щ‘ЩҮШ§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ЩҶШ№Ш«Шұ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ Щ…Щ…Щ‘Ш§ ЩҠШҙШұЩ‘Ш№ Щ„ШҜШұШ§ШіШ© Ш§Щ„ШЈШ«Шұ ЩҲЩҠШЁШұЩ‘Шұ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩҮШӘЩ…Ш§Щ… ШЁЩҮ ШҢ Ш№Щ„Щү ШЈЩҶЩ‘ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„Щ‘ЩҒ ЩӮШҜ Ш§ЩҗШ№ШӘШЁШұ ЩӮШөШөЩҮ Щ…ЩҶШ° Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© ЩҶШөЩҲШөЩӢШ§ ШіШұШҜЩҠЩ‘Ш© Ш°Ш§ШӘ Ш·Ш§ШЁШ№ ШӘШіШ¬ЩҠЩ„ЩҠ Щ„ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© ЩҠШӯЩҠЩ„ Ш№Щ„Щү Ш°Щ„Щғ Ш№ЩҶЩҲШ§ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ© Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҲШіЩ…ЩҮШ§ ШЁЩ…Ш§ ЩҠЩ„ЩҠ : В« ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШіЩҠШұШ© Щ„Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶ В» ЩҲЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ШӘШіШӘШ¬ЩҠШЁ Щ„Щ…Ш«Щ„ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ЩҸШіЩ…ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Щ…Ш°ЩғЩҲШұШ© ШіШ§ШЁЩӮЩӢШ§ Ш№Щ„Щү ШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ЩҮШ§ ЩҲШ§ЩҗШ®ШӘЩ„Ш§ЩҒЩҮШ§. ЩҲШ§Щ„Щ…ШӘШЈЩ…Щ‘Щ„ ШЈЩҠШ¶ЩӢШ§ ЩҒЩҠ ШЈШәЩ„ШЁ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ЩҠЩ„Ш§ШӯШё ШЈЩҶЩ‘ЩҮШ§ ШӘШіШӘШ¬ЩҠШЁ Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ЩҲЩ…ШӘШ·Щ„Щ‘ШЁШ§ШӘЩҮШ§ Ш№Щ„Щү Щ…Ш§ ЩҠШ°ЩғШұ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Ш§ЩӮШҜШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠviii ЩҲ ШөШЁШұЩҠ ШӯШ§ЩҒШё ix. ЩғЩ…Ш§ ШЈЩҶЩ‘ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Ш§ШёШұ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ШЈЩҠШ¶ЩӢШ§ ЩҠЩ„Ш§ШӯШё ЩҲШ¬ЩҲШҜ ЩӮШөШө ЩӮШөЩҠШұШ© Ш¬ШҜЩӢШ§ Щ„Ш§ ШӘШӘШ¬Ш§ЩҲШІ Ш§Щ„ШЈШіШ·Шұ Ш§Щ„Щ…Ш№ШҜЩҲШҜШ© ЩғЩ…Ш§ ЩҒЩҠ ЩӮШөЩ‘Ш© В«ШЈШЁШ·Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©xВ»ШҢ Щ…Щ…Щ‘Ш§ ЩҠШ¬Ш№Щ„ЩҶШ§ ЩҶЩҸШөЩҶЩ‘ЩҒЩҮШ§ Ш¶Щ…ЩҶ Щ…Ш§ ЩҠЩҸШ№ШұЩҒ ШЁШ§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩҲЩ…Ш¶Ш©ШҢ ЩғЩ…Ш§ ШЈЩҶЩ‘ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШ®ШұЩү ШӘШЁШҜЩҲ ЩӮШөШөЩӢШ§ ЩӮШөЩҠШұШ©ЩӢ Щ„Ш§ ШӘШӘШ¬Ш§ЩҲШІ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҒШӯШ© ШЈЩҲЩ’ ЩҶШөЩҒ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҒШӯШ© Щ…Щ…Щ‘Ш§ ЩҠШ¬Ш№Щ„ЩҮШ§ ЩӮШөШөЩӢШ§ ЩӮШөЩҠШұШ© Ш¬ШҜЩӢШ§xi ЩҲЩҮЩҠ ЩғШ«ЩҠШұШ© . ЩҲЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© ШЈЩҠШ¶Ш§ ЩҶШөЩҲШө ЩҮЩҠ ШЈЩӮШұШЁ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҙЩ‘Ш№Шұ Ш§Щ„ШӯШұЩ‘ xii ШЁШӯЩҠШ« ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ШӘШіШӘШ¬ЩҠШЁ ШӯШӘЩү Щ„Щ„ШӘЩ‘ЩӮШ·ЩҠШ№ Ш§Щ„Ш№ШұЩҲШ¶ЩҠЩ‘ ЩғЩ…Ш§ ЩҒЩҠ ЩӮШөШ© В« Ш№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩғЩҶШ§ ШөШәШ§ШұШ§xiii В».ЩғЩ…Ш§ ШӘЩҲЩҒЩ‘ШұШӘ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© ЩӮШөШөЩҢ Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш©ЩҢ ЩҶШіШЁЩҠЩ‘Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШҘШҜШұШ§Ш¬ЩҮШ§ Ш¶Щ…ЩҶ Щ…Ш§ ЩҠЩҸШ№ШұЩҒ ШЁЩҒЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ШЈЩҲЩ’ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„Ш·Щ‘ЩҲЩҠЩ„Ш© Щ„ЩғЩҶЩ‘ЩҮШ§ Щ„Ш§ ШӘШЁЩ„Шә Щ…ШұШӯЩ„Ш© Ш§Щ„ШұЩ‘ЩҲШ§ЩҠШ© ЩҲЩ…ШӘШ·Щ„Щ‘ШЁШ§ШӘЩҮШ§ Щ…ЩҶ ЩӮШЁЩҠЩ„ ЩӮШөШө В«Ш№ШІЩҲШ© Ш§Щ„ШҙЩҲШ§ШЎ В»xiv ЩҲ В«Ш§Щ„ШөШҜЩӮШ© В» xvЩҲШ§Щ„Ш«Щ‘Ш§ШЁШӘ ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ ШЁЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү ШЈЩҶЩ‘ ШҘШҙЩғШ§Щ„Ш§ЩӢ ШЈШ¬ЩҶШ§ШіЩҠЩӢШ§ ЩғШ§Щ…ЩҶ ЩҒЩҠ Ш«ЩҶШ§ЩҠШ§ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө ЩҠШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ ШЈШіШ§ШіЩӢШ§ ШЁЩ…Ш§ЩҮЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩҲШ№ Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠЩ‘ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ШӘЩ…Ш«Щ‘Щ„ЩҮ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ©. ЩҲЩҶШІШ№Щ… ШЈЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҲШ¶ЩҠШӯ Ш§Щ„Щ…ШӘЩ‘ШөЩ„ ШЁШ§Щ„Ш№ЩҶЩҲШ§ЩҶ Ш§Щ„Щ…ЩҒШіЩ‘Шұ Щ„ЩҮ В«ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ...ШіЩҠШұШ© Щ„Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶ В»ЩҠШөЩҶЩ‘ЩҒ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© Ш¶Щ…ЩҶ ШҜШ§ШҰШұШ© Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ§ШӘ (Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ Ш§Щ„ЩҲШ¬ЩҠШІ ЩҲШ§Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ШЁ) ЩҲЩҠЩҶЩҒЩҠ Ш№ЩҶЩҮ ШөЩҒШ© Ш§Щ„ШҙЩ‘Ш№Шұ Щ…Ш«Щ„Ш§ЩӢ ШЁШ§ЩҗШ№ШӘШЁШ§ШұЩҮ Ш¬ЩҶШіШ§ЩӢ Щ…ШіШӘЩӮЩ„Ш§ЩӢ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Щ„ЩҮ ШӘЩӮЩҶЩҠШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„Ш®Ш§ШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІЩҮ Ш№ЩҶ ШәЩҠШұЩҮ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ¬ЩҶШ§Ші Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠШ© ШҜЩҲЩҶ ШЈЩҶЩ’ ЩҶЩҶЩҒЩҠ Ш№ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈШ¬ЩҶШ§Ші - Ш№Щ„Щү Ш§ЩҗШ®ШӘЩ„Ш§ЩҒЩҮШ§ ЩҲШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ЩҮШ§ - ШөЩҒШ© Ш§Щ„ШӘЩ‘ШҜШ§Ш®Щ„ ЩҲШЈШ®Щ’Ш° ШЁШ№Ш¶ЩҮШ§ ШЁШұЩӮШ§ШЁ ШЁШ№Ш¶.ЩҲЩҶЩғШ§ШҜ ЩҶШіЩ„Щ‘Щ… Щ…Ш№ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ШЁШЈЩҶЩ‘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө - ЩҲШҘЩҶЩ’ ЩғШ§ЩҶШӘ Щ…ШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№Ш© ЩҲЩ…Ш®ШӘЩ„ЩҒШ© Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ« ЩҮЩҠШҰШ© Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© ЩҲШ·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ ЩҒЩҠЩҮШ§- ЩҮЩҠ ШЈЩӮШұШЁ ШҘЩ„Щү Щ…Ш¬Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ШҜЩҲЩҶ ШЈЩҶ ЩҶЩҶЩҒЩҠ Ш№ЩҶЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…ЩҶШӯЩү Ш§Щ„ШіЩҠШұ Ш°Ш§ШӘЩҠ ЩҒЩҮЩҠ ШіЩҠШұШ© Щ„Щ„ЩӮШұЩҠШ© ЩҲ ШЈЩҮШ§Щ„ЩҠЩҮШ§ШҢ Щ„ЩғЩҶЩ‘ЩҶШ§ ЩҶЩҸШіШ¬Щ‘Щ„ ЩҒЩҠ ЩҶЩҒШі Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩ‘ШЁШ§ЩҠЩҶ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘Щ…Ш§ЩҠШІ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө ШіЩҲШ§ШЎ ШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ Ш§Щ„ШЈЩ…Шұ ШЁШ§Щ„Ш·Щ‘ЩҲЩ„ ЩҲ ШЁШ§Щ„ЩӮШөШұ ШЈЩҲ ШЁШ·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© ЩҲШЁЩҶЩҠШӘЩҮШ§ .ШЈЩ…Щ‘Ш§ Ш§Щ„Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш§Щ„Ш«Щ‘Ш§ЩҶЩҠШ© ЩҒЩҮЩҠ ШӘШӘЩ‘ШөЩ„ Ш§ЩҗШӘЩ‘ШөШ§Щ„Ш§ ЩӢЩҲШ«ЩҠЩӮЩӢШ§ ШЁШ§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү ЩҲ ШӘШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ ШЁШ§Щ„ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө. ЩҒШ§Щ„Щ…ШӘШЈЩ…Щ‘Щ„ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„Щ‘ЩҒ ЩҠЩ„ШӯШё ШЈЩҶЩ‘ ШЁЩҶЩҠШӘЩҮ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© ЩҮЩҠ ШЁЩҶЩҠШ© Щ…ЩғШӘЩҶШІШ©xvi ШӘШӯЩ…Щ„ ЩҒЩҠ Ш«ЩҶШ§ЩҠШ§ЩҮШ§ Щ…Ш№ЩҶЩҠ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩ…ШӘЩ„Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҗШ¬ШӘЩ…Ш§Ш№ ЩҲШ§Щ„ЩӮЩҲЩ‘Ш© ЩҒЩҠ ШўЩҶ Щ„Щ…Ш§ ЩҠШ№ШӘЩ…Щ„ ШҜШ§Ш®Щ„ЩҮШ§ Щ…ЩҶ Щ…ЩӮЩҲЩ‘Щ…Ш§ШӘ ШӘШұЩғЩҠШЁЩҠЩ‘Ш© ЩҲШЁЩҶЩҠЩҲЩҠЩ‘Ш© Щ…ШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІШ© Щ…ШӯЩғЩҲЩ…Ш© ШЁЩ…ШӯЩҲШұЩҠЩ’ Ш§Щ„Ш§ЩҗШ®ШӘЩҠШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҲШІЩҠШ№ШҢ Щ…Щ…Ш§ ЩҠШ¬Ш№Щ„ Ш§Щ„ШҜЩ‘Щ„Ш§Щ„Ш© ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© Щ„Ш§ ШӘШЁШҜЩҲ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЈЩӮЩ„ Щ…ЩҲШӯЩ‘ШҜШ© ШЁЩ„ ЩҮЩҠ ШҜЩ„Ш§Щ„Ш© Щ…ЩҸЩҶЩҒШӘШӯШ© Щ„Ш§ Щ…ШӘЩҶШ§ЩҮЩҠШ© ЩҠШ№Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұШҰ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…ЩҲШ°Ш¬ЩҠ Ш№Щ„Щү ШЁЩ„ЩҲШәЩҮШ§ ЩҲЩ…Ш№ШұЩҒШ© ЩӮШөШҜЩҠЩ‘ШӘЩҮШ§ ЩҲШҜЩ„Ш§Щ„ШӘЩҮШ§ Щ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ Щ…Щ…Ш§ШұШіШ© ЩҶШҙШ§Ш·ЩҮ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ЩҠЩ‘ ЩҲ Ш§Щ„ШӘЩ‘Ш№Ш§Ш¶ШҜЩҠЩ‘ Щ…Ш№ШӘЩ…ШҜЩӢШ§ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ Ш№Щ„Щү ЩғЩҒШ§ЩҠШӘЩҮ Ш§Щ„ШҘЩҠШҜЩҠЩҲЩ„ЩҲШ¬ЩҠЩ‘Ш© ШЁШӯЩғЩ… ШӘЩғЩҲЩҠЩҶЩҮ ЩҲЩ…Ш№Ш§ШұЩҒЩҮ ЩҲШ«ЩӮШ§ЩҒШӘЩҮ ЩҲ ШҘЩҶЩ’ ШӘШЈШ®Щ‘ШұШӘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ‘Щ„Ш§Щ„Ш© ШЁШӯЩғЩ… ШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ ЩҲШ§ЩҗШ®ШӘЩ„Ш§ЩҒ Ш«ЩӮШ§ЩҒШ§ШӘЩҮЩ… Ш№Щ„Щү Щ…Ш§ ЩҠШІШ№Щ… В« ШЈЩ…ШЁЩҠШұШӘЩҲ ШҘЩҠЩғЩҲВ»xvii.ШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠ ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ШЁЩҶЩҠШ© Щ…ЩғШӘЩҶШІШ© ЩҠЩҮЩҠЩ…ЩҶ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ Ш§Щ„Ш·Щ‘Ш§ШЁШ№ Ш§Щ„Ш§ЩҗШ®ШӘШІШ§Щ„ЩҠЩ‘ ЩҶШ§ЩҮЩҠЩғ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩ‘ШұЩ…ЩҠШІ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҠШӯШ§ШЎ ЩҲШ§Щ„ШӯШ°ЩҒ ШҘЩ„Щү ШҜШұШ¬Ш© ШӘЩҸШөШЁШӯ Щ…Ш№ЩҮШ§ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© Ш§ЩҗШіШӘШ№Ш§ШұШ©ЩӢ ШЈЩҲ Щ…Ш¬Ш§ШІЩӢШ§ЩӢ ШҘШ° ЩҮЩҲ Щ„Ш§ ЩҠШЁЩҲШӯ ШЁЩғЩ„Щ‘ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ЩҶЩҠ ЩҲ ШҘЩҶЩ‘Щ…Ш§ ШЁШЁШ№Ш¶ЩҮШ§ Щ…Ш№ШӘЩ…ШҜШ§ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ Ш№Щ„Щү ШӘЩӮЩҶЩҠШ© Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© .ЩҲШ§Щ„Ш«Щ‘Ш§ШЁШӘ Щ„ШҜЩҠЩҶШ§ ШЈЩҶЩ‘ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© В«ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ...ШіЩҠШұШ© Щ„Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶ В» Щ…ШӯЩғЩҲЩ… ШЁЩҶЩ…Ш· Щ…Ш®ШөЩҲШө ЩҒЩҠ ШҘЩҶШ¬Ш§ШІЩҮ ЩҲШӘЩӮШҜЩҠЩ…ЩҮ Щ„Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© ЩҲШ·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ЩҒЩҠЩҮ . ШҘШ°Щ’ ЩҠЩҶЩҮШ¶ ШЈШіШ§ШіЩӢШ§ Ш№Щ„Щү Ш§ЩҗЩӮШӘШөШ§ШҜ Ш§Щ„Ш№ШЁШ§ШұШ© ЩҲШӘШӯШ¬ЩҠЩ…ЩҮШ§ ЩҲШ§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© ЩҲШ§ЩҗЩ…ШӘЩ„Ш§ШҰЩҮШ§ ЩҲШЁШ§Щ„ШӘЩ‘Ш§Щ„ЩҠ ШҘШӯЩғШ§Щ… ШЁЩҶШ§ШҰЩҮШ§ШҢ Щ…Щ…Ш§ ЩҠШӨШіЩ‘Ші Щ„Ш§ЩҗЩҶШӘЩҒШ§ШЎ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШ§ШөЩҠЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШіЩҠШұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘ШЁШұЩҠШұШ§ШӘ. ЩҒЩҶЩ„ШӯШё ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҶЩҒЩҲШұ Ш§Щ„ШіЩ‘Ш§ШұШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШЁШ§ШҙШұШ© ЩҲШ§Щ„ШӘЩҮЩҲЩҠЩ„ ЩҲЩҮЩҲ Щ…Ш§ ЩҠШ¬Ш№Щ„ Ш§Щ„ШҜЩ‘Щ„Ш§Щ„Ш© Щ…ШӘШ№ШҜЩ‘ШҜШ© ШӘШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ ШЁШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ Ш§Щ„ЩӮШұЩ‘Ш§ШЎ ЩҲШ§ЩҗШ®ШӘЩ„Ш§ЩҒЩҮЩ… ЩҲШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ Щ…Ш№Ш§ШұЩҒЩҮЩ… ЩҲ Ш«ЩӮШ§ЩҒШ§ШӘЩҮЩ… ЩҲШ°Щ„Щғ Щ…Ш§ ШЈЩҮЩ‘Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөШө Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Щ„Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ЩҶШ§ШөШұ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ШЈЩҶЩ’ ШӘЩғЩҲЩҶ ЩҶЩ…Ш§Ш°Ш¬ ЩҲШӘШ¬Ш§ШұШЁ ШіШұШҜЩҠЩ‘Ш© Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠШ© ШұШ§ШҰШҜШ© ЩҠЩ…ЩғЩҶ Щ„ЩҮШ§ ШЈЩҶЩ’ ШӘШӯШӘЩ„Щ‘ Щ…ЩҶШІЩ„Ш© Щ…ШұЩ…ЩҲЩӮШ© ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠЩҸЩӮШҜЩ‘Щ… Щ…ЩҶ ЩҶШөЩҲШө ШҘШЁШҜШ§Ш№ЩҠШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҙЩ‘ЩғЩ„ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҶШ·ЩӮШ© Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШ©.ЩҲЩ„Щ…Ш§ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘ ЩҮЩҲ Щ…Щ„ЩҒЩҲШё ЩҠШӨЩ„Щ‘ЩҒ ЩҶШөЩӢШ§ ЩӮШөШөЩҠЩӢШ§ШҢ ЩҒШҘЩҶЩ‘ Ш°Щ„Щғ Щ…ЩҶ ШҙШЈЩҶЩҮ ШЈЩҶЩ’ ЩҠЩҸЩҠШіЩ‘Шұ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҲШ§ШөЩ„ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШіЩ‘Ш§ШұШҜ Ш§Щ„Щ…ЩҶШёЩ‘Щ… Щ„Щ„ШӯШҜШ« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ Щ…ЩҶ ЩҶШ§ШӯЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ШӘЩ„ЩӮЩ‘ЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…ЩҲШ°Ш¬ЩҠ Щ…ЩҶ ЩҶШ§ШӯЩҠШ© Ш«Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ Ш№Щ„Щү ШЈЩҶЩ‘ЩҶШ§ ЩҶШ№ШӘШЁШұ Щ…ЩҶШ° ШЁШҜШ§ЩҠШ© ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ‘ШұШ§ШіШ© ШЈЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШЈШіШ§ШіЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠ Щ„ЩҠШі Щ…Ш§ ЩҠЩҸШұЩҲЩү Щ…ЩҶ ШЈШӯШҜШ§Ш« ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© (Щ…Ш§Ш°Ш§ ЩӮЩҠЩ„) ШЁЩ„ Ш§Щ„ШЈЩҮЩ…ЩҠШ© Ш§Щ„ЩғШЁШұЩү ШӘЩғЩ…ЩҶ ЩҒЩҠ ЩҮЩҠШҰШ© Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© ЩҲШіЩҸШЁЩ„ ШӘШөШұЩҠЩҒ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘ ЩҒЩҠЩҮШ§ (ЩғЩҠЩҒ ЩӮЩҠЩ„) ШЈЩҠЩ’ ШЈЩҶЩ‘ Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШҘШЁШҜШ§Ш№ЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ Ш§ЩҗШ№ШӘЩӮШ§ШҜЩҶШ§ ШӘШӘЩ‘ШөЩ„ ШЁЩғЩҠЩҒЩҠШ§ШӘ ШӘШөШұЩҠЩҒ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҲЩҮЩҠШҰШ§ШӘ ШҘЩҶШ¬Ш§ШІЩҮШ§. ЩҒЩғЩ„Щ‘ Ш№Щ…Щ„ ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҠШӘЩҒШұЩ‘ШҜ ШЁШ·ШұЩҠЩӮШ© ШӘШөШұЩҠЩҒ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ© ЩҒЩҠЩҮ ЩҲШіШЁЩ„ ШҘШ®ШұШ§Ш¬ЩҮШ§ Ш№Щ„Щү Ш·ШұЩҠЩӮШ© Щ…Ш®ШөЩҲШөШ© Щ…Щ…ЩҠЩ‘ШІШ© ЩҠШ¬ЩҲШІ Щ…Ш№ЩҮШ§ ШЈЩҶЩ’ ЩҶЩҸЩҶШіШЁ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ШҜЩҲЩҶ ШәЩҠШұЩҮ . ЩҒЩҠШӯШҜШ« Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШ§Ш№Щ„ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘ЩҲШӘЩ‘Шұ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Ш§Щ„ЩҲШӯШҜШ§ШӘ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„Щ…ЩғШӘЩҶШІШ© Ш№Щ„Щү ШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ЩҮШ§ ЩҲШӘШҜШ§Ш®Щ„ЩҮШ§ ШЁШ§ЩҗШ№ШӘШЁШ§Шұ ШЈЩҶЩ‘ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…Ш· Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ШҘШіЩ…ЩҠШ© ЩғШ§ЩҶШӘ ШЈЩ… ЩҒШ№Щ„ЩҠШ© Ш®ШЁШұЩҠШ© ЩғШ§ЩҶШӘ ШЈЩ… ШҘЩҶШҙШ§ШҰЩҠШ© ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ЩҠЩҸШӯШҜШ« Щ…Ш№ЩҶЩү ШӘШ§Щ…Щ‘Ш§ ЩҒЩҠ ШөЩ„ШЁ Ш§Щ„ЩӮШөШө ЩҠШӘЩҒШ·Щ‘ЩҶ ШҘЩ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұШҰ Ш§Щ„ЩҶЩ…ЩҲШ°Ш¬ЩҠ ШҜЩҲЩҶ ШәЩҠШұЩҮ .ЩҲ Ш·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ ЩҲЩғЩҠЩҒЩҠЩ‘Ш§ШӘ ШӘШҙЩғЩҠЩ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜЩ‘ШұШ§ШіШ© ЩҮЩҠ Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш¬ШҜЩҠШұШ© ШЁШ§Щ„Ш§ЩҗЩҮШӘЩ…Ш§Щ…ШҢ Ш°Щ„Щғ ШЈЩҶЩ‘ ЩғЩҠЩҒЩҠШ© ШӘЩӮШҜЩҠЩ… Ш§Щ„ШіЩ‘Ш§ШұШҜ Щ„Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠЩҮШ§ Щ„Ш§ ШӘШ®ШұШ¬ Ш№ЩҶ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘШ·Ш§Шұ. ЩҒЩӮШҜ ЩҶЩҮШ¶ШӘ ШЈШіШ§ШіЩӢШ§ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҲ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩ…ШӘЩ„Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„ШөЩ‘Щ…ШӘxviii ЩҲ Ш§Щ„Ш№Ш¬ШІ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§Щ… ЩҒЩҠ ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„Щ…ЩҲШ§Ш·ЩҶ В«Ш№ШұЩҒ Ш§Щ„ШҙЩҠШ® ШІШ§ЩҮШұ ШЁЩғШұЩ…ЩҮ ЩҲШ¬ЩҲШҜЩҮ ЩҲШӘЩҲШёЩҠЩҒЩҮ Щ„Ш№ШҜШҜ ЩғШЁЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩҠШ№Щ…Щ„ЩҲЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШІЩ‘ШұШ№ ЩҲШ§Щ„ЩҶЩ‘Ш®Щ„ ЩҲЩғШ§ЩҶЩҲШ§ ЩҠШ®Ш§ЩҒЩҲЩҶ Ш§Щ„ШӯШҜЩҠШ« Щ…Ш№ЩҮ ШЈЩҲ Ш§Щ„ШҘЩӮШӘШұШ§ШЁ Щ…ЩҶ Ш¬Щ„ШіШӘЩҮ Щ„ШҙШҜШ© ШЁШЈШіЩҮ ЩҲЩҮЩҠШЁШӘЩҮ ЩҲЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Щ„Ш§ ЩҠШӘШ°Щ…Щ‘ШұЩҲЩҶ Щ…ЩҶ Ш°Щ„Щғ ШЁЩ„ ЩғШ§ЩҶЩҲШ§ ЩҠШұШӘШ¶ЩҲЩҶ Щ„Щ„ШҙЩҠШ® ЩҒШ№Щ„ЩҮ Щ„Щ…Ш§ Щ„ЩҮ Щ…ЩҶ Щ…ЩҶ ШЈЩҮЩ…ЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠ ШӯЩ…Ш§ЩҠШ© Щ…Щ…ШӘЩ„ЩғШ§ШӘЩҮЩ… ЩҲШ«Щ…Ш§ШұЩҮЩ… ЩҲЩ…ЩҶШӘШ¬Ш§ШӘ ШӯЩӮЩҲЩ„ЩҮЩ… В» xix ЩҒШ§ЩҗЩҶШ№ЩғШі ШіЩ„ЩҲЩғ Ш§Щ„ШҙЩ‘Ш®ШөЩҠШ§ШӘ ЩҲШұШәШЁШӘЩҮШ§ Ш§Щ„Щ…Щ„ШӯЩ‘Ш© ЩҒЩҠ Ш№ШҜЩ… Ш§Щ„ШҘЩҒШөШ§Шӯ Ш№ЩҶ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠ ЩҲШ§Щ„Щ…Ш¬Ш§ЩҮШұШ© ШЁЩҮ Ш№Щ„Щү Щ…ШіШ§Шұ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ЩҲЩҮЩҠШҰШ© Ш§ЩҗЩҶШӘШёШ§Щ…ЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠ ШЁШ§Щ„ШҜЩ‘ШұШ¬Ш© Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү. ЩҒШ¬Ш§ШЎШӘ ШЈШәЩ„ШЁЩҮШ§ Щ…ЩҶЩҒЩҠЩ‘Ш© ШЈЩҲЩ’ Щ…Ш«ШЁШӘШ© ЩҲЩ…ЩҶЩҒЩҠЩ‘Ш© ЩҒЩҠ ШўЩҶШҢ ЩҲШ№Щ„Щү Щ…ШіШ§Шұ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ ЩҲШ§Щ„ЩҲШөЩҒ ЩҲШ§Щ„ШЈЩ…ЩғЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШЈШІЩ…ЩҶШ© ШЁШҜШұШ¬Ш© Ш«Ш§ЩҶЩҠШ©ШҢ Щ„ЩҠЩғЩҲЩҶ Щ…ЩҶ ШЈШЁШұШІ ЩҶШӘШ§ШҰШ¬ Ш°Щ„Щғ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШҜЩ‘Щ„Ш§Щ„Ш§ШӘ Ш§Щ„Щ…ШӘШ№ШҜЩ‘ШҜШ© ЩҲ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„Щ…ЩҶЩҒШӘШӯШ© ШЁШ№Ш¶ЩҮШ§ Ш№Щ„Щү ШЁШ№Ш¶ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҠ ЩҠШҜШұЩғЩҮШ§ ЩӮШ§ШұШҰ Щ…ШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІ ЩҮЩҲ Ш§Щ„ЩӮШ§ШұШҰ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…ЩҲШ°Ш¬ЩҠxx. Ш°Щ„Щғ ШЈЩҶЩ‘ ЩҒЩ„Щ„Щ…ШұЩҲЩҠЩ‘ В« ШҙШЈЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Щ‘ЩҶШөЩ‘ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘ Ш№Ш§Щ…Щ‘Ш©. ЩҲЩҮЩҲ ЩғШ§ШҰЩҶ ЩҶШөЩҠЩ‘ ЩҲШ«ЩҠЩӮ Ш§Щ„ШҘШұШӘШЁШ§Ш· ШЁШ§Щ„ШұЩ‘Ш§ЩҲЩҠВ»xxi ШҘЩҶЩ‘ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© В«ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©В» Ш№Щ„Щү ШӘЩҶЩҲЩ‘Ш№ Ш§Щ„ЩӮШөШө ЩҒЩҠЩҮШ§ ЩҲШӘШ№ШҜЩ‘ШҜЩҮШ§ШҢ ШӘШӯШ§ЩҒШё Ш№Щ„Щү ЩҮЩҠШҰШ© ШӘЩғШ§ШҜ ШӘЩғЩҲЩҶ Щ…ЩҲШӯЩ‘ШҜШ© ЩҒЩҠ ШӘШҙЩғЩҠЩ„ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘. ЩҒЩӮШҜ Ш§ЩҗШӘЩ‘Ш®Ш°ШӘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠШ© ШҙЩғЩ„ Ш§Щ„ЩҮШұЩ…: Щ…ШӘЩ‘ШіШ№Ш© (Ш·ЩҲЩҠЩ„Ш©) ЩҒЩҠ ШЈЩҲЩ‘Щ„ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш©ШҢ ЩҲШ¶ЩҠЩ‘ЩӮШ© (ЩӮШөЩҠШұШ©) ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШөЩҒШӯШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈШ®ЩҠШұШ©ШҢ ЩҒШҘШ°Ш§ ЩғШ§ЩҶШӘ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„Щү ЩҲШ§Щ„Ш«Щ‘Ш§ЩҶЩҠШ© ШӘЩ…ШӘШҜЩ‘ Ш№Щ„Щү Ш№ШҜШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҒШӯШ§ШӘШҢ ЩҒШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ЩӮШөШө ЩҒЩҠ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Щ„Ш§ ШӘШӘШ¬Ш§ЩҲШІ Ш§Щ„ШөЩҒШӯШ© Ш§Щ„ЩҲШ§ШӯШҜШ©. ШҘЩҶЩ‘ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҙЩ‘ЩғЩ„ Ш§Щ„ЩҮШұЩ…ЩҠЩ‘ ЩҮЩҲ Ш§Щ„Ш°ЩҠ ЩҠШЁШұЩ‘Шұ ШӘЩҲШ§ШӘШұ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ ЩҲШӘШ¬Щ„Щ‘ЩҠШ§ШӘЩҮ ЩҒЩҠ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ШӯШӘЩү ЩҲШөЩ„ ШҘЩ„Щү ЩҶЩҒШ§Ш° Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҲШӘЩҶШ§Щ…ЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩҠ ЩҒЩҠ ШўЩҶ.1- Ш§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ ЩҒЩҠ ШЁЩҶЩҠШ© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© В« ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©В» :ШҘЩҶЩ‘ Ш·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠЩ‘ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ЩҮЩҠ ЩҮЩҠШҰШ§ШӘ ЩҒЩҠ ШӘШөШұЩҠЩҒ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠЩ‘. ЩҲЩ„Щ…Щ‘Ш§ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЈЩ…Шұ ЩғШ°Щ„Щғ ЩҒШҘЩҶЩ‘ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҶЩҒ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© ЩҠШЁШҜЩҲ ЩҒЩҠ Ш§ЩҗШ№ШӘЩӮШ§ШҜЩҶШ§ Щ…ШіШЈЩ„Ш© ЩҶЩӮШҜЩҠЩ‘Ш© Ш¬ШҜЩҠШұШ© ШЁШ§Щ„ШҜЩ‘ШұШ§ШіШ© ЩҲШ§Щ„ШӘШ№ШұЩ‘ЩҒ Ш№Щ„Щү ШЈШЁШұШІ Щ…Щ„Ш§Щ…ШӯЩҮШ§ Ш®Ш§ШөЩ‘Ш© ШӯЩҠЩҶЩ…Ш§ ЩҠШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ Ш§Щ„ШЈЩ…Шұ ШЁЩ…ШіШЈЩ„Ш© ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ© ШЁШ§ЩҗШ№ШӘШЁШ§Шұ ШЈЩҶЩ‘ Ш°Щ„Щғ ЩҠЩҸШ№ШӘШЁШұ ШұШӨЩҠШ©ЩӢ Ш¬Щ…Ш§Щ„ЩҠШ©ЩӢ ЩҲШҘШЁШҜШ§Ш№ЩҠШ© ЩҒЩҠ ШўЩҶШҢ Ш®Ш§ШөЩ‘Ш© ШҘШ°Ш§ Щ…Ш§ ШӘШ№Щ„Щ‘ЩӮ Ш§Щ„ШЈЩ…Шұ ШЁЩғЩҠЩҒЩҠШ© ШҘЩҶШ¬Ш§ШІ Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШЎ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘ Щ„Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© ЩҲШіЩҸШЁЩ„ ШӘШҙЩғЩҠЩ„ЩҮ ЩҒЩҠ ЩғШӘШ§ШЁШ§ШӘЩҮ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҶЩҮШ¶ ШЈШіШ§ШіЩӢШ§ Ш№Щ„Щү Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘. ЩҲШӘЩ„Щғ Ш§ЩҗШіШӘШұШ§ШӘШ¬ЩҠШ© ЩҶШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҲ Ш®ЩҠШ§Шұ Щ„ШәЩҲЩҠЩ‘ Ш§ЩҗЩҶШӘЩҮШ¬ЩҮ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ЩҒЩҠ ШөЩҠШ§ШәШ© ЩҶШөЩҲШөЩҮ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш©ШҢ Щ„Ш°Щ„Щғ Ш§ЩҗШӘЩ‘ШіЩ…ШӘ ШЈШәЩ„ШЁ ЩғШӘШ§ШЁШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ШЁШ§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ Ш§Щ„Ш№ШЁШ§ШұШ© ЩҲШ§ЩҗШ®ШӘШІШ§Щ„ЩҮШ§ . ЩҒЩғШ§ЩҶ Щ„Ш§ ШЁШҜЩ‘ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЁШӯШ« ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШўЩ„ЩҠШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШЈШіШ§Щ„ЩҠШЁ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҲШіЩ‘Щ„ ШЁЩҮШ§ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ЩҒЩҠ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ ЩҶШөЩҲШөЩҮ Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ©. ЩҲЩҮЩҠ ЩҒЩҠ Ш§ЩҗШ№ШӘЩӮШ§ШҜЩҶШ§ ШўЩ„ЩҠШ§ШӘ ЩҲШЈШіШ§Щ„ЩҠШЁ ШӘШӘЩ‘Ш®Ш° Щ…ЩҶ ШӘЩӮЩҶЩҠШ© ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ШөЩ‘Щ…ШӘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ШіШЁЩҠЩ„Ш§ЩӢ ЩҒЩҠ ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ©. ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШўЩ„ЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШҙШ§Ш№ШӘ ЩҒЩҠ ШЈШәЩ„ШЁ ЩҶШөЩҲШөЩҮ ЩҲШӯЩғЩ…ШӘ ШЁЩҶЩҠШӘЩҮШ§ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ШӯШӘЩү Ш§ЩҗШіШӘШӯШ§Щ„ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„Щ„ШәЩҲЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘ Ш®Ш·Ш§ШЁЩӢШ§ Щ…ЩғШӘЩҶШІЩӢШ§ ЩҮЩҲ Ш§Щ„ШўШ®ШұШҢ ШЁШ§ЩҗШ№ШӘШЁШ§Шұ ШЈЩҶЩ‘ ШӘШұЩғЩҠШЁ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҠЩҸШ№ШҜЩ‘ ШЈШЁШұШІ Щ…ЩғЩҲЩ‘ЩҶШ§ШӘ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘.Щ„Ш°Ш§ ШіЩҲЩҒ ЩҶШӘШӘШЁЩ‘Ш№ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© ЩҲЩҶШӘШЁЩҠЩ‘ЩҶ Щ…ШҜЩү ШҙЩҠЩҲШ№ ШӘЩӮЩҶЩҠШ© Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ЩҲШ§Щ„ЩҲЩӮЩҲЩҒ Ш№ЩҶШҜ Щ…ЩғЩҲЩ‘ЩҶШ§ШӘЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҲЩҮЩҠШҰШ§ШӘ ШӘШөШұЩҠЩҒЩҮШ§ Щ…ЩҶ ШӯЩҠШ« Ш§Щ„ШЁШіШ§Ш·Ш©ЩҸ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘ШұЩғЩҠШЁЩҸ Ш®Ш§ШөЩ‘Ш© .ШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШҘЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҮЩҲ ЩҮЩҠШҰШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© ЩҲШўЩ„ЩҠЩ‘Ш© Щ„ЩҮШ§ Ш®ШөШ§ШҰШөЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩ‘ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘. ЩҲШ§Щ„Щ…ШЁШӯШ« Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘ ЩғЩҒЩҠЩ„ ШЁШЈЩҶЩ’ ЩҠЩҶЩҮШ¶ ШЁШ§Щ„ЩғШҙЩҒ Ш№ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩӮЩҶЩҠЩ‘Ш© . Щ„Ш°Щ„Щғ ЩҒШҘЩҶЩ‘ЩҶШ§ ШіЩҶШӘЩҲШіЩ‘Щ„ ШЁЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…Щ„ЩҒЩҲШё Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ Щ„Щ„ЩҲЩӮЩҲЩҒ Ш№Щ„Щү Ш·ШұЩҠЩӮШ© Ш§ЩҗШіШӘШ№Щ…Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҲШЈЩҲШ¬ЩҮ Ш§Щ„ШӘШөШұЩ‘ЩҒ ЩҒЩҠЩҮШ§В« ЩҒШәШ§ШҰЩҠШ© Ш§Щ„ШӯШҜШ« Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠЩ‘ ШӘЩғЩ…ЩҶ ЩҒЩҠ ШӘШ¬Ш§ЩҲШІ Ш§Щ„ШҘШЁЩ„Ш§Шә ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҘШ«Ш§ШұШ©. ЩҲШӘШЈШӘЩҠ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Щ…ЩӮШ§Щ… Щ„ШӘШӘШӯШҜЩ‘ШҜ ШЁШҜШұШ§ШіШ© Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШЁЩҮШ§ ЩҠШӘШӯЩҲЩ‘Щ„ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш№ЩҶ ШіЩҠШ§ЩӮЩҮ Ш§Щ„ШҘШ®ШЁШ§ШұЩҠЩ‘ ШҘЩ„Щү ЩҲШёЩҠЩҒШӘЩҮ Ш§Щ„ШӘШЈШ«ЩҠШұЩҠЩ‘Ш© ЩҲШ§Щ„Ш¬Щ…Ш§Щ„ЩҠЩ‘Ш©.В»xxiiШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШЁШӯШ« ЩҒЩҠ Щ…ШіШЈЩ„Ш© Ш§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҮЩҲ ЩғШҙЩҒ Ш№ЩҶ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШіЩ‘Щ…Ш§ШӘ Ш§Щ„ШЁЩҶЩҠЩҲЩҠЩ‘Ш© Щ„Ш№Щ…Щ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШҘШЁШҜШ§Ш№ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Щ…Ш¬Ш§Щ„Ш§ШӘЩҮШ§. ЩҲЩғЩҠЩҒ ШӘШҙЩғЩ‘Щ„ШӘ Ш·ШұЩӮ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ„ЩҒЩ‘Шё ЩҒЩҠЩҮШ§ ШҢ ШіШ№ЩҠЩӢШ§ ШҘЩ„Щү Ш§ЩҗШіШӘЩҶШЁШ§Ш· ЩӮЩҲШ§Ш№ШҜ ЩҲЩ…ЩҶШ§ЩҮШ¬ Ш№Ш§Щ…Щ‘Ш© ШӘШӨШіЩ‘Ші Щ„ЩӮЩҠШ§Щ… ШөЩ…ШӘ ШӯЩғШ§ШҰЩҠЩ‘ ЩғЩҶШёШ§Щ… ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҒЩҠ ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ. ЩҲШӘЩҸШЁШұШІ ЩҶЩ…Ш·ЩӢШ§ Ш®Ш§ШөЩ‘Ш§ЩӢ ЩҒЩҠ ЩғЩҠЩҒЩҠШ© ШӘШҙЩғЩҠЩ„ЩҮ Щ„ШәЩҲЩҠЩӢШ§ ЩҲШұШіЩ… Щ…Ш№Ш§Щ„Щ…ЩҮ ЩҒЩҠ Щ„ЩҲШӯШ§ШӘ ШіШұШҜЩҠЩ‘Ш© Щ…ШӘШӘШ§Щ„ЩҠЩ‘Ш© ЩҲ ШЁШ§Щ„ШӘЩ‘Ш§Щ„ЩҠ ШӘЩӮШҜЩҠЩ…ЩҮ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Щ…ШӘЩ„ЩӮЩ‘ЩҠ ЩҒЩҠ ЩҮЩҠШҰШ© ШӘШ®Ш¶Ш№ ШҘЩ„Щү Щ…ЩӮШӘШ¶ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҲШіШЁЩ„ Ш§Щ„ШӘШөШұЩ‘ЩҒ ЩҒЩҠЩҮШ§ . ЩҲЩҮШ°Ш§ Ш№Щ…Щ„ ЩҠШЁШҜШЈ ЩғЩ…Ш§ ЩҠЩӮЩҲЩ„ ШұЩҠЩҒШ§ШӘЩҠШұ В« Щ…Ш№ ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§Щ„Ш¬Ш© Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠЩ‘Ш© ЩҲШ§Щ„ШЈШіЩ„ЩҲШЁЩҠЩ‘Ш© Щ„Щ„Щ…ЩӮШұЩҲШЎ ЩҲЩ…ШӯШ§ЩҲЩ„Ш© ШӘШ¬Ш§ЩҲШІ ШҘЩғШұШ§ЩҮШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠЩ‘Ш© ЩҲЩҒЩғЩ‘ ШіЩҶЩҶЩҮ ЩҲЩ…Ш№ШұЩҒШ© ШіЩҠШ§ЩӮШ§ШӘЩҮ ШЁШӯЩ„Щ‘ ШӘЩҶШ§ЩӮШ¶Ш§ШӘЩҮ Ш§Щ„Щ…ШӘШӘШ§Щ„ЩҠЩ‘Ш© В»xxiii ЩҒЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠЩ‘ Ш¬ШіЩ‘ШҜЩҮ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Щ…Ш№ШӘЩ…ШҜЩӢШ§ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ Ш№Щ„Щү ШЈШіШ§Щ„ЩҠШЁ Щ„ШәЩҲЩҠЩ‘Ш© Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒШ© ЩҮЩҠ ЩҒЩҠ ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩ…Шұ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Щ…ШӘШ№Ш§Ш¶ШҜШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш№Щ„Ш§Щ…Ш§ШӘ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәЩҲЩҠЩ‘Ш© xxivШҢ ЩҲЩ„ШӘШ¬ШіЩҠШҜ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш¬Ш§ЩҶШЁ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШёШұЩҠЩ‘ ЩғШ§ЩҶ Щ„ШІШ§Щ…ЩӢШ§ Ш№Щ„ЩҠЩҶШ§ Ш§Щ„Ш§ЩҗШҙШӘШәШ§Щ„ Ш№Щ„Щү ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Щ…ЩҶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩӮШөШө Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© . Щ„Ш°Щ„Щғ ЩҶЩҶШёШұЩҸ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш«Щ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩ‘ШұШ§ЩғЩҠШЁ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ШіШӘШ№Щ…Щ„Ш© ЩҒЩҠ Ш·ШұШ§ШҰЩӮ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ:- ШҙЩҠШ® Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© : Щ„Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҙЩҠШ® ЩҠШҜЩҠШұ ШҙШӨЩҲЩҶЩҮШ§/ЩҲЩҠШӘЩҒЩӮШҜ ШЈШӯЩҲШ§Щ„ЩҮШ§ / ЩҲЩҠШӘШ№ЩҮЩ‘ШҜ Щ…ЩғШӘШіШЁШ§ШӘЩҮШ§ /ЩҠШӯШӘЩғЩ… Ш№Щ„Щү ЩҠШҜЩҠЩҮ /ЩҠШӯЩ„ Ш®Щ„Ш§ЩҒШ§ШӘЩҮШ§ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ЩҮШ§ /Ш°ЩғЩҠ/ ЩҒШ·ЩҶ/ ЩҲШҜШ§ЩҮЩҠШ©/ЩҠШіЩҲШіЩҮШ§ ШЁШ§Щ„ШӯЩғЩ…Ш© /ШҙШҜЩҠШҜ ЩҒЩҠ ЩҲЩӮШӘ ЩҠШӯШӘШ§Ш¬ ЩҒЩҠЩҮ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„ШҙШҜШ© /ЩҲЩ„ЩҠЩҶ ЩҒЩҠ ЩҲЩӮШӘ ЩҠШӯШӘШ§Ш¬ ЩҒЩҠЩҮ ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Щ„ЩҠЩҶ/ЩҠШӯШӘШұЩ…ЩҮ Ш§Щ„ШөШәЩҠШұ ЩҲШ§Щ„ЩғШЁЩҠШұ/Ш§Щ„ШұШ¬Ш§Щ„ ЩҲШ§Щ„ЩҶШіШ§ШЎ/ЩҠЩғЩҲЩҶ ШұЩ…ШІШ§ Щ„ЩҮЩ… /ЩҠШӘШіЩ… ШЁШ§Щ„ЩҮЩҠШЁШ© ЩҲШ§Щ„ЩҲЩӮШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҲШ§Ш¶Ш№/xxv- Ш®ЩҠЩ…Ш© Ш§Щ„Ш®ШӘШ§ЩҶ: ШӘЩӮШҜЩ… Ш§Щ„Ш·ШЁШ®Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШЈЩғЩ„Ш§ШӘ/ ЩҠЩҲШ¶Ш№ Ш§Щ„Ш·ЩҒЩ„ ШӘШӯШӘ Ш§Щ„Ш®ЩҠЩ…Ш© / ЩҠШөШ·ЩҒ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші Щ„Щ„ШҜЩ‘Ш®ЩҲЩ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®ЩҠЩ…Ш© /ЩҠШіЩ„Щ… / ЩҠШҜЩҲ Ш§Щ„Щ„ЩҮ/ ЩҠЩӮШҜЩ… ЩҲШ¬ШЁШ© ЩҠЩҲЩ…ЩҠШ© / ЩҠЩҶШӘШёШұЩҲЩҶ ЩӮШҜЩҲЩ… Ш§Щ„Щ…ЩҲЩғШЁ / Ш§Щ„ЩҶШіШ§ШЎ ЩҠШҙШӘШұЩғЩҶ ЩҒЩҠ ШҘШ№ШҜШ§ШҜ Ш§Щ„Ш·ШЁШ®Ш§ШӘ /ЩҮЩҶ ЩҠШІШәШұШҜЩҶ / ЩҠШ®ШӘЩҶ Ш§Щ„Ш·ЩҒЩ„ /ШӘШіЩ…Ш№ ШЈШөЩҲШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҶШіШ§ШЎ/ШӘШ·Щ„ЩӮ Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҜЩӮ Ш·Щ„ЩӮШ§ШӘ /xxvi- Щ…ЩҮЩҲЩү Ш§Щ„ЩҶШ¬Щ… : Ш§Щ„ШұШ§Ш№ЩҠ ЩҠШӯШӘШұШі Ш¬ШҜШ§ / ЩҠШӯШ§ЩҲЩ„ ШЈЩҶ ЩҠЩ„ШӘЩҒ ШЁШЈШәЩҶШ§Щ…ЩҮ / ЩҠЩҲШ§ШөЩ„ ШұШӯЩ„ШӘЩҮ /ЩҠЩ…Шұ Щ…ЩҶ Щ…ЩҮЩҲЩү Ш§Щ„ЩҶШ¬Щ… ЩҠШ°ЩғШұ ШЈЩҶ Ш№Ш§ШҰЩ„ШӘЩҮ ЩғШ§Щ…Щ„Ш©/ ШәШұЩӮШӘ Ш№Ш§ШҰЩ„ШӘЩҮ /ШӯШ§ЩҲЩ„ ШҘЩҶЩӮШ§Ш°ЩҮШ§ / Ш°ЩҮШЁ Ш§Щ„ЩҲШ§ШӯШҜ ШӘЩ„ЩҲЩү Ш§Щ„ШўШ®Шұ /ШәШұЩӮЩҲШ§ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ / Ш§ШЁШӘЩ„Ш№ЩҮЩ… Ш§Щ„Щ…Ш§ШЎ /Щ„Ш§ ЩҠШ№Щ„Щ… ШЈШӯШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШўЩҮШ§Щ„ЩҠ /xxvii- ШӯЩҠШ§Ш© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©: Ш§Щ„ШұШ¬Щ„ Ш§Щ„ЩғШЁЩҠШұ ЩҠШҙШ№Щ„ Ш§Щ„ЩҶШ§Шұ/ЩҠШҙШ№Шұ ШЁШ§Щ„ШҜЩҒШЎ/ ЩҠЩӮЩ„ШЁ Ш§Щ„ЩғШұШЁ/ ШЈЩҲЩӮШҜ ШӘШӯШӘЩҮШ§ / Ш·ШЁШ® Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ Ш№Щ„ЩӮ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ШЈЩғЩҠШ§Ші/ЩҠЩҲШ¬ШҜ Щ…ШҙШұШЁ Ш§Щ„ШіШӘЩҠЩ„ Ш§Щ„ШЁШ§ШұШҜ / Ш§Щ„ШҜШ®Ш§ЩҶ ЩҠШұШӘЩҒШ№ Ш№Ш§Щ„ЩҠШ§/ ЩҲЩҮЩҲ ЩҠШЁШӘШіЩ…/ ШӘШӘШ№Ш§Щ„Щү Ш§Щ„ШЈШөЩҲШ§ШӘ / ШӘШӘЩ…Ш§ШІШ¬/ Ш§Щ„ШЈШ·ЩҒШ§Щ„ ЩҠШӘШ¬Щ…Ш№ЩҲЩҶ / ЩҠШ¬ШӘЩ…Ш№ Ш§Щ„ШұШ¬Ш§Щ„ Щ„ШӘЩҶШ§ЩҲЩ„ Ш§Щ„ЩӮЩҮЩҲШ© / ЩҮЩҶШ§Щғ ЩҠШ¬ШӘЩ…Ш№ЩҶ Ш§Щ„ЩҶШіШ§ШЎ / ЩҠШӘЩҶШ§ЩҲЩ„ЩҶ Ш§Щ„ЩӮЩҮЩҲШ© ЩҠШӘШЁШ§ШҜЩ„ЩҶ Ш§Щ„ШЈШ®ШЁШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ШЈШӯШ§ШҜЩҠШ«/xxviiiШҘЩҶЩ‘ Ш§Щ„Щ…ШӘШЈЩ…Щ‘Щ„ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ШіЩ‘Ш§Щ„ЩҒШ© Ш§Щ„Ш°Щ‘ЩғШұ Щ…ЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Ш§Щ„ЩӮШөШөxxix Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘Ш© В«ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© В»ЩҠЩ„ШӯШё ШЁЩ…Ш§ Щ„Ш§ ЩҠШҜШ№ Щ…Ш¬Ш§Щ„Ш§ЩӢ Щ„Щ„ШҙЩғЩ‘ ШЈЩҶЩ‘ЩҮШ§ Ш№Щ„Щү ЩӮШҜШұ ЩғШЁЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШөШұ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҠШ¬Ш§ШІ ШӘЩҒШөЩ„ ШЁЩҠЩҶ Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒ Щ…ЩғЩҲЩ‘ЩҶШ§ШӘЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ©В«Ш§Щ„Щ…ШЁШӘШҜШЈ ЩҲШ§Щ„Ш®ШЁШұ/Ш§Щ„ЩҒШ№Щ„ ЩҲШ§Щ„ЩҒШ§Ш№Щ„ ЩҲШ§Щ„Щ…ШӘЩ…Щ‘Щ…Ш§ШӘ В» Ш§Щ„ЩҶЩ‘ЩӮШ§Ш·ЩҸ ЩҲШ§Щ„ЩҒЩҲШ§ШөЩ„ЩҸШҢ ЩғЩ…Ш§ ШЈЩҶЩ‘ЩҶШ§ Щ„Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ЩҶЩ„ШӯШё ЩҒЩҠЩҮШ§ Ш№ШЁШ§ШұШ© ШІШ§ШҰШҜШ© ШЈЩҲ ШҘЩҒШ§Ш¶Ш© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШіЩ„ЩҲШЁ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶЩ’ ШӘЩҶШӯЩҲ Щ…ЩҶШӯЩү Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШіЩҠШұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩ‘ШЁШұЩҠШұxxx ШЁЩӮШҜШұ Щ…Ш§ ШӘЩӮЩҒ Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш«Щ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Щ…ЩҲЩӮЩҒ Ш§Щ„ШӯЩҠШ§ШҜ ЩҲШӘЩӮШҜЩҠЩ… Ш§Щ„Щ…Ш№Щ„ЩҲЩ…Ш© ЩғЩ…Ш§ ЩҮЩҠ ШҜЩҲЩҶ ШІЩҠШ§ШҜШ© ШЈЩҲ ЩҶЩӮШөШ§ЩҶxxxi ЩҲШҘЩ„Щү Ш°Щ„Щғ ШӘЩҶЩҮШ¶ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШЈЩ…Ш«Щ„Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШөШө Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Ш№Щ„Щү Ш§Щ„Ш§ЩҗШ®ШӘШІШ§Щ„. ЩҒШҘШ°Ш§ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ЩҒЩҠ ШәШ§Щ„ШЁ Ш§Щ„ШЈШӯЩҠШ§ЩҶ ШЁШіЩҠШ·Ш©xxxii Щ…ШӘЩғЩҲЩ‘ЩҶШ© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Щ…ШіШӘЩҲЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ© Ш§Щ„Ш¶Щ‘ШұЩҲШұЩҠШ© Ш§Щ„ШҜЩ‘ЩҶЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘШіШӘЩӮЩҠЩ… ШЁЩҮШ§ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„Ш© . ЩҲШӘШӨШҜЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҶЩү.Ш№Щ„Щү ШЈЩҶЩ‘ЩҶШ§ ЩҶЩҒШұЩ‘ЩӮ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…Ш§Ш°Ш¬ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШөЩҠЩ„Ш§ШӘ ЩҲШ§Щ„Ш¬ШІШҰЩҠЩ‘Ш§ШӘ Ш§Щ„Ш¶Щ‘ШұЩҲШұЩҠЩ‘Ш© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩ…ЩғЩҶ ШЈЩҶ ЩҠЩ„ШӯЩ‘ Ш№Щ„ЩҠЩҮ ШөЩҶЩҒ Щ…Ш®ШөЩҲШө Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ЩҠЩӮШӘШ¶ЩҠЩҮШ§ Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩҒЩҶЩ‘ЩҠЩ‘ Ш°Ш§ШӘЩҮШҢ ЩҲШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШӘЩҒШөЩҠЩ„Ш§ШӘ Ш§Щ„ШІЩ‘Ш§ШҰШҜШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ Щ„Ш§ ЩҠШ№Щ…Щ„ Ш§Щ„ШіЩ‘Ш§ШұШҜ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШЁЩҲШӯ ШЁЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ ЩҲШәЩҠШұЩҮШ§ Щ…ЩҶ ЩҶШөЩҲШө Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Ш§Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Ш®Ш§ШөЩ‘Ш©ШҢ ЩҲЩҮЩҠ Ш№Ш§ШҜШ© Щ…Ш§ ЩҸЩҠЩӮШөШҜ ШЁЩҮШ§ ШӘШ¶Ш®ЩҠЩ… ШӯШ¬Щ… Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҗШіШӘШұШіШ§Щ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§Щ… ШҜЩҲЩҶ Щ…ШЁШұЩ‘Шұ Щ„Ш°Щ„Щғ . ЩҲЩ„Щ… ШӘШ№ШӘШЁШұ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШӘЩ‘ЩҒШөЩҠЩ„Ш§ШӘ Щ…ЩҶ ЩҒЩҶЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ЩӮШөЩ‘Ш© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© ЩҲШҘЩҶЩ‘Щ…Ш§ ЩҠЩ…ЩғЩҶ Ш§Щ„Ш§ЩҗШіШӘШәЩҶШ§ШЎ Ш№ЩҶЩҮШ§ ЩҲШӯШ°ЩҒЩҮШ§ ЩҲЩҮЩҲ Щ…Ш§ ЩҲЩӮШ№ ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Щ…Ш§Ш°Ш¬ Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШӯЩҲЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩҶШӘЩ…ЩҠ ШҘЩ„Щү ЩӮШөШө Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Щ…ЩҲШ¶ЩҲШ№ Ш§Щ„ШҜЩ‘ШұШі ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШЁШӯШ« Щ„ШЈЩҶЩ‘ ЩҲШ¬ЩҲШҜЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҲШөЩҒ ШЈЩҲ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӯЩҲШ§ШұШҢ ЩҠШ¶ШұЩ‘ ШЁЩ…ЩӮШӘШ¶ЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„Ш№Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠЩ‘ ЩҲШўЩ„ЩҠШ§ШӘЩҮ.----------------------------------------------------Ш§Щ„ЩҮЩҲШ§Щ…Шҙ :1- ШЈШіШӘШ§Ш° Щ…ШіШ§Ш№ШҜ ШЁШ§Щ„ШӘШ№Щ„ЩҠЩ… Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„ЩҠШҢ ЩғЩ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШўШҜШ§ШЁ ШЁШөЩҒШ§ЩӮШіШҢ Ш§Щ„Щ…Ш№ЩҮШҜ Ш§Щ„Ш№Ш§Щ„ЩҠ Щ„Щ„ШәШ§ШӘ ЩӮШ§ШЁШі- - ШӘЩҲЩҶШі.2- ШЈЩҶШёШұ :ШЈШӯЩ…ШҜ Ш§Щ„ШіЩ‘Щ…Ш§ЩҲЩҠШҢ ЩҒЩҶЩ‘ Ш§Щ„ШіЩ‘ШұШҜ ЩҒЩҠ ЩӮШөШө Ш·ЩҮ ШӯШіЩҠЩҶ. ШөЩҒШ§ЩӮШі. Щ…Ш·. Ш§Щ„ШӘЩ‘ШіЩҒЩҠШұ Ш§Щ„ЩҒЩҶЩ‘ЩҠ. 2000 Шө8.ЩҲШ§ЩҸЩҶШёШұ ЩғШ°Щ„Щғ:_ Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠ ШҢ Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ШҢ ШҜШ§Шұ ШөШ§Щ…ШҜ ШҢ ШӘЩҲЩҶШіШҢ Щ…Ш§ЩҠ 2014ШҢ Ш· 1 . Шө9.- Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„Ш№ШІЩҠШІ ШҙШЁЩҠЩ„ ШҢ ЩҶШёШұЩҠШ© Ш§Щ„ШЈШ¬ЩҶШ§Ші Ш§Щ„ШЈШҜШЁЩҠШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШӘШұШ§Ш« Ш§Щ„ЩҶШ«ШұЩҠ ШҢ Ш¬ШҜЩ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШәЩҠШ§ШЁ ЩҲШ§Щ„ШӯШ¶ЩҲШұШҢ Ш· 1 ШіШЁШӘЩ…ШЁШұ 2001 ШҜШ§Шұ Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш№Щ„ЩҠ Ш§Щ„ШӯШ§Щ…ЩҠ ШӘЩҲЩҶШіШҢ Шө13ШҢ143 - ШЁЩ„ЩӮШ§ШіЩ… Щ…Ш§ШұШіШҢ ШЁЩ„Ш§ШәШ© Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮШөШ© Ш§Щ„ЩӮШөЩҠШұШ© Ш¶ЩҲШЎ Ш¶Ш№ЩҠЩҒ Щ„Ш§ ЩҠЩғШҙЩҒ ШҙЩҠШҰШ§ Щ„Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш§Щ„ШЁШіШ§Ш·ЩҠ ШҢ ШҜШ§Шұ ШұШіЩ„Ш§ЩҶ Щ„Щ„ЩҶШҙШұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҲШІЩҠШ№ ШҢ2015 Шө3.4- Ш§ЩҸЩҶШёШұ ШөШЁШұЩҠ ШӯШ§ЩҒШё ШҢВ« Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Щ„Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© В» ШҢ Щ…Ш¬Щ„Ш© ЩҒШөЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ„ШҜ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Ш№ШҜШҜ 4 Щ„ШіЩҶШ© 1982.5 - ЩғШ§ШӘШЁ ЩҲШҙШ§Ш№Шұ Щ…ЩҶ Щ…ЩҲШ§Щ„ЩҠШҜ ШіЩ„Ш·ЩҶШ© Ш№Щ…Ш§ЩҶ ШҢ ШҜЩ…Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„Ш·Ш§ШҰЩҠЩҠЩҶШҢ Щ…ЩҶ Щ…ШӨЩ„ЩҒШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„Ш№ШЁЩҲШҜЩҠШ© ЩҲШЈШ«ШұЩҮШ§ ЩҒЩҠ ШҙШ№Шұ Ш№ЩҶШӘШұШ© ШҢ ШҜШұШ§ШіШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШҜШЁ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„ЩӮШҜЩҠЩ… ШҢ Щ…ЩӮШ§ШөШЁ Ш№Ш§Щ…Шұ ШЁЩҶ ШіЩҠЩҒ ШӘШӯЩӮЩҠЩӮ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШҙШ№Шұ Ш§Щ„ШҙШ№ШЁЩҠ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ШҢ ЩҲЩ…Ш¶Ш§ШӘ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШҜШЁ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ ШҜШұШ§ШіШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШҜШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҶЩӮШҜ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШҢ Ш¬ЩҲШ§ЩҮШұ Ш№ШұШЁЩҠШ© Щ…ЩӮШ§Щ„Ш§ШӘ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШЈШҜШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҶЩӮШҜ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠШҢ ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШіЩҠШұШ© Щ„Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶ .6- ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ: ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢШіЩҠШұШ© Ш§Щ„Щ…ЩғШ§ЩҶ ЩҲШ§Щ„ШІЩ…Ш§ЩҶШҢ ШҜШ§Шұ ЩғЩҶЩҲШІ Ш§Щ„Щ…Ш№ШұЩҒШ© ШҢ 2015ШҢ Ш·17- Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠ ШҢ В« Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠЩ‘ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ В» ШҢ Ш°ЩғШұ ШіШ§ШЁЩӮШ§ШҢ ЩҠШіШ№Щү Ш§Щ„Щ…ШӨЩ„ЩҒ ЩҒЩҠ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁ ШҢ 254 ШөЩҒШӯШ©ШҢ ШҘЩ„Щү ШӘШҜШЁЩ‘Шұ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ЩҶЩҲШ№ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШіШұШҜ Ш§Щ„Щ…ЩӮШӘШ¶ШЁ ЩҲШ§Щ„ЩҲШ¬ЩҠШІ ЩҲШ§Щ„ШЁШӯШ« ЩҒЩҠ ШіЩҠШ§ЩӮШ§ШӘЩҮ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ЩҠШ© ЩҲЩӮШҜ ШӘШ¶Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁ Ш®Щ…ШіШ© ЩҒШөЩҲЩ„ ШҢ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„ШЈЩҲЩ„ : Щ…ШёШ§ЩҮШұ Ш§Щ„ШӘЩ…Ш§ЩҠШІ ШЁЩҠЩҶ Щ…ЩӮШ§ШұЩҶШ© Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠ ЩҲШ§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШұЩҲШ§ШҰЩҠ ЩҲЩ…ЩҶ Ш®Щ„Ш§Щ„ЩҮ ЩҠЩӮШ§ШұЩҶ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ЩҲШ§Щ„ШұЩҲШ§ЩҠШ© ЩҲЩ…Ш§ ШӘШӘЩ…ЩҠЩ‘ШІ ШЁЩҮ ЩғЩ„ Щ…ЩҶЩҮЩ…Ш§ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ : ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩӮШ§ШұЩҶ ШЁЩҠЩҶ ЩӮЩҠШҜ ШҜЩҲ Щ…Ш§ШЁШіЩҲЩҶ ЩҲ ЩҠЩҲШіЩҒ ШҘШҜШұЩҠШі ЩҲЩҮЩҲ ЩҒШөЩ„ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҠШ© Щ„Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ШЈЩ…Щ‘Ш§ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„Ш«Ш§Щ„Ш« :ЩҒЩҮЩҲ Ш§Щ„ШӘЩғШ«ЩҠЩҒ Ш®Ш§ШөЩҠШ© Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ЩҲЩҮЩҲ ЩҒШөЩ„ ЩҠЩҶШёШұ ЩҒЩҠ ШҜЩҲШұ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ЩҒЩҠ ШӘШҙЩғЩҠЩ„ ШЈШЁШ№Ш§ШҜ Ш§Щ„ЩҶЩ‘Шө Ш§Щ„Ш¬Щ…Ш§Щ„ЩҠШ© ЩҒЩҠ ШӯЩҠЩҶ ШӘШ№Щ„ЩӮ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„Ш§ЩҶ Ш§Щ„ШұЩ‘Ш§ШЁШ№ ЩҲШ§Щ„Ш®Ш§Щ…Ші ШЁШ§Щ„Щ…ЩӮШ§ШұШЁШ© Ш§Щ„ШҘШ¬ШұШ§ШҰЩҠШ© .8 - ШЈШҙШ§Шұ Ш§Щ„ЩҶШ§ЩӮШҜ Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Щ…ЩҶ ЩғШӘШ§ШЁЩҮ В« Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩ‘ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠЩ‘ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„ В» ЩҲШЁШ§Щ„ШӘШӯШҜЩҠШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҲШіЩҲЩ… ШЁЩҖ В« ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш®Ш·Ш§ШЁ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠЩ‘ Ш§Щ„Щ…ЩӮШ§ШұЩҶ ШЁЩҠЩҶ ЩӮЩҠШҜ ШҜЩҲЩ…Ш§ШЁШіШ§ЩҶ ЩҲ ЩҠЩҲШіЩҒ ШҘШҜШұЩҠШі В» ШҘЩ„Щү Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ЩҒЩҶЩҠШ© Щ„Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© Ш§Щ„ЩғЩҲЩҶЩҠШ© Щ…ЩҶ ЩӮШЁЩҠЩ„ Ш§Щ„ШЁШҜШ§ЩҠШ© Ш§Щ„ШіШұЩҠШ№Ш© ШәЩҠШұ Ш§Щ„Щ…ШӘШұШ§Ш®ЩҠШ© ЩҲ Ш§Щ„ЩҶЩҮШ§ЩҠШ© Ш§Щ„Щ…ЩҒШ§Ш¬ШҰШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ШЁШ§ШәШӘШ© ЩҲЩҲШӯШҜШ© Ш§Щ„Ш§ЩҗЩҶШ·ШЁШ§Ш№ ЩҲШ§Щ„ШЈШ«Шұ ЩҲШ§Щ„ШҘЩҠШӯШ§ШЎ ЩҲШ§Щ„ШӘЩғШ«ЩҠЩҒ ЩҲШ§Щ„ШҘЩӮШӘШөШ§ШҜ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩҗЩӮШӘШ¶Ш§ШЁ ЩҲШ§Щ„ШӘШұЩғЩҠШІ ЩҲШ§Щ„ЩҲШөЩҒ Ш§Щ„ШЁШұЩӮЩҠ Ш§Щ„Щ…ЩҲШёЩҒ ...Ш§ЩҸЩҶШёШұ ЩғШӘШ§ШЁ : Ш§Щ„ШЁШҙЩҠШұ Ш§Щ„ЩҲШіЩ„Ш§ШӘЩҠ : Ш§Щ„ЩҶЩ‘Шө Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөЩҠ ЩҲЩӮШ¶Ш§ЩҠШ§ Ш§Щ„ШӘШЈЩҲЩҠЩ„.(Ш§Щ„ЩҒШөЩ„ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ) Шө149.9- ЩҲЩӮШҜ ШӯШҜЩ‘ШҜ ШөШЁШұЩҠ ШӯШ§ЩҒШё Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Щ„Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ЩҒШЈШ¬Щ…Щ„ЩҮШ§ ЩҒЩҠЩ…Ш§ ЩҠЩ„ЩҠ :- ЩҲШӯШҜШ© Ш§Щ„ШҘЩҶШ·ШЁШ§Ш№ : Ш®ШөЩҠШөШ© Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ЩҲШЈЩғШ«ШұЩҮШ§ ЩҲШ¶ЩҲШӯЩӢШ§ ЩҲЩҮЩҠ Щ…ЩҶ ШЈЩғШ«Шұ Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө ШӘШҜШ§ЩҲЩ„Ш§. ЩҒЩӮШөШұ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© Щ„Ш§ ЩҠШіЩ…Шӯ ШЁШ§Щ„ШӘШұШ§Ш®ЩҠ ШЈЩҲ Ш§Щ„Ш§ЩҗШіШӘШ·ШұШ§ШҜ ШЈЩҲ ШӘШ№ШҜЩ‘ШҜ Ш§Щ„Щ…ШіШ§ШұШ§ШӘ ШЁЩ„ ЩҠШӘШ·Щ„ШЁ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩғШ«ЩҠЩҒ ЩҲШ§Щ„ШӘШұЩғЩҠШІ ЩҲШ§ЩҗШіШӘШҰШөШ§Щ„ ШЈЩҠЩ‘Ш© ШІШ§ШҰШҜШ© ШЈЩҲ Ш№ШЁШ§ШұШ© Щ…ЩғШұЩ‘ШұШ© ШЈЩҠЩ’ ШЈЩҶ ШӘШӘЩ‘Ш¬ЩҮ ЩғЩ„ Ш¬ШІШҰЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© ШҘЩ„Щү Ш®Щ„ЩӮ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„ШЈШ«Шұ Ш§Щ„ЩҲШ§ШӯШҜ ШЁШөЩҲШұШ© ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Щ…ШӯЩғЩ…Ш© ШЈЩҲ ЩҠШӘШӯЩӮЩӮ Ш®Щ„Ш§Щ„ Ш§Щ„Щ…ЩҒШ§ШұЩӮШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ЩҶЩӮШ§ШҰШ¶ ЩҲШ§Щ„Ш°ЩғШұЩҠШ§ШӘ ЩҲШ§Щ„ШӘШЈЩ…Щ„Ш§ШӘ ШЈЩҠ Ш®Щ„ЩӮ Ш§ЩҗЩҶШ·ШЁШ§Ш№ ШЈЩҲ ШЈШ«Шұ ШҘШ¬Щ…Ш§Щ„ЩҠ ЩҲШ§ШӯШҜ .- Щ„ШӯШёШ© Ш§Щ„ШЈШІЩ…Ш© : ЩҮЩҠ Щ„ШӯШёШ© Ш§Щ„ЩғШҙЩҒ ЩҲШ§Щ„Ш§ЩғШӘШҙШ§ЩҒ Щ„ШӯШёШ© Ш§Щ„ШҘШҙШұШ§ЩӮ ЩҲШ§Щ„ЩғШҙЩҲЩҒ ШҘШ° ЩҠЩғШҙЩҒ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҙШ®ШөЩҠШ© ЩҒЩҠ Щ„ШӯШёШ© Щ…Ш№ЩҠЩҶШ© ЩҲЩҮЩҠ Щ„ШӯШёШ© ШӘШ№ШұЩҒ Ш®Щ„Ш§Щ„ЩҮШ§ Ш§Щ„ШҙШ®ШөЩҠШ© ШӘШӯЩҲЩ„Ш§ШӘ ШӯШ§ШіЩ…Ш© .- Ш§Щ„ШіЩ‘ЩҠШ§ЩӮ / Ш§Щ„ШӘШ№Щ…ЩҠЩ… : ЩҮЩҠ Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ШӘЩӮЩҲШҜ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҲШ§ЩӮШ№ ШҘЩ„Щү ШҜШұШ§ШіШ© Ш§Щ„Щ…Щ„Ш§Щ…Шӯ ЩҲШ§Щ„Ш№ЩҶШ§ШөШұ Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Ш§Щ„Щ…Ш®ШӘЩ„ЩҒШ© Ш§Щ„ШӘЩҠ ЩҠЩҶЩҮШ¶ Ш№Щ„ЩҠЩҮШ§ ШҙЩғЩ„ Ш§Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© Щ…ЩҶ ШҙШ®ШөЩҠШ© ЩҲШӯШЁЩғШ© ЩҲШІЩ…ЩҶ ЩҲШЈШӯШҜШ§Ш«. Ш§ЩҸЩҶШёШұ: ШөШЁШұЩҠ ШӯШ§ЩҒШё : Ш§Щ„Ш®ШөШ§ШҰШө Ш§Щ„ШЁЩҶШ§ШҰЩҠШ© Щ„Щ„ШЈЩӮШөЩҲШөШ© Щ…Ш¬Щ„Ш© ЩҒШөЩҲЩ„ Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ„ШҜ Ш§Щ„Ш«Ш§ЩҶЩҠ Ш№ШҜШҜ 4 1982 Щ„ШіЩҶШ© .Шө6.x- ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©ШҢШө19.11 - Ш§ЩҸЩҶШёШұ ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© : ШҙЩҠШ® Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Шө13ШҢ Ш§Щ„ШҙШ§ЩҠШЁ ШІШ§ЩҮШұ Шө 15ШҢ Ш§Щ„ШӘЩҶШ¬ЩҠЩ„ЩҠШ© Шө 23ШҢ Ш§Щ„ШұЩӮШ§Ш· Шө 34ШҢ Ш§Щ„Щ…ШҜЩ„ЩҲЩғ Шө 37ШҢ Ш§Щ„ЩғЩҲШҜЩҠШ© Шө 39ШҢ Ш§Щ„ШұШ№Щү Шө 41ШҢ Ш®ЩҠЩ…Ш© Ш§Щ„Ш®ШӘШ§ЩҶ Шө 43ШҢ Ш№ШІЩҲШ© Ш§Щ„ШҙЩҲШ§ШЎ Шө 46ШҢ Ш·Ш§ЩҮШұ Шө 51ШҢ ШұШӯШЁШ© Ш§Щ„ШЁЩҠЩҲШӘ Шө 61....xii - Ш§ЩҸЩҶШёШұ ЩӮШөШ© Ш№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩғЩҶШ§ ШөШәШ§ШұШ§ ШҢ Шө72 ЩҲ ЩӮШөШ© Ш§Щ„ШЁШ§ШҜШ©ШҢ Шө58 .xiii - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Ш№ЩҶШҜЩ…Ш§ ЩғЩҶШ§ ШөШәШ§ШұШ§ШҢ Шө73.xiv - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Ш№ШІЩҲШ© Ш§Щ„ШҙЩҲШ§ШЎ ШҢШө46.xv - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ©ШҢ Ш§Щ„ШөШҜЩӮШ© ШҢШө15.xvi - Ш§ШЁЩҶ Щ…ЩҶШёЩҲШұШҢ Щ„ШіШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш№ШұШЁ ШҢ Щ…Ш§ШҜШ© ( Щғ.ЩҶ.ШІ.) Ш§Щ„Щ…Ш¬Щ„ШҜ5ШҢ Шө 402 ШҢ ШҜШ§Шұ ШөШ§ШҜШұ ШЁЩҠШұЩҲШӘ1994.Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШІ Ш§Щ„ШҙЩҠШЎ : Ш§ЩҗШ¬ШӘЩ…Ш№ ЩҲШ§ЩҗЩ…ШӘЩ„ШЈ ЩҲЩғЩҶШІ Ш§Щ„ШҙЩҠШЎ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩҲШ№Ш§ШЎ ЩҲШ§Щ„ШЈШұШ¶ ЩҠЩғЩҶШІЩҮ ЩғЩҶШІШ§ ШәЩ…ШІЩҮ ШЁЩҠШҜЩҮ .ЩҲ ШҙШҜЩ‘ ЩғЩҶШІ Ш§Щ„ЩӮШұШЁШ© Щ…Щ„ШЈЩҮШ§ ЩҲ ЩҠЩӮШ§Щ„ Щ„Щ„Ш¬Ш§ШұЩҠШ© Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұШ© Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩғЩҶШ§ШІЩҸ ЩҲЩғШ°Щ„Щғ Ш§Щ„ЩҶШ§ЩӮШ© ..ЩҲЩҶШ§ЩӮШ© ЩғЩҶШ§ШІЩҸ ШЁШ§Щ„ЩғШіШұ ШЈЩҠ Щ…ЩғШӘЩҶШІШ© Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲШ§Щ„ЩғЩҶШ§ШІ Ш§Щ„ЩҶШ§ЩӮШ© Ш§Щ„ШөЩ„ШЁШ© Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲШ§Щ„Ш¬Щ…Ш№ ЩғЩҶЩҲШІ ЩҲ ЩғЩҶШ§ШІ..ЩҲ ШұШ¬Щ„ ЩғЩҶШІ Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲ Щ…ЩғШӘЩҶШІ Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲ ЩғЩҶЩҠШІ Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… ЩҲ Щ…ЩғЩҶЩҲШІЩҮ..Ш§Щ„ЩғЩҶШ§ШІ Ш§Щ„Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ Ш§Щ„Щ„ШӯЩ… Ш§Щ„ЩӮЩҲЩҠЩҮ ЩҲЩғЩ„ Щ…ЩғШӘЩҶШІ Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ ЩҲШ§Щ„ЩғЩҶЩҠШІ Ш§Щ„ШӘЩ…Шұ ЩҠЩғШӘЩҶШІ Щ„Щ„ШҙШӘШ§ШЎ ЩҒЩҠ ЩӮЩҲШ§ШөШұ ЩҲ ШЈЩҲШ№ЩҠШ© ЩҲШ§Щ„ЩҒШ№Щ„ Ш§Щ„Ш§ЩҗЩғШӘЩҶШ§ШІ ЩҲШ§Щ„ШЁШӯШұШ§ЩҶЩҠЩҲЩҶ ЩҠЩӮЩҲЩ„ЩҲЩҶ Ш¬Ш§ШЎ ШІЩ…ЩҶ Ш§Щ„ЩғЩҶШ§ШІ ШҘШ°Ш§ ЩғЩҶШІЩҲШ§ Ш§Щ„ШӘЩ…Шұ ЩҒЩҠ Ш§Щ„Ш¬Щ„Ш§Щ„....xvii . - Umberto Eco, les limites de lвҖҷinterprГ©tation , Ed Bernard Grasset, Paris 1992- p76xviii - Ш§ЩҗШ№ШӘШЁШұ Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШЁЩҮЩ„ЩҲЩ„ ШЈЩҶЩ‘ ШЈЩҲЩ„ Щ…ЩҶШ·Щ„ЩӮШ§ШӘ Ш§Щ„ШЁШӯШ« ЩҮЩҲ Ш§ЩҗШ№ШӘШЁШ§Шұ Ш§Щ„ШөЩ…ШӘ Ш¶ШұЩҲШЁШ§ Щ…ШӘЩ…Ш§ЩҠШІШ© ЩҒЩ…ЩҶЩҮ Щ…Ш§ ЩҠЩғЩҲЩҶ Ш№Ш¬ШІШ§ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҘШЁШ§ЩҶШ© ЩҲШ§Щ„ШӘШ№ШЁЩҠШұ ЩҲЩ…ЩҶЩҮ Щ…Ш§ ЩҠЩғЩҲЩҶ Ш°Ш§ Ш·Ш§ЩӮШ© ШҘШЁЩ„Ш§ШәЩҠШ© ЩҲШЁЩ„Ш§ШәЩҠШ© ШӘЩҒЩҲЩӮ Ш§Щ„Ш·Ш§ЩӮШ© Ш§Щ„ЩғШ§Щ…ЩҶШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§Щ… ЩҠЩғЩҲЩҶ ШӯЩҠЩҶШ§ Щ…ЩҲЩӮЩҒШ§ ЩҠЩҸЩғШұЩҮ Ш№Щ„ЩҠЩҮ Ш§Щ„Щ…ШӘЩғЩ„Щ… ЩҲЩҠЩҸШ¶Ш·ШұЩ‘ ШҘЩ„ЩҠЩҮ ЩҲЩҠЩғЩҲЩҶ ШӯЩҠЩҶШ§ ШўШ®Шұ Щ…ЩҲЩӮЩҒШ§ ЩҠШӘШ®ЩҠШұЩҮ Ш§Щ„Щ…ШӘЩғЩ„Щ… Щ„ШЈШіШЁШ§ШЁ ШӘШ®ШӘЩ„ЩҒ ШЁШ§ЩҗШ®ШӘЩ„Ш§ЩҒ Ш§Щ„Щ…ЩӮШ§Щ…Ш§ШӘ ...Ш§ЩҸЩҶШёШұ Ш№ШЁШҜ Ш§Щ„Щ„ЩҮ Ш§Щ„ШЁЩҮЩ„ЩҲЩ„ :Ш§Щ„ШөЩ‘Щ…ШӘ ШіЩҠШ§ШіШ© ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮЩҲЩ„ ЩғШӘШ§ШЁ Ш§Щ„ШөЩ…ШӘШҢ Ш§Щ„ЩҶШҜЩҲШ© Ш§Щ„Ш№Щ„Щ…ЩҠШ© Ш§Щ„ШҜЩҲЩ„ЩҠШ© ЩғЩ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШўШҜШ§ШЁ ЩҲШ§Щ„Ш№Щ„ЩҲЩ… Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶЩҠШ© ШЁШөЩҒШ§ЩӮШі: ШЈЩҠШ§Щ… 5ШҢ6ШҢ7ШҢ ШЈЩҒШұЩҠЩ„ 2007ШҢШө 83.ЩҲШ§ЩҸЩҶШёШұ ЩғШ°Щ„Щғ :- Piere Van Den Heuvel, Parole , Mot , Silence , pour une poГ©tique de lвҖҷГ©nonciation Librairie JosГ© Corti 1970,pp.73,80.xix - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Шө 16.xx - Umberto Eco ,lвҖҷЕ“uvre ouverte, traduit de lвҖҷitalien par Chantal Roux de BГ©zieux avec le concours dвҖҷAndrГ© boucourechlie v, Г©d вҖ“ Seuil, 1965, p35xxi - Щ…ШӯЩ…ШҜ ЩҶШ¬ЩҠШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§Щ…ЩҠ : Ш§Щ„ШұШ§ЩҲЩҠ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ШіШұШҜ Ш§Щ„Ш№ШұШЁЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш№Ш§ШөШұШҢ ШұЩҲШ§ЩҠШ© Ш§Щ„Ш«Щ…Ш§ЩҶЩҠЩҶШ§ШӘ ЩҒЩҠ ШӘЩҲЩҶШіШҢ ЩҶШҙШұ ШҜШ§Шұ Щ…ШӯЩ…ШҜ Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШӯШ§Щ…ЩҠ ШҢ ЩғЩ„ЩҠШ© Ш§Щ„ШўШҜШ§ШЁ ШіЩҲШіШ© ШҢ 2001 Шө 141.xxii-Georges Mounin, Clefs pour la linguistique, Paris, Г©dition Seghers. 1968, pp: 167,168.xxiii - - Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale, Paris 1971, P: 46.xxiv - В« ШҘШ° Ш§Щ„Щ„Щ‘ШәШ© ЩҒЩҠ Ш¬ЩҲЩҮШұЩҮШ§ Щ„ЩҠШіШӘ ШҘЩ„Ш§Щ‘ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Щ…ЩҶ Ш§Щ„Ш№Щ„Ш§Щ…Ш§ШӘ... ЩҲШЈЩҶЩ‘ ШЈШөЩ„ Ш§Щ„Ш№Щ„Ш§Щ…Ш© ЩҮЩҲ Щ…ШЁШӘШҜШЈ Ш§Щ„ШӘШҙЩғЩ‘Щ„ШҢ ЩҲЩ„ЩғЩҶ ШЈШөЩ„ Ш§Щ„ШӘШҙЩғЩ‘Щ„ ЩҮЩҲ ШӘЩҲЩҒЩ‘Шұ ШөЩҲШұШ© ШӯШіЩҠШ© ШӘШҜШұЩғ Ш№ШЁШұ ШҘШӯШҜЩү ЩӮЩҶЩҲШ§ШӘ Ш§Щ„ШӯЩҲШ§Ші Ш§Щ„Ш®Щ…Ші Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЁШөШұ ЩҲ Ш§Щ„ШіЩ‘Щ…Ш№ ЩҲШ§Щ„Щ„Щ‘Щ…Ші ЩҲШ§Щ„ШҙЩ…Щ‘ ЩҲШ§Щ„Ш°Щ‘ЩҲЩӮ ЩҒШҘШ°Ш§ Ш§ШұШӘШЁШ·ШӘ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШөЩ‘ЩҲШұШ© Ш§Щ„ШӯШіЩҠШ© ШЁШ§Ш¶Ш·Щ„Ш§Ш№ Щ…Ш№ЩҠЩҶ ШЁЩҠЩҶ Ш§Щ„ШЈЩҒШұШ§ШҜ Ш§Щ„Щ…ШҙШӘШұЩғЩҠЩҶ ЩҶШҙШЈШӘ Ш§Щ„Ш№Щ„Ш§Щ…Ш©В» Ш§ЩҸЩҶШёШұШ№ШЁШҜ Ш§Щ„ШіЩ„Ш§Щ… Ш§Щ„Щ…ШіШҜЩҠШҢ Щ…Ш§ ЩҲШұШ§ШЎ Ш§Щ„Щ„ШәШ©ШҢШөШҢШөШҢ 51- 53.xxv - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ ШҙЩҠШ® Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Шө 13.xxvi - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Ш®ЩҠЩ…Ш© Ш§Щ„Ш®ШӘШ§ЩҶ ШҢ Шө 44.xxvii - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Щ…ЩҮЩҲЩү Ш§Щ„ЩҶШ¬Щ… ШҢШө 64.xxviii - ШіЩҠШұШ© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ ШӯЩҠШ§Ш© Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ШҢ Шө 27.xxix - Ш§ЩҗШ№ШӘЩ…ШҜЩҶШ§ Ш№Щ„Щү ШЁШ№Ш¶ Ш§Щ„ЩҶЩ‘ШөЩҲШө Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ© ШҜЩҲЩҶ ШәЩҠШұЩҮШ§ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ЩӮШөШө ЩҒЩҠ Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠ ЩҶШ§ШөШұ ШЁЩҶ ШӯЩ…ЩҲШҜ Ш§Щ„ШӯШіЩҶЩҠ ШҘШ° Ш§Щ„Щ…ЩӮШ§Щ… ЩҒЩҠ ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„ШҜШұШ§ШіШ© Щ„Ш§ ЩҠШіЩ…Шӯ ШЁШЈШ®Ш° ЩҶЩ…Ш§Ш°Ш¬ Щ…ЩҶ ЩғЩ„ Ш§Щ„ЩӮШөШө ЩҲШӘШӯЩ„ЩҠЩ„ЩҮШ§ ЩҲШ§Щ„ЩҲЩӮЩҲЩҒ Ш№Щ„Щү ШЁЩҶШ§ШҰЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶШӯЩҲЩҠ ЩҲЩҮЩҠШЈШ© Ш§Щ„ЩғШӘШ§ШЁШ© ЩҒЩҠЩҮШ§ Ш№Щ„Щү ШЈЩҶЩ‘ ЩҶЩҲШ№ЩҠШ© Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ Ш§Щ„Щ…ШӘЩҲШ§ШӘШұШ© ЩҒЩҠ ШЁЩӮЩҠШ© Ш§Щ„ЩӮШөШө Щ„Ш§ ШӘШ®ШӘЩ„ЩҒ ЩғШ«ЩҠШұШ§ Ш№ЩҶ ШӘЩ„Щғ Ш§Щ„ШӘЩҠ Ш§ЩҗШ®ШӘШұЩҶШ§ЩҮШ§ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮШөШө Ш§Щ„Щ…Ш°ЩғЩҲШұШ© ЩҲЩҮЩҲ Щ…Ш§ ЩҠШӨЩғШҜ ЩҶШІЩҲШ№ Ш§Щ„ЩғШ§ШӘШЁ ЩҶШӯЩҲ Ш§ШіШӘШұШ§ШӘШ¬ЩҠШ© Щ…Ш®ШөЩҲШөШ© ЩҒЩҠ ЩғШӘШ§ШЁШ© Ш§Щ„ЩҶШө Ш§Щ„ШіШұШҜЩҠ .xxx - Щ„Ш§ШӯШё Ш№ШІЩҲЩҒ Ш§Щ„ШіШ§ШұШҜ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҘШ®ШЁШ§Шұ ЩҲШ§Щ„ШӘЩҲШ§ШөЩ„ ЩҒЩҠ ЩӮШөШ© - Ш§Щ„ШЁШ§ШҜШ©- ШҙШЈЩҶЩҮ ЩҒЩҠ Ш°Щ„Щғ ШҙШЈЩҶ Ш§Щ„ШҙШ®ШөЩҠШ© ШҘШ° Ш§ШіШӘШӯШ§Щ„ Ш№Ш§Ш¬ШІШ§ Ш№ЩҶ ЩҒЩҮЩ… Щ…Ш§ ЩҠШҜЩҲШұ ШӯЩҲЩ„ЩҮ Щ…ЩҶ ШЈШӯШҜШ§Ш« Щ…ШӘШіШ§ШұШ№Ш© ШӘШ®Щ„Щү Ш§Щ„ШіШұШҜ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҘЩҒШөШ§Шӯ Ш№ЩҶЩҮШ§ ЩҒЩҠ ЩҶЩҒШі Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ Ш§Щ„Ш°ЩҠ Щ„Щ… ЩҠЩӮШҜЩ… ШӘШЁШұЩҠШұШ§ ЩҲШ§Ш¶ШӯШ§ Щ„Щ…Ш¬ШұЩҠШ§ШӘ Ш§Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« Щ…Щ…Ш§ ЩҠШӯЩӮЩӮ ЩҮШ°Ш§ Ш§Щ„Ш№Ш¬ШІ Ш§Щ„ШіШұШҜЩҠ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ШҘЩҒШөШ§Шӯ ЩҲШ§Щ„ШҘШЁШ§ЩҶШ© ШЁШ§Ш№ШӘШЁШ§Шұ ШЈЩҶ вҖ“ Ш§Щ„ШЁШ§ШҜШ©- Ш№ЩҶШҜ Ш§Щ„Щ…Ш¬ШӘЩ…Ш№ Ш§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠЩ‘ ШӘШ№ЩҶЩҠ Ш§Щ„ЩҲЩӮШӘ Ш§Щ„ШІЩ…ЩҶЩҠ Ш§Щ„Щ…Ш®ШөЩ‘Шө Щ„ШіЩӮЩҠ Ш§Щ„Щ…ШІШұЩҲШ№Ш§ШӘ Щ„ЩҶШ§Ші Щ…ШӯШҜШҜЩҠЩҶ ШӯЩҠШ« ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„ШЈШіШЁЩҲШ№ Щ…ЩӮШіЩ…Ш§ Щ„Щ…Ш¬Щ…ЩҲШ№Ш© Ш§Щ„ЩҶШ§Ші Ш§Щ„Щ…ЩҲШ¬ЩҲШҜЩҠЩҶ ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© ...ЩҮШ°ЩҮ Ш§Щ„Ш®ШөЩҲШөЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Щ…ШӯШҜЩҲШҜЩҠШ© ШӯШ§Щ„ШӘ ШҜЩҲЩҶ ШӘЩҲШ§ШөЩ„ Ш§Щ„ШіШұШҜ ЩҲШ§ЩҗШіШӘШұШіШ§Щ„ЩҮ ...Ш§ЩҸЩҶШёШұ ЩӮШөШ© вҖ“ Ш§Щ„ШЁШ§ШҜШ© вҖ“ Шө 58.xxxi - Щ„Ш§ШӯШё ЩҶЩҒЩҲШұ Ш§Щ„ШіШ§ШұШҜ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШӘЩҒШіЩҠШұ ЩҲШ§Щ„ШӘШЁШұЩҠШұ ЩҒЩҠ ЩӮШөШ© Ш§Щ„ШҙШ§ЩҲЩҲЩҲЩҲЩҠ( ШӘЩғШӘШЁ ЩҮЩғШ°Ш§) ШӯЩҠШ« Ш§ЩҗШ®ШӘШөШұ Ш§Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ© ЩҒЩҠ ШөЩҒШӯШ© ЩҲШ§ШӯШҜШ© ШҜЩҲЩҶ Ш§Щ„ШҘЩҒШөШ§Шӯ Ш№ЩҶ Ш§Щ„ЩғШ«ЩҠШұ Щ…ЩҶ Ш§Щ„ШЈШӯШҜШ§Ш« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ© Щ…Щ…Ш§ ЩҠШіШұ ШӘЩҲШ§ШӘШұ Ш§Щ„ШіШұШҜ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠ ШЁШіШұШ№Ш© ЩҒШ§ШҰЩӮШ© ШӘШ¬ШіШҜ ШұШәШЁШ© Ш§Щ„ШіШ§ШұШҜ ЩҒЩҠ ШҘЩҶЩҮШ§ШЎ Ш§Щ„ЩғЩ„Ш§Щ… ЩҲШәЩ„ЩӮ Щ…ШіШ§Шұ Ш§Щ„ШӯШҜШ« Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠ ШӯШӘЩү ШЈШіШӘШӯШ§Щ„ШӘ ШЈШәЩ„ШЁ Ш§Щ„Ш¬Щ…Щ„ Ш§Щ„ЩӮШөШөЩҠШ© Ш¬Щ…Щ„Ш§ Ш§ШіШӘШҰЩҶШ§ЩҒЩҠШ© Щ…ШіШӘЩӮЩ„Ш© Щ…ЩҶЩҒШөЩ„Ш© Ш№ЩҶ ШЁШ№Ш¶ЩҮШ§ Ш§Щ„ШЁШ№Ш¶ Щ…ЩҶ ЩӮШЁЩҠЩ„ : В«....ЩҠШ№ШӘЩ…ШҜ ШЈЩҮЩ„ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Ш№Щ„Щү Щ…ШІШұШ№ШӘЩҮЩ…/ ЩҠЩ…Шұ Ш§Щ„ШЈШ·ЩҒШ§Щ„ ШЁШҜШұЩҲШЁ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© / ЩҲЩҮЩ… ЩҠШөЩҠШӯЩҲЩҶ / ЩҠШӯЩ…Щ„ЩҲЩҶ Щ…Ш№ЩҮЩ… ШЁЩҶШ§ШҜЩӮЩҮЩ… ЩҠШөЩҠШӯЩҲЩҶ ШЁШ§Щ„ШЈШәШ§ЩҶЩҠ Ш§Щ„ШҙШ№ШЁЩҠШ© ЩҲШ§Щ„Ш№Щ…Ш§ЩҶЩҠШ©/... В» Ш§ЩҸЩҶШёШұ: ЩӮШөШ© Ш§Щ„ШҙШ§ЩҲЩҲЩҲЩҲЩҠ Шө 67.xxxii - Ш§Ш№ШӘШ§ШҜ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩҒЩҠ Ш§Щ„ЩӮШұЩҠШ© Ш№Щ„Щү Ш§Щ„ШөШҜЩӮШ© / ЩҠЩ…Шұ ШҙЩҮШұ / ЩҠЩҒШ№Щ„ЩҮШ§ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші ЩғЩ„ ШіШ§Ш№Ш© / ЩҠШ¬ШӘЩ…Ш№ Ш§Щ„ЩҶШ§Ші / Ш§Щ„ШҘЩҶШіШ§ЩҶ ЩҠШӘШөШҜЩӮ / ШӘШӯШ¬Щ… ЩғЩ„ Ш§Щ„ШЁЩҠЩҲШӘ Ш№ЩҶ Ш§Щ„Ш·ШЁШ® / ЩҠШ°ЩҮШЁ ЩҒШұШҜ ЩҲШ§ШӯШҜ/ ЩғШ§ЩҶ Ш§Щ„Ш·ШЁШ® Щ„Ш°ЩҠШ°Ш§ ЩҲШҙЩҮЩҠШ§ / Ш§ЩҸЩҶШёШұ ЩӮШөШ© Ш§Щ„ШөШҜЩӮШ© Шө 53.