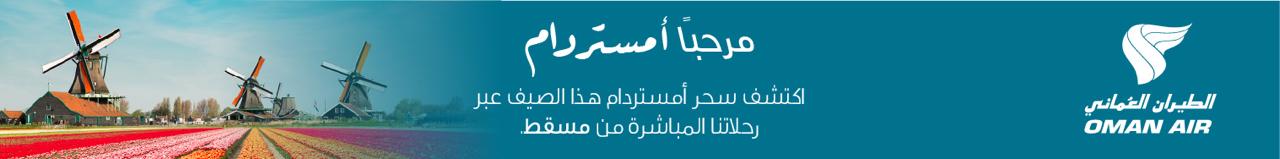أسلوب الاختصاص (1 ـ 2)من الأساليب المهمة المستعملة كثيرا في القرآن الكريم وفي النثر بكل أنواعه ، وسوف نتناوله من النقاط الآتية: مفهوم أسلوب الاختصاص ـ أركان الاختصاص ـ صور المختص ـ إعراب صور أسلوب الاختصاص ـ الفرق بين أسلوب النداء والاختصاص. فمفهوم أسلوب الاختصاص: أنه أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر متأخر بعد ضمير المتكلم غالبا لبيان المقصود منه، ثم يلي ذلك بقية الجملة، ومثال ذلك قولك: أنا ـ المسلمَ ـ أعرف حقوق العباد والبلاد، فالضمير هو المبهم المتقدم، وما بين الشرطتين هو الاسم المختص الظاهر الذي يوضح إبهامَ ذلك الضمير، ثم تأتي تكملة الجملة، وكما تقول: أنا ـ المعلمَ ـ أربي النشء على الصلاح والتقوى، علينا ـ أبناء الإسلام ـ توحيد الصف وجمع الكلمة، ويسمى الاسم الظاهر الذي يبين المقصود من الضمير مختصًّا أو الاسم المختص، والضمير المتقدم، الغالب فيه أن يكون للمتكلم، والقليل أن يكون للمخاطب، والممتنع أن يكون للغائب، ولكن ما هو هدف وغرض العرب من استعمالات هذا الأسلوب. ومن أغراض أسلوب الاختصاص: (1) الفخر والتعظيم: ومثال ذلك قولنا: نحن ـ معشرَ المؤمنين ـ خير أمة أخرجت للناس، وكقوله (صلى الله عليه وسلم): (إنّا ـ آلَ محمدٍ ـ لا تحل لنا الصدقة) بنصب كلمة (آل)، وكقوله (عليه الصلاة والسلام):(نحن ـ معاشرَ الأنبياءِ ـ لا نورث، ما تركناه صدقة)، ومنها كذلك: (2) التواضع والاستعطاف: ومثال ذلك: نحن ـ الفقراءَ ـ نبيت نفترش الأرض ونلتحف السماء، وإننا – مسلمي بورما – لا نجد يدًا حانية بل نجد فقط عينا باكية، ونحو: نحن – فقراءَ المسلمينَ – لا نجد ما يقيم الأود ويسد الرمق، ومن تلك الأغراض كذلك: (3) البيان: ومثاله قولك: أنا – مديرَ المصلحةِ – أعرف واجبي، ونحو: نحن ـ طالباتِ دارِ القرآن ـ نحرص على نظافتها، وعلينا ـ طلابَ العلومِ الشرعية ـ واجبٌ اجتماعيٌّ كبيرٌ، وترد صور المختص (الذي يرد بعد الضمير مباشرة) في لغة العرب على ثلاث: الصورة الأولى: أن يرد معرفًا بأل، ومثالها قولنا: نحن ـ المسلمينَ ـ نحب الخير للناس، وأنا ـ المؤمنَ بالله ـ أحب والديَّ وأكرمهما، وبي ـ الإسلامَ ـ تحل المسائل والمشكلات، والصورة الثانية: أن يرد مضافًا للمعرف بأل، ومثالها قولنا: أنا – طالبَ العلم ِ– أحرص على نشر الخير، وكما يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم):(نحن ـ معاشرَ الأنبياءِ ـ لا نورث، وما تركناه صدقة)، إننا ـ طالباتِ دار تحفيظ القرآن الكريم ـ نحرص على العلم الشرعي وننفذه، ونحو: إننا ـ معلمي المركز ـ نود أن يفهم الناس لغة القرآن وعلومه، ويستعملونها في حياتهم، وأما الصورة الثالثة: فهي أن يكون المختص وارداً بلفظ (أيها وأيتها)، ومثالها قولنا: بنا ـ أيها الشباب ـ يرفع لواء الحق، علينا ـ أيتها الأخوات ـ واجب ضخم، وعلينا ـ أيها الأطباء والطبيبات ـ تقوم المستشفيات، وتخفَّف آلام المرضى، وأما التوجيه النحوي للصور اللغوية التي يرد عليها هذا الأسلوب فتظهر في الآتي: (1) نحن ـ المسلمين ـ أصدق الناس معاملة، فنحن: مبتدأ ضمير مبني على الضم في محل رفع، والمسلمين: مفعول به منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوباً، تقديره: أخص أو أعني، وأصدقُ الناس: خبر مرفوع ومضاف إليه، ومعاملة: تمييز منصوب بالفتحة لوقوعه بعد أفعل التفضيل، ومثل: (2) أنا ـ طالبَ العلم ـ أنشر الخير، فأنا: مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وطالب العلم: مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوباً تقديره أخص أو أعني، وهو مضاف، والعلم مضاف إليه، وأنشر الخير: جملة في محل رفع خبر المبتدأ، (3) بنا ـ أيها الشبابُ ـ يرتفع الحق، فقولك: بنا: شبه جملة متعلق بالفعل (يرتفع) المتأخر، أو شبه جملة في محل نصب حال، وأيها: مفعول به مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص، بفعل محذوف وجوباً، تقديره: أخص أو أعني، والهاء حرف تنبيه، لا محل له من الإعراب، والشبابُ: صفة للفظة (أي) مرفوع بالضمة، وجملة: يرتفع الحق: جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، وأهم فارق بين أسلوب الاختصاص، وأسلوب النداء يتضح في أوجه التشابه والافتراق الآتية: فهما يتشابهان في الآتي:1 ـ كل منهما يكون اسمًا منصوبًا بعامل محذوف وجوبًا (أدعو/ أنادي/ أخص/ أقصد)، 2 ـ كل منهما قد يكون بلفظ (أي وأية) مبنياً على الضم في محل نصب، ولكن الاسم المختص أو أسلوب الاختصاص يفارق أسلوب النداء في أمور، منها:1 ـ أن النداء يكون معه حرف نداء لفظاً أو تقديراً ، بخلاف الاختصاص فلا يكون معه ذلك، 2 ـ أن النداء يقع في أول الكلام، وأما الاختصاص فلا يكون إلا في أثنائه أو في آخره، 3 ـ أن المنادى لا يكون بأل قياساً، بخلاف الاختصاص فإنه يكون بأل قياسا، نحو:(نحن ـ العربَ ـ كرامٌ)، ونحن ـ العلماءَ ـ نيسِّر على الناس، 4 ـ أن المنادى يكون عَلَمًا ونَكِرةً ومَعْرِفةً، وأما الاختصاص فَيقِلُّ وروده علمًا، ولا يقع نَكِرَةً، ومن حيث ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم في نحو قوله تعالى:(قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) (هود ـ 73)، حيث قال أبو حيان:(وأهلَ) منصوبٌ على النداء، أو منصوب على الاختصاص (راجع البحر المحيط 5/ 245)، ومنه كذلك قوله تعالى:(يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعَزُ منها الأذَلَّ) (المنافقون ـ 8)، إذ قال أبو حيان: وقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني (لنَخرُجَنَّ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء، ونصب (الأعز) على الاختصاص، كما قيل: نحن ـ العرب ـ أقرى الناس للضيف، ونصب (الأذلَّ) على الحال .(راجع البحر المحيط 8 ـ 274)، وفي بعض آي القرآن الكريم يدعي بعض من المشككين في الكتاب العزيز أن خطأ لغوياً قد يقع في القرآن الكريم، ويجعلون ـ جهلاً منهم أو تعمد التشكيك وجعلوا منه قوله عزوجل:والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء (البقرة ـ ١٧٧)، حيث ورد فيه ـ حسب زعمهم ـ مخالفة لقواعد اللغة، إذ جاء المعطوف، وهو:(الصابرين) منصوباً، مع أن المعطوف عليه هو قوله:(الموفون) وهو مرفوع، والصواب في زعمهم أن يقال:(والصابرون) بالرفع عطفا على ما قبله، وللرد على هؤلاء يقول النحاة: الأصل في المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في الإعراب، رفعاً ونصباً وجراً وجزماً، ولكن جاء النظم المعجز هنا على خلاف هذا الظاهر، والمتأمل في كلام الله عزوجل:(والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يجد أن كلمة (الصابرين) منصوبة، وكان الظاهر ووفق القاعدة أن تكون مرفوعة، عطفاً على ما قبلها، وللنحاة والمفسرين في توجيه ذلك أقوال، منها: 1) أن الظاهر من سياق الكلام أن تكون كلمة (الصابرين) مرفوعة لأنها معطوفة على مرفوع، ولكنها قُطعت عن العطف، ونُصبت على المدح بفعل محذوف، تقديره (أمدح) إشعاراً بفضل الصبر، وتنويها بذلك الفضل، أو منصوبة على الاختصاص بفعل محذوف، تقديره: أخص أو أعني أو أقصد، 2) وأن المخالفة الظاهرة في مثل هذا المقام هي أبلغ من جريان الكلام على نمط واحد، وهذا أسلوب جارٍ على سنن العربية، وطريقة أهلها في الكلام، فقد جاءت كلمة (الصابرين) منصوبة على الاختصاص وإفادة المدح إظهار لفضل الصبر في الشدائد، ومواطن القتال، وغيرها من مواقف المحن الكبرى على سائر الأعمال... للموضوع بقية. د/ جمال عبد العزيز أحمدكلية دار العلوم- جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية[email protected]