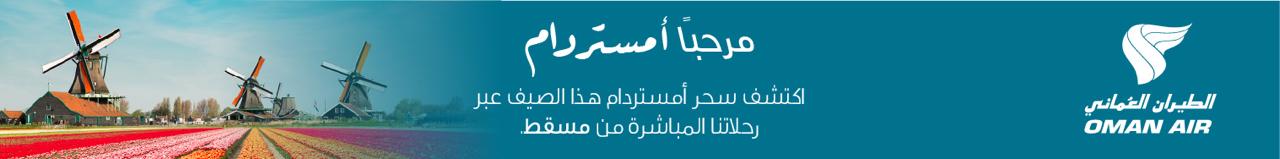يتميز أسلوب القرآن الكريم بتنوع صوره، وتعدد أنماطه، وتباين جمله وعباراته، وقد أتى القرآن الكريم بأساليب لغوية كثيرة، نتناول منها هنا أسلوبُ الإغراء، فنتعرف طبيعة هذا الأسلوب وصوره اللغوية، وكيفية وروده في القرآن الكريم، وطريقة تناوله إعرابياً ودلالياً، من خلال النظر في الآتي: مفهومه، وأركانه وصوره، وحكم عامل النصب في المغرى به جوازاً ووجوباً.فالإغراء: هو حثُّ المخاطب على أمر محمود ليفعله، أو ليلزمه، كأنْ نحثه أو نحضه مثلا على الحرص على الصلاة لوقتها، فنقول له: الصلاةَ (بالنصب) على وقتها، والمعنى: اِلْزَمِ الصلاة على وقتها حتى تحصل الثواب الكبير من الله، وكما نقول:)الإيمانَ الإيمانَ تفلحوا(، و)التقوى والخوفَ من الله تسلموا، وتنعموا(.وأركان الإغراء: ثلاثة: الركن الأول: المغرِي (بكسر الراء وبعدها ياء) تحتها نقطتان، وهو المتكلم أو المخاطِب (بكسر الباء)، والركن الثاني: المغرَى (بفتح الراء وبعدها ألف القصر)، وهو الشخص الذي نخاطبه مغرين إياه (المخاطَب بفتح الخاء)، والركن الثالث: المغرَى به، وهو الأمر المحمود الذي نحض أو نحث المخاطَب على فعله ليلزمه، نحو: (القرآنَ) فنحن هنا نغرِي المخاطب على فعل أمر محمود ليقوم به، ويحرص عليه، ويلزمه، فالقرآن مغرًى به، والمتكلم هو المغرِي، والذي أمامه ممن ينصحه ويغريه بقراءته والتزام تلاوته هو المغرَى، وكذا يقال في نحو: التعاونَ على البر والتقوى، فالمغرى به هو خلق التعاون على البر والتقوى والتزام فعلهما والعمل بهما ليسعد الإنسان بإتيانهما، ومَنْ يَنْصَحُ بذلك هو المغرِي، وهو مَنْ كان قد فَعَلَهما من قبلُ، وتذوَّقَ عاقبة الاتصاف بهما؛ ومن ثمَّ فهو يُغْرِي غيره من المخاطبين بأن يسلكوا مسلكه ليسعدوا سعادته، والمخاطَب المنتصَح هو المغرَى.وكذلك نحو: التضحيةَ في سبيل الله، أو: الإخلاصَ في العمل، أو: الصدقَ في القول، وغيرها من الصفات الطيبة التي هي محل إغراء الناس، ولفت نظرهم إلى نتائجها، وعواقبها الطيبة الملموسة، ممن سبقهم في الالتزام بها، والعيش في ظلالها وثمراتها. وأما عن صور الإغراء فتأتي على ثلاث صور قياسية، هي الإفراد والتكرار والعطف، فصورة الإفراد: هي أن يذكر المغرَى به مفردا غير مكرر، وعندئذ يحذف فعله جوازا ، بمعنى أنه قد يذكر، أو يحذف، ويقدر.ومثال ذلك أن تقول: الإخلاصَ في العمل، فالإخلاص: مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف جوازاً، تقديره: الزم الإخلاصَ، وقد يذكر الفعل، فنقول: الزمِ الإخلاصَ.والصورة الثانية هي صورة التكرار: أن يُذْكَرَ المغرَى به مكرَّرا، وعندئذ نعرب اللفظ الثاني توكيداً لفظيًّا منصوباً مثل الأول، ويحذف الفعل هنا وجوبا مع هذه الصورة؛ لأن التكرار قام مقام الفعل المحذوف، والقاعدة أنه لا يجمع بين العِوض والمعَوَّض عنه.مثال: البرَّ البرَّ بالوالدين، فالبر(الأولى): مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوباً، تقديره: الزم، والبرَّ (الثانية): توكيد لفظي منصوب.بالوالدين: جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف وجوبا، وأما الصورة الثالثة فهي صورة العطف: فهي أن يذكر المغرَى به معطوفا عليه بمغرًى به آخرَ، ويُحذَف الفعل عندئذ وجوباً كذلك لأن المعطوف قام مقام الفعل المحذوف، ولا يجمع بين الشيء، وما ينوب منابه، ويغني عنه.وذلك مثل قولك: البرَّ بالوالدين وطاعتَهما، فالبر : مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوبا تقديره: الزم، والواو: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وطاعتهما: معطوف على البر منصوب مثله.ولو لاحظت هنا كيفية اعتبار حكم إعراب الاسم المغرَى به وحكم حذف فعله جوازاً ووجوباً لوجدته مرتبطا بالصورة التي يرد عليها هذا الأسلوب في اللغة: فالاسم المغرَى به منصوب دائمًا، ويتوقف حذف الفعل الناصب له على صورته، فإن كان على صورة الإفراد حُذف الفعل الذي ينصبه جوازًا، وإن كان على صورتي المكرر، والمعطوف حُذف الفعل الذي ينصبه وجوبًا، لأن التكرار والعطف قد قاما مقام الفعل المحذوف، فهما كالعوض عنه، ولا يجمع ـ كما سبق ـ بين العوض والمعوَّض عنه، ولا بين النائب والمنوب عنه.ومن أمثلة ذلك قولنا:الصدقَ (فالفعل هنا يحذف الفعل جوازاً)، وأما قولنا: الصدقَ الصدقَ، أو الصدقَ والإخلاصَ (فيحذف الفعل في الحالتين هنا وجوباً)، وكذلك نحو قولك: المذاكرةَ (يحذف الفعل جوازاً)، والمذاكرةَ المذاكرةَ، والمذاكرة والفهم (يحذف الفعل وجوبا)، وقولنا:التفوقَ (يحذف الفعل جوازاً)، وقولنا:التفوقَ التفوقَ، أو التفوق والتواضع (يحذف الفعل وجوباً). لكن السؤال هنا: هل ورد الإغراء في القرآن الكريم؟، وما صوره إن كان قد ورد؟.نعم ورد فيه قوله تعالى:(ملةَ أبيكم إبراهيم)، حيث جاء في بعض أعاريبها أنها منصوبة على الإغراء، بفعل محذوف جوازا تقديره: الزموا ملة أبيكم إبراهيم، وهناك من: هي منصوبة على الاختصاص، وآخر قال: منصوبة على أنها مفعول به، بفعل تقديره اتبعوا، وكذلك قوله تعالى: (فطرةَ الله)، وصبغة الله، أي الزموا فطرة الله لا تبرحوها، أو الزموا صبغة الله لا تتنكبوا طريقها، ومنهم من أدخل فيه قراءة النصب في قوله:(شهرَ) من قوله تعالى:(شهرَ رمضانَ الذي أنزل فيه القرآن)، أي: الزموا الشهر: صياماً وقياماً وتهجداً وتعبداً ولا تضيِّعوه، ذلك جاء منصوباً على أنه أسلوب إغراء، وفي نصبه على الإغراء دلالات جديدة فوق دلالة المفعول به، أو دلالة الاختصاص، أو دلالة نصبه بالسياق العام المتناغم مع ما قبله من آيات، وهناك بالطبع توجيهات أخرى لتلك الآيات، وتخريجات نحوية متباينة للنحاة والمُعربين، أسأل الله تعالى أن يلزمنا نهجَه القويم وصراطه المستقيم، وأن ينفعنا بكل ما نقرأ، ونتعلم، ونحصِّل، إنه وليُّ ذلك، والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.د/ جمال عبد العزيز أحمدكلية دار العلوم ـ جامعة القاهرةجمهورية مصر العربية[email protected]