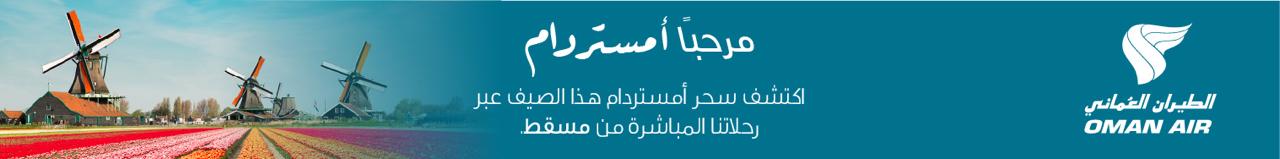.. فتنصُّ الآية الكريمة، وهي واردة هنا بالجملة الاسمية، المفيدة للدوام، والثبات، والأزلية، والسرمدية للحكم الذي حَكَتْهُ، وسجَّلته للدنيا كلها:(هو الذي بعث في الأميين..)، وهنا إيجاز بالحذف، أي: هو الله الذي بعث في الخلقِ، أو القومِ الأميين، وهم العرب، كما أن التعبير بالماضي يدل على أنها نعمةٌ قد مَضَتْ منذ الأزل، واقتضتْها الحكمة الإلهية، والأفضال الربانية من أزل الأزل: أن يكون الرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو خاتم الأنبياء، وسيد الأتقياء، وباعث هِمَّة الخلق إلى عبادة الخالق، والآخِذُ بأيديهم إلى طريق العَفاف، والارتقاء، والنبل، والعبادة الحقة للإله الحق، والربِّ الذي يجب أن نتوجَّه إليه ـ نحن الخلق ـ بجميع أنواع العبادة، ونقدِّم لعظمته كل ألوان الولاء، والطاعة، مع الخضوع، والخشوع، المحوط بالتسليم والدموع، عساه يتفضل بالقبول؛ لأنه خير مسؤول.
والحرف (في) هنا يدل على تعمُّقه في التواصل مع الناس، وتعبه في الدعوة إلى الله، واجتهاده في الأخذ بيد الخلق إلى سبيل خالقهم، وطريق مولاهم، من أول الكون إلى آخره، ودخوله في كلِّ شؤونهم، وحلوله الناجعة لكلِّ ما يقع لهم، كأنه غابَ بين ظَهْرَانَيْهِمْ، وتوغَّل في كلِّ أعمالهم، وتعاملاتهم، وحياتهم، فالظرفية هنا لها دلالاتها الدعوية والرحمة النبوية، وتنكير (رسول) لبيان عظمته، وكمال خَلْقِه وخُلُقِه، وجلال بعثتِه، وجمال سِيرته، وطُهْرِ مَسيرتِه، كما أن التعبير بشبه الجملة:(منهم) يأتي كناية عن أنه بشرٌ مثلهم، نهضَ بمهمته، وقام برسالته، وأنه بِوُسْعِهِمْ أن يستنُّوا به، وبسيرته، وجمال حياته، وجلال مسيرته، وأنه مثلهم، ولكنه تمكن من يكون ـ بفضل الله ـ قدوة للعالمين، وليس ملكًا أو جنًّا، حتى لا يقولون: إنه من جنس آخر قوي، وخلق من نوع غير البشر، فأمكنه أن يكون فوق البشر، ولكن شاءت حكمة الله أن يجعله بشرًا ككل البشر، لكنه زاد عنهم بأنه يوحى إليه، قال الله تعالى:(قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد..)،والتعبير بالفعل المضارع:(يتلو) يفيد الاستمرار، وأنه لا يجد أيَّ مدخل لدعوتهم، إلا وسلكه، ولا طريقًا إلى الله إلا ويَسَّره لهم، ودعاهم إليه، وتلا عليهم ما نزل بشأنه من القرآن الكريم، ووضح لهم طبيعته، وكيف يخرجهخم من الظلمات إلى النور، وشبه الجملة:(عليهم) فيه حرف الجر(على) الذي يفيد الاستعلاء، والتمكُّن، وهو كناية عن تقدير كلام الله، وأنه مقدًّرٌ في العيون، وموضوع من عظمته، وتوقيره فوق الرؤوس، فكأنهم قدَّروه، وأعْلَوْا مكانه، وتلقَّفوه بكلِّ ما أوتوا من قوة، وتوقير، وعز، وتقدير، والتزموا به حق الالتزام، وساروا به في الحياة، ورآهم ربُّهم متمسِّكين به، وعاملين بكل ما فيه، وداعين إليه، وذائدين عن حياضه، وقوله: (ويزكيهم) ورد بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، وتواصل الحكم، والوصف، وهو كذلك كناية عن تواصل تزكيته، وعدم تركِ فرصةٍ يمكن أن يطهِّرهم بها إلا ويعجِّل بها، ويسعى لها سَعْيَهَا، وكذا هي دلالة الفعل بعده:(ويعلمهم الكتاب)، فتعليم الكتاب متواصل، كالتزكية لقلوبهم، و(أل) هنا في (الكتاب) عهدية، ذهنية، أزو (أل) الكمالية، أي:هو الكتاب المعهود المعروف لكلِّ العالمين،وهو المعلوم في ذهن كل مؤمن، وهو القرآن الكريم،أو الكتاب الكامل في كتابته، الواضح في نطقه، وتلاوته، وعبَّر عن السُّنَّة بالحكمة؛ لبيان قيمتها، وعظمة ما فيها، وكمال غاياتها، وجلال أهدافها، والعطف بالواو هنا ليجمع المسلمُ بينهما، سواء أكان القرآن الكريم أولًا، أم جاءت السُّنَّة أولًا، فالواو لمطلق الجمع، أو للجمع المطلق من غير ما ترتيب، المهم أن يكون بين نَاظِرَيِ المؤمن كتابُ الله، وسنةُ رسوله الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم تأتي الجملة الحالية(وإن كانوا من قبلُ لفي ضلال مبين)؛ لترسم الوضع الذي كان عليه الناسُ قبل مولده، ومبعثه الشريف، أي والحال عند البشر قبل مولده ومبعثه حال من الضلال الواضح، والمبين عن نفسه، والمتحدث عن فعالهم القبيحة، وسلوكياتهم الدنيئة:(وإن كانوا من قبلُ لفي ضلال مبين)، والفعل:(كانوا) يدل على رسوخهم في الضلال زمنًا طويلًا، وأن ذلك قد كان لهم قبل مولده ومبعثه ديدنًا متتابعًا، وسلوكًا متواصلًا، وجمع اسم كان(كانوا)، أو مجيئه بواو الجماعة:(كانوا) يدل على أن مجموعهم كانوا في ضلال محقَّق، ولم يَسْلَمْ منهم إلا القليلُ الذين كانوا يتعبَّدون على ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهم المتحنِّفون، أو الحنفاء، أو المتحنِّثون،وشبه الجملة:(من قبل) كناية عن أن ضلالهم كان موجودًا إلى موعدِ ميلاده، وزمنِ مبعثه، واللام في قوله:(لفي ضلال) تفيد التوكيد، وتثبيت الدلالة، ويأتي الحرف:(في) ليدل على انغماسهم في هذا الضلال، وتغطيته إياهم في جميع سلوكياتهم، وتعاملاتهم، حتى إنَّ الواحد منهم لا يُرَى في كل ألوان الضلال، وأطياف الجهل، وأنواع المعصية، وتنكير (ضلال) يأتي للشمول، وأنهم ارتكبوا كلَّ الآثام، وأصناف الضلال، ووصف الضلال بأنه (مبين)، وهو اسم فاعل من الفعل الرباعي:(أبان)، وهي استعارة مكنية تبيِّن أن الضلالَ كان كما لو كان شخصًا عاقلًا يمكنه، وفي مُكنته أن يُبِينَ عن نفسه، ويتحدث عن سلوكه بلسان عربي سليم، وأنه فصيحٌ فصيحٌ، فكان يُعلِن عن سوء سلوكهم بلسان واضح، ومنطقٍ ظاهرٍ، مبين، فكأنَّ الضلال رجلٌ مِفصاح، يتكلم بالفصيح من الضلال، والصريح من الفساد، ولم يكن يرعوي عن ذلك، فقد كان فصيحًا مُبينًا، لسنًا، حتف الكلمة الشرود، وهو كذلك كناية عن اتِّضاح الضلال، وتعدُّد أطيافه، وتنوع أصنافه، وألوانه، وأحجامه، حتى فاحت رائحته، وزَكَمَتْ منها الأنوفُ، فكان الرسول الكريم سببًا مباشرًا ـ بعد فضل الله عليهمـ في أخذهم إلى ربهم، ورفع مقامهم عند مولاهم، وتقديرهم لذواتهم، واعتدادهم برقِيِّ إنسانيتهم، واعتلائهم قمم النبل، وحياة الطاعة، والعبادة.
د.جمال عبدالعزيز أحمد
كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية