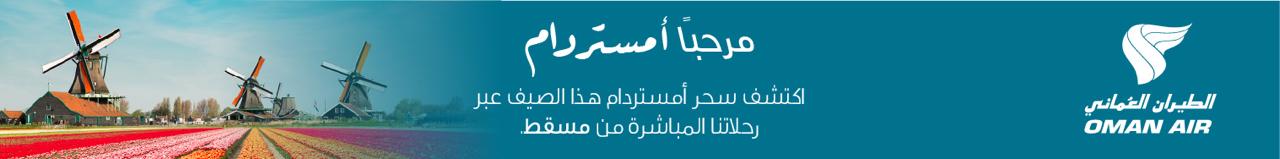أثار حدث الهجرة الجليل أحكاما فقهية كبيرة، وتخللته وقائع يستشف منها أحكام شرعية كثيرة، يمكن أن تفتح لنا مجالا، ولأهل الفتيا طريقا ينير لنا سبلا متعددة، حيث تبين لنا في الوقت نفسه جلال الهجرة على المستوى الفقهي، ومستوى الأحكام، والفتاوى المعاصرة التي تستند إلى فعل النبي الكريم، وقوله.
ومن ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تساؤل أحدهم: هل يجوز المرء أو الداعية أن يستأكل من دعوته، وأن يعيش من خلال مسيرته الدعوية، وأعماله الدينية؟، أم أن هذا حرام، وغير جائز؟!.
ولعل أقرب الجواب على ذلك أن فيه بعض التفصيل، على الوجه الآتي: الأول أنه إن لم يكن له مصدر دخل آخر يتعايش منه، ويسد مطالبه، وحاجاته، في حدودها الدنيا، فلا بأس أن يتعايش بشيء مما يأتيه من ورائها، وعليه أن يزداد بحثًا، وطلبًا للرزق، بحيث يكون عمله الدعوي خاليًا من التأكل من دعوته، والعيش عليه؛ حتى يتذوق معنى، ودلالة، وعمق: (العمل ابتغاء وجه الله، والتماس رحمته)، وحتى يعيد سيرة السلف الصالح في الاستماتة في الدعوة إلى الله على حسابهم الخاص، وضرورة الصرف على الدعوة ومتطلباتها، والسهر لنجاحها، دون ارتقاب شكر، ولا انتظار مقابل مادي منها، مهما كان.
ودليلنا على ذلك من موضوع الهجرة أن سيدنا أبا بكر عندما بلغه الرسول الكريم أنه قد أذن له بالهجرة، وسأله أبو بكر شرف الصحبة، فأكد له الرسول أنه سيكون معه في هجرته، وسيكون مرافقا له في هذا الحدث الجلل، قال:(يا رسول الله، اشتريت راحلتين واحدة لك يا رسول الله، والثانية لي، فرد عليه الرسول الكريم بقوله: آخذها بثمنها، فقال: أكفيك ذلك يا رسول الله مؤنة ذلك، فقال: لا، يا أبابكر، ما أنت بأحرص مني على الثواب، ولا أنا بمستغن عن الأجر)، وهذا المعنى فهم من سياق الحديث بينهما، وكذلك في غزوة بدر، عندما كانت تأتي دورة أبي بكر في ركوب الناقة، فيقول للرسول الكريم:(اركب أنت يا رسول الله، وأواصل أنا المشي)، فكان الرسول الكريم يقول نحوًا من ذلك، ويصر على ركوب سيدنا أبي بكر، والرسول الكريم يمشي آخذا بزمام الناقة في هذا الحر الشديد؛ ليبين للأمة أنه لابد للداعية من التحمل، والتصبر، والمثابرة؛ حتى عندما كانوا في إحدى الغزوات، وراحوا يجهزون الطعام، وكل واحد حاول تقديم جهد منه؛ ليتم ذلك لهم، فقال الرسول الكريم:(وعلي جمع الحطب)، والمعروف في بلاد العرب ـ آنذاك ـ أن هذا الأمر صعب للغاية؛ جراء عدم وجود حطب يذكر في تلك البيئة القاحلة، فاختار الرسول الكريم أصعب مهمة، وأكثرها مشقة، ولم يخلد إلى الدعة، والراحة، وكذلك قدم جهوده في غزوة الخندق عندما كان يحفر معهم، ويحمل المكتل بما فيه من حجارة، وتراب، وكانوا يستعينون بالرسول إذا واجهوا حجارة ضخمة كؤودا، وتحدثنا السيرة العطرة أن الرسول أخذ معوله، وضرب الصخرة ضربة شديدة، قائلًا:(الله أكبر خربت خيبر)، وضربها الثانية: (وقال: الله أكبر، هلك ملك كسرى، وقيصر)، وتفتت الصخرة، وصارت رمادًا، فقد كانت قوته الشريفة تعادل قوة مائة فارس، أو مائة رجل بطل قوي الجسد، والبدن، والعقل.
وثاني تلك التساؤلات أنه: هل يجوز الاستعانة بالمشركين المهرة في أمور المسلمين الكبرى؟، وأليس في ذلك مخاطرة باطلاعهم على قضايا الأمن القومي الخاص بنا، وما من شأنه معرفتهم بخفايا أمورنا، ودقائق أسرارنا ومتطلبات أمتنا؟.
والجواب أنه ـ من خلال مجريات أحداث الهجرة ـ يجوز الاستعانة بالمشركين المهرة في أمور تخص المسلمين؛ شريطة ألا يتحكموا في مصير الأمة، ومسيرتها البنائية، والحضارية، وأنه يستأجر، ويعطى حقه دون ظلم، وليس له التدخل فيما لا يخصه، وما لا يعنيه، وتغلق صفحته بعد انتهاء مهمته، دون أن يطلع على مجريات أمورنا، ودون أن يتحكم في مسيرتنا، والدليل ما فعله الرسول الكريم حينما استعان بالمشرك الذي كان على دين قريش ـ عبد الله بن أريقط ـ حيث كان قد استعمله الرسول في هجرته الشريفة، وكان بصحبته أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ وكان معهما هذا الدليل الخريت، الماهر بدروب الصحارى، ومسالكها الصعاب، وهضابها، ووهادها، ونجادها وتهامها، وهو عبد الله بن أريقط الدؤلي، وكان مشركًا، ولكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد استأجره؛ ليدله على الطريق، وكان خريتًا ماهرًا بالطريق الصحراوية، فجاز من سبرته الشريفة الاستعانة بالمشرك ما دام أمينًا، وثقة، وعالمًا، وماهرًا بما استخدم له، واستؤجر من أجله.
على أن بعض المصادر ذكرت أنه ـ فيما بعد (أنه قد أسلم، وحسن إسلامه، وصار صحابيًا جليلًا من صحابة الرسول الكريم)، وفي هذا الأمر، والاستخدام كثير من الفوائد، منها: أن دين الإسلام دين منفتح على الآخر، ولا يمنع من قراءة ما عند الآخرين، وتداول الخبرات لدبهم، والتعاون الإيجابي معهم، والتعامل، والتعاون البناء، والانفتاح على كل ما عند الآخرين إذا لم يخالف ثوابتنا، وعقيدتنا، واحترام الآخر، والتعارف الإنساني، مصداقًا لقوله تعالى:(إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا..)، وليبين للدنيا كلها يسر التعامل مع أفراد المجتمع كله، وعدم النفرة بناء على مسائل عرقية، أو عقدية، أو أيديولوجية، أو اثنينية،.جعلتها الأديان الأخرى حاجز عثرة أمام أهل الأديان، فصارت هناك خصومات، ونزاعات، كنا نحن أغنى الناس عنها، وأوسعهم صدرًا لها، فجاءت تلك الاستعانة للرد على أمثال هؤلاء الذين لا يعلمون الكثير عن جلال ديننا، وقوته، وكمال تشريعاته، وما الذي يخيفنا ـ نحن المسلمين ـ وديننا دين قوي، ارتضاه الله ليكون خاتمة أديان السماء، ولا دبن بعده:(اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينًا)، وهو القائل ـ سبحانه وتعالى ـ في محكم كتابه:(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة ـ 8). فنحن ـ بوصفنا مسلمين ـ منفتحون على فكر الآخرين، وثقافاتهم، وعلومهم، فما صادف ثوابتنا أخذنا منه، وشكرنا أصحابه، وإذا أخذوا من علومنا؛ ليفيدوا منها مكناهم من ذلك، والقوي لا يخاف، ولا يرتعد، ولا يضطرب، ولا يرتعب، وإنما يقف في الميدان كالسيف البتار؛ لأنه يستدر قوته من القوي الجبار، ودينه القويم الخاتم المغوار، الذي تضمن في طياته عوامل بقائه، وأسباب شموخه، وأنه دين الفطرة الذي يأتي الناس بجميع أطيافهم إليه، ويدخلون فيه أفواجًا، وهو الدين الذي لا يكره أحدًا على اعتناقه، قال الله تعالى:(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي..) (البقرة ـ 256).
وهنا نعرف أن من دروس الهجرة ما يدخل تحت باب الفقه، والأحكام الشرعية، وما يمكن أن يسهم في مسيرتنا الحياتية، ويربط الناس: مِللًا، ونِحلًا، ببعضهم، ويجعلهم إخوة متحابين، ويصيرهم مجتمعًا متكاملًا، متعاونًا، متناغمًا، متوحدًا، تتلاقى فيه أيدي أبنائه، وتتحد فيه قلوبهم، وتتحاب أفئدتهم.
د.جمال عبدالعزيز أحمد
كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية