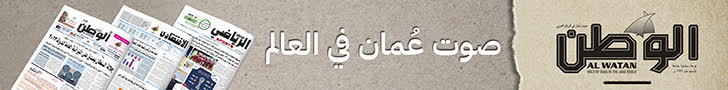هناك أمورٌ نحوية يلزم أن تُراعَى عن التناول اللغوي للنص القرآني، منها قضية التعلق، وأقصد بها عودةُ أشباه الجمل إلى أفعالِها المتقدمة، أو المتأخرة، وما لها من دور كبير في كشف النص، وإيضاح المراد، وإضاءة المعنى، وبيان الدلالة، وأشباه الجمل هي الظروف بنوعيها: زمانًا، ومكانًا، والجار والمجرور، بمعنى: أنك لو قلت:(جئتك اليوم صباحًا)، فـ(صباحًا) شبه جملة، ظرف زمان، ولو قلت:(الجنةُ تحتَ أقدامِ الأمهات)، فـ(تحت) شبه جملة، ظرف مكان، ولو قلت:(الإيمان في القلب)، فـ(في القلب) شبه جملة، جار ومجرور، .. وهكذا في كلِّ ظروف الزمان، وظروف المكان، وكل حروف الجر مع مجروراتها، هي أشباه جمل، أي: هي فوق المفرد، ودون الجملة، وتلك الأشباه تقوم بدور الربط بينها وبين الأفعال، أو الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، وتُحدِث لونًا من الترابط الدلالي الذي يدعو إلى التماسك النصي، وجَعْلِ نسيجِ النص واحدًا، متداخلًا، ومتناغمًا، متشابكًا، يأخذ بعضُه بِحُجُزِ بعض في تناسق منظوم، ومعنًى منغوم، يعطي فكرة متكاملة عن المرمى المقصود، والمعنى المرصود.
ونتناول هنا قضية التعلق في سورة القدر، عسى أن نسهم بكليمة في كشف بلاغتها، وكمال تناسقها، وجلال ترابطها، يقول الله تعالى:(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (القدر 1 ـ 5).
يبدأ أول تعلُّق في قوله تعالى:(في ليلة القدر)، حيث يعربه النحويون شبه جملة متعلقًا بالفعل:(أنزلناه)، أو في محل نصب حالًا، وفي تعلقه بالفعلية يبيِّن زمن نزول القرآن الكريم، أنه في الليلة، لا في النهار، حيث الجلال، والهدوء، والضياء، والتملي، والصفاء، فـ (في) تفيد ابتداء الغاية الزمانية، أو الحالية، أي أنزلناه حالة كونِ إنزاله في تلك الليلة، وفي ذلك الزمن، وكأنك تراه يتنزَّل على النبي الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك الزمن الجميل، الهادئ، المنير، مع الصفاء، ونور القمر، وأنوار النجوم، وصفاء صفحة السماء، وترى الملائكة تتنزل به على شخصه الشريف، وتجد الملائكة، وهم نور، يحملون النور، إلى السراج المنير، والبدر الزاهر ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالقرآن، وهو نور، يتنزل على الرسول، وهو أنور، وأجمل من نور البدر، والفعل:(أنزلناه) يعني نزوله دفعة احدة، أما (نَزَّلناه) ـ بتشديد الزاي مفتوحة ـ فتعني نزوله منجَّمًا وفق الوقائع، والأحداث، ورهن المشكلات الناجمة، وطلب الرأي فيها، والله أنزله كله مرة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزَّله منجَّمًا حسب الأحداث على قلب النبي الكريم؛ ليثبته، ويُظهر صدقَ نبوته، وصدقه فيما يحدِّث به قومَه، ومن ورائهم كلُّ المسلمين، فشبه الجملة، إما أن يرتد إلى الفعل (أنزلناه)، فيبين حصوله في ذلك الوقت، وتلك الليلة الموعودة، وإما أنه حالٌ تبين هيئة حصول الفعل، وهو الإنزال للقرآن دفعةً واحدةً في ليلة القدر إلى السماء الأولى في بيت العزة، ثم نزل منجّمًا مفرّقًا حسب ما كان يقع من أحداث.
والتعلُّق الثاني في قوله تعالى:(.. مِن أَلفِ شَهرٍ)، فشبه الجملة هذا متعلق بأفعل التفضيل: (خير)؛ لأن أصله (أخير)، أي أكثر خيرية، ومعنى هذا أن ليلة القدر هي أخيَرُ، وأكثر فضلا، ونعما، وفيضَ عطاء إلهي من ألف شهر، ولك أن تحسب الألفَ شهر بقسمتها على اثني عشر، وهي أشهر العام، فتعطيك أكثر من ثلاث وثمانين سنة كاملة، فليلة واحدة في ميزان الإسلام هي أفضلُ من ثلاث وثمانين سنة (التي هي ألف شهر)، وقالوا: ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، فإذا تخيلتَ أن ألف شهر في كل سنة فيها ليلة قدر، فكيف يكون ثوابها؟!، إنه ثوابٌ مذهلٌ، فوق حسابات البشر؛ لأنه من رب البشر، ولا يعرف قدرها إلا ربها، وملاها، ومنزلها، وشارعُها.
فشبه الجملة المتعلق بـ(خير) كشف لنا عن مدى حجم ليلة القدر، وعِظَمِ ثوابها؛ حتى لا نتكاسل في قيامها، ولا حُسْنِ استغلالها، وجميلِ استثمار أوقاتها، على ما وصل إلينا في فضلها، ومكانتها، وجلال قدرها، وعظيم مقامها.
وشبه الجملة الثالث هو(والرُّوحُ فِيها)، فإن «الروح: مبتدأ، و(فيها) شبه جملة متعلق بمحذوف هو الخبر، والتقدير:(والروح نازل فيها)، أو حاضر، وموجود فيها، أو أن شبه الجملة نفسه هو الخبر على رأي المتأخرين من النحويين كابن السراج، ومن لف لفه، وقد أضاف هذا الشبه أن الروح، وهو جبريل ـ عليه السلام ـ في الملائكة، وموجود معهم، وهو رئيس الملائكة، والموكَّل بالوحي، وقد وصفه الله وصفًا عظيما في كتابه، فهو رئيسهم، وإذا كانت ليلة القدر نزل هو في كوكبة من الملائكة، يسلمون على الطائعين، ويدعون لهم، ولك أن تتخيل ـ على سبيل المثال ـ رئيسًا، أو ملكًا، أو سلطانًا جاء يزورك مع وزرائه، ويسلِّم عليك بنفسه، وتشعر عندها بقيمتك، وقيمة الزمن الذي تعبد الله فيه: أن يرسل إليك رئيس جميع الملائكة، يصل في كل مكان في الكون، يكون فيه طائعٌ، وعابدٌ في تلك الليلة، ويفهم هذا من معنى الظرفية في الحرف (في) فهو منتشرٌ وُجُودُهُ ونزوله في جميع أزمنة الليلة، وهو في الأرض يجوبها جميعًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا، ينظر في وجه هذا، ويدعو لهذا، ويسلِّم على هذا، ومع الملائكة على كثرتهم، يباركون للخلق طاعتهم، ويفرحون لعبادتهم، ويدعون لهم بالقبول والرضا، كل هذه الدلالة كشف عنها شبه الجملة (فيها)، كما أن فيه كنايةً عن جلال الطائعين، وعلوِّ منزلتهم: أن يزورهم، ويدعو لهم، وينظر في وجوههم طوال الليلة رئيسُ الملائكة المحبوبُ عند ربه:(ذُو مِرَّةٍ فَاستَوَى)، وكما في:(نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمينُ عَلَى قَلبِكَ..)، وكون الواو حالية، فإنها تذكِّي هذا الفهمَ، وترشِّح دلالتَه في أن الحال تبيِّن هيئة حدوث الفعل، فالملائكة، وهم يتنزلون في تلك الليلة يتنزلون، ومعهم رئيسهم؛ تشريفًا، وتقديرًا للطائعين في هذه الليلة المباركة.
وشبه الجملة الرابع، وهو (بِإذنِ رَبِّهِم) الباء هنا بمعنى ابتداء الغاية الزمانية، أو ابتداء الغاية المكانية، أو تكون بمعنى (مع)، أو بمعنى السبية، أي: ينزلون بسبب إذن ربهم، أو ينزلون، ومعهم الإذن بالنزول، أو بمعيته، ومشيئته، فهو نزولٌ مباركٌ من الله، ومبتدِئٌ من عنده، أو في لحظة أمرهم به، كل ذلك أحدثه حرفُ الجر الباء الذي يأتي بمعنى المعية، والمصاحبة، أو ابتداء الغاية: زمانية، أو مكانية، والدخول عليهم يُشعِرهم بالعظمة، فهو ليس مأذونا له من أيِّ أحد، وإنما الإذن من ربهم، ولم يقل من (إلههم)، فاختار الربوبية التي هي الحنان كله، والحدب، والعطف كله، والرحمة، والعطاء كله، والسياقُ يتطلبها، والإضافة للتشريف، والتعظيم، فهو ربهم، ومولاهم، وإلههم، وحبيبهم، ومعبودُهم، والمسموع كلمتُه، قد أذن لهم بملاقاة البشر الطائعين، والخلق العابدين، الأطهار، الأبرار الذين نظر إليهم العزيز الغفار، في تلك الليلة ذات الأنوار، والنعم الكثار، والمنن الغزار.
والشبه الخامس هو(مِن كُلِّ أَمرٍ)، و(من) هنا بمعنى الباء، أي ينزلون بكل أمر أراده الله من سَعَةِ خير، ومزيدِ فضل، وجليلِ رفعة، حسب أمر الله، أو تكون بمعنى مع (أي: مع كل أمر)، وتنكير (أمر) يوحي بكثرته وتنوعه، وعدم تضييقه، ولا منعه، وتؤكد ذلك كلمة (كل)، فهي ليلة العطاء، والعفو الواسع، والعطاء الجامع، وأما الشبه الأخير فهو قوله تعالى:(حتى مطلع الفجر)، و(حتى) هنا إما بمعنى (إلى أن)، أي: سلام إلى مطلع الفجر، وإما بمعنى (إلا) أي هي ليلة سلام، وعفو، وصفح، وخير، وتظل كذلك إلا أن يطلعَ الفجرُ، فتنتهي الليلة، أو إلى أن يؤذَّن للفجر، فتُرفَع تلك السنة، وتكون قد سجلت كل طائع، وعابد في أي مكان من كون الله، وأرضه، وخاب، وخسر من نام فيها، ولم يعتكف، ولو ساعة، أو بعض وقتٍ، ينال خيرها، ويُسلَك في عداد أهلها، ويكون من أتباعها، ومَنْ كُتِبوا في سجلاتها، وفازوا برضا ربها، ومُنْزِلِ كتابه فيها، وهو مقدِّرها حقَّ قدرها.
د. جمال عبد العزيز أحمد
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم بجمهورية مصر العربية