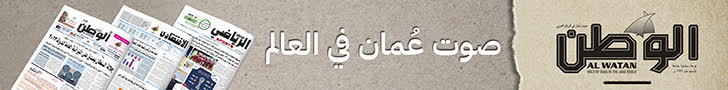«العُدولُ فـي البِنْيَة وأثره فـي الدلالة القرآنية التذكير والتأنيث فـي الفعل «نماذج من القرآن الكريم» «5»
.. ولكنَّ اسمَ الجمع غيرُ الجمع، فالجمع ما له مفرد من لفظه، كرجال مفردها رجل، وأعراب مفردها أعرابي، وأسماء مفردها اسم، وبسمات مفردها بسمة.. وهكذا، أما اسم الجمع فهو ما لا واحد له من لفظه، وإنما له واحدٌ من معناه، مثل رهط، وقبيلة، ونفر، مفردها كلها رجل، ولا مفرد لها من لفظها، بل مفردها من معناها، وكذلك نسوة، مفردها امرأة، وليس هنا مفرد هو: (نُسَيَّة)، فهنا (نسوة) اسم جمع، وفي قاعدة تذكير وتأنيث الفعل جوازًا أن يكون فاعله اسمَ جمع، فـ(نسوة) من حيث القاعدة النحوية وردت على القياس، وجواز الاستعمال، هذا معروف، لكنْ، لِمَ مال القرآن الكريم إلى التذكير، مع أن مقتضى الظاهر أن يقول:(قالت نسوة)؟!، قيل في ذلك إن من طبع النساء الحياء، والإقلال من الكلام، وخصوصًا إذا خرجنا إلى المجتمع، وكن في محضر من الرجال، فهن يذودان عن الرجال، ولا يتكلمْن في حضرتهم إلا قليلًا، ولا يكثرن، بل يكتفين بالقليل المفهم، دون الكثير المُسْهِب، قال تعالى حكاية عن بنتي شعيب: (قَالَتَا لا نُسقِي حَتى يُصدِرَ الرِّعاءُ وَأبُونا شَيخ كَبيرٌ)، وهنا محذوفات كثيرة في كلامهن كثير، واقتصرن في جوابهن على سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ على الأركان الأساسية في الجملة، وحذفن أجزاءً كثيرة من جملهن(وقد أشرنا إلى ذلك كثيرًا من قبلُ في مقالات مطولة في هذه الجريدة المباركة تحت عنوان: اللغة والأخلاق)، فمن طبع النساء الحياء، وعدم الكلام، ولكنَّ النسوة هنا خلعْن برقع هذا الحياء، وذهبن في كل المدينة، ولعل استعمال:(في) من قوله:(وَقَالَ نِسوَةٌ فِي المَدينةِ) التي تفيد الظرفية، وفيما ما يكشف عن حجم ما بذلوه في حق امرأة العزيز، وفضيحتها في كل المدينة، ولم يتركوا مكانًا حتى وصلوا إليه، وقالوا ما قالوه في حقها:(امرأةُ العَزيزِ تُراوِدُ فَتَاهَا عَن نَفسِهِ قَد شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراهَا فِي ضَلالٍ مُبينٍ)، وكثُر كلامُهم، وفاح حديثُهم، حتى وصل إلى موضع قدمي امرأة العزيز، وكأنهن قد صرنَ رجالًا، وليس من طبعهن الحياء، وراح لسانهم يلوغ في امرأة العزيز، ولم يراعوا حياء، ولا حرمة، فاستحقوا أن يخرجوا إلى طبيعة الرجال، وما يتفوهون به، دونما وازع، ودونما حياء رادع؛ ومن ثم عُدِلَ من التأنيث إلى التذكير، كأنهن بسلوكهن هذا قد صرنَ رجالًا، وأعينهن واسعة، وألسنتهن لاغطة، لائكة، فظهرْنَ كأنهنَّ يَمْضُغْنَ الكلام مضغًا، ويَلُكْنَهُ، ويُعِدْنَه مرارًا، وتكرارًا، ويُكرِّرْنَه كثيرًا، فاتسمْنَ بسيماء الرجال، وأخلاقهم، وخصائصهم، فاستحققن تذكير الفعل، لا تأنيثه، وكان ذلك وصفهن؛ ومن ثم جاء الفعل مذكّرًا.
فلو عَدَدْنا الجملَ التي قُلْنَها، وكررنها، لوجدناها كثيرة، وهي:( امرأةُ العَزيزِ تُراوِدُ فَتَاهَا عَن نَفسِهِ ـ قَد شَغَفَها حُبًّا ـ إِنَّا لَنَراهَا فِي ضَلالٍ مُبينٍ)، إنه لكلام طويل، وحديث كثير، يدل على جرأة غير عادية، وانعدم حياء، وألسنة تلوغ في شرف الناس، وتكشف عوراتهم، وتسمح لأنفسها أن تنشر أسرار الناس، وأخبارهم دون وجه حق، ولذلك جاء العدل في هاتين الآيتين (هذه التي حللناها الآن، والتي تسبقها، وهي المتعلقة بسورة الحجرات: «قالت الأعراب آمنا»)، ثم نعلم أن من سمات لغة الكتاب العزيز أن كلَّ لفظة فيه مرتبطة مع سياقها العام، ومتناغمة مع الدلالة التي سيق لأجلها الكلام، وهو مدخل كريم من مداخل الإعجاز البلاغي، والدلالي في كتاب الله العزيز الحميد.
د. جمال عبد العزيز أحمد
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم بجمهورية مصر العربية