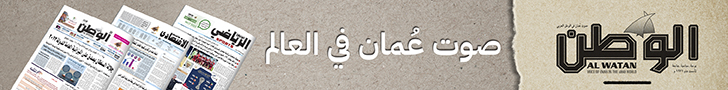أتذكَّر جيِّدًا كيف بدأ انتشار الهاتف المحمول في منتصف تسعينيَّات القرن الماضي، حينها لم تكُنِ الهواتف ذكيَّة، لكن كانتْ تُحدِث ضجيجًا في السُّوق، وقَدِ استطاعت شركة فنلنديَّة أن تهيمنَ على هذا القِطاع العالَمي، متفوِّقة على شركات غربيَّة ويابانيَّة وكوريَّة كبرى. تلك السَّيطرة لم تأتِ من فراغ، بل اعتمدت على جودة المنتَج وتطويره المستمر، لكن ما كان غريبًا أنَّ هذه الشَّركة، رغم قوَّتها، تراجعت بشكلٍ مفاجئ، ليس لأنَّها توقَّفت عن العمل، بل لأنَّها لم تُواكبْ وتيرة التَّغيير الجارف وشغَف الإنسان الدَّائم بكُلِّ جديد، فكُلُّ مَن يظنُّ أنَّ النَّجاح اللَّحظي سيخلِّده على القمَّة، دُونَ أن يواكبَ عجَلة التَّطوُّر، يرتكب خطأ قاتلًا، فهذا المشهد تكرَّر لاحقًا مع دخول الصِّين، الَّتي كنَّا نصفُ منتجاتها حينها بالرَّداءة، وكان كلمة صيني مرادف للمنتج الرَّديء، إلَّا أنَّها فجأة أصبحتْ تُهيمن على المشهد، ليس فقط في التَّصنيع، بل في الهيمنة على سلسلة الإنتاج، حتَّى باتَتِ التَّفاحة الأميركيَّة تُصنَّع هناك، وشركة مثل هواوي مثلًا، بعد أن تعرَّضتْ لعقوباتٍ أميركيَّة شديدة، في فترة ترامب الأولى، لم تتقهقرْ بل انطلقتْ لِتصبحَ من بَيْنِ أفضل شركات العالَم في قِطاع الاتِّصالات، وهذا ليس استثناءً، بل قاعدة باتَتْ تتكرر في كثير من الشَّركات الصِّينيَّة.
لا أظنُّ أنَّ أحدًا كان يتوقع يومًا أن تتحولَ المنتجات الصِّينيَّة من نماذج منخفضة السِّعر ورديئة السُّمعة، إلى منتجات تُنافس بقوَّة وتتصدر المبيعات العالَميَّة. من الإلكترونيَّات إلى السيَّارات، حيثُ تتجلَّى هذه القفزة النَّوعيَّة في قِطاع السيَّارات، فقَدْ نجحتِ الشَّركات الصِّينيَّة في فرض نَفْسها من خلال معادلة دقيقة وهي القِيمة مقابل السِّعر، ومع الوقت لم تَعُدْ تعتمد فقط على السِّعر، بل رفعتْ من مستوى الكفاءة والتقنيَّات، واقتربتْ بشكلٍ واضح من المنافسة مع الكوريِّين واليابانيِّين، لا سِيَّما في مجال الخدمات. اللافت هنا أنَّ هذا التَّحوُّل لم يتمَّ بفضل الصُّدفة، بل عَبْرَ تخطيط استراتيجي طويل الأمد، وبالاستثمار في البنية الصِّناعيَّة والبحثيَّة. فالصِّين الَّتي كانتْ تعتمد سابقًا على استنساخ التقنيَّات، أصبحتْ تمتلك مراكز بحثيَّة تنافس نظيرتها الغربيَّة، وتطوّر تقنيَّاتها الخاصَّة، وتضع بصمتها في أكثر من قِطاع. بلد زراعي تحوَّل خلال عقدَيْنِ فقط إلى قلعة صناعيَّة عالَميَّة، لا يُنافسه فيها إلَّا مَن بدأ قَبله بمئة عام، وحتَّى في قِطاع السِّلاح، الَّذي كان لعقودٍ محتكرًا من قِبل القوى الكبرى، أثبتَ السِّلاح الصِّيني كفاءة لافتة في النِّزاعات الحديثة، ما مهَّد له طريقًا نَحْوَ مبيعات هائلة، خصوصًا بعد نجاحه في منافسة نظيره الرُّوسي والغربي خلال الأحداث الأخيرة في القارة الآسيوية.
كُلُّ هذا الحديث عن الصِّين لا أقصده من باب الإعجاب الأعمى، ولا من أجْل دراسة التَّجربة كما يُحب بعض الباحثين التَّنظير، بل أذكره وفي داخلي قدر كبير من الإحباط، فقَدْ جرَّبنا في منطقتنا مرارًا وتكرارًا محاولات استنساخ التَّجارب النَّاجحة، من التَّعاونيَّات الألمانيَّة إلى المؤسَّسات الصَّغيرة اليابانيَّة، بل حتَّى قُمنا باستيراد أفكار النُّمور الآسيويَّة، ومع ذلك فشلنا. فبرغم أنَّ النُّهوض العربي بدأ منذُ بداية القرن الماضي، إلَّا أنَّنا ما زلنا نراوح في ذات المكان، فالمُشْكلة ليسَتْ في استيراد الفكرة، بل في محاولة تحويرها حتَّى تتناسبَ مع ما نُطلق عَلَيْه (خصوصيَّتنا)، وهنا تكمن الكارثة.. فالصِّين لم تنهضْ؛ لأنَّها حملتْ شعارات مِثل من الإبرة حتَّى الصَّاروخ، بل لأنَّها أغلقتْ فمَها واشتغلتْ، لم تضيّعِ الوقت في سرد الأسباب وتبرير الفشل، بل بنَتْ، وجرَّبتْ، وسقطَتْ، ثمَّ نهضَتْ. أمَّا نحن فما زلنا نحاول أن نقنعَ أنْفُسنا بأنَّ فشَلَنا له طابع خاصٌّ، وخصوصيَّة حضاريَّة وثقافيَّة، وما هي إلَّا ستار للهروب من الحقيقة.
أكثر ما يثير حنقي أن نرَى المسؤولين يتحدثون عن (خصوصيَّة المُجتمع) وكأنَّ حاجتنا إلى الغذاء والدَّواء والكساء والسِّلاح تختلف عمَّا يحتاجه بقيَّة البَشَر! فاختراع العجَلة لا يحتاج إلى إعادة اكتشاف، بل يكفي أن ننقلَ التَّجربة كما هي، ونتعلم مِنْها، ثمَّ نُضيف بعد ذلك ما يناسبنا، لا أن نبدأَ من الصِّفر كُلَّ مرَّة، ثمَّ نسقط، وندَّعي أنَّ لنا خصوصيَّة تجعلنا لا ننجح مِثل غيرنا، ما نحتاجه اليوم ليس خطابًا مختلفًا، بل عقليَّة مختلفة. أتذكَّر أنَّني سألتُ يومًا أحَد مهندسي الطُّرق عن سبب الازدحام الشَّديد رغم توسعة الشَّوارع، فأجابني بأنَّنا نُصمِّم الطُّرق بما يتناسب مع خصوصيَّتنا! حينها أيقنتُ أنَّ تلك (الخصوصيَّة المزعومة) هي شمَّاعة الفشل المُعلَنة، لأجدني أردِّد العبارة الخالدة (مفيش فايدة)، وهكذا ببساطة، نظلُّ نلهث وراء تجارب غيرنا، نحاول تقليدها، ثمَّ نفرغها من مضمونها باِسْمِ الخصوصيَّة، ونفشل، ونُعِيدُ الكرَّة مرَّة أخرى، دُونَ أن نتعلمَ.
إبراهيم بدوي